 |
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 3130
تاريخ التسجيل : 31 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 2,291
- شكراً و أعجبني للمشاركة

- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 12
معدل تقييم المستوى
: 16

المبحث الثاني المؤسسة القضائية وبعض الاجتهادات الفقهية
يعتبر عهد ذي النورين امتدادا للعهد الراشدي الذي تتجلى أهميته بصلته بالعهد النبوي وقربه منه، فكان العهد الراشدي عامة والجانب القضائي فيه خاصة امتدادا للقضاء في العهد النبوي، مع المحافظة الكاملة والتامة على جميع ما ثبت في العهد النبوي، وتطبيقه بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه، وتظهر أهمية العهد الراشدي في القضاء بأمرين أساسيين:
* المحافظة على نصوص العهد النبوي في القضاء، والتقيد بما جاء فيه، والسير في ركابه، والاستمرار في الالتزام به.
* وضع التنظيمات القضائية الجديدة لترسيخ دعائم الدولة الإسلامية الواسعة، ومواجهة المستجدات المتنوعة([1]).
استطاع الفاروق بتوفيق الله ثم عبقريته الفذة أن يطور مؤسسة القضاء للدولة الإسلامية، وأصبحت لها قواعد ونظم، استفاد منها الخليفة الراشد عثمان t في تعيين القضاة وأرزاقهم، واختصاصهم القضائي ومعرفة صفات القاضي، وما يجب عليه، ومصادر الأحكام القضائية، والأدلة التي يعتمد عليها القضاة، كما أنه أصبحت هناك سوابق قضائية من الصديق والفاروق استفاد منها القضاة في عهد عثمان t.
عندما تولى عثمان t الخلافة كان على قضاء المدينة يومئذ علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، والسائب بن يزيد رضي الله عنهم. ويذكر بعض الباحثين أن عثمان لم يترك لأحد من هؤلاء القضاة الاستقلال بالفصل في قضية من القضايا, كما كان الحال في عهد عمر t, بل كان ينظر في الخصومات بنفسه، ويستشير هؤلاء وغيرهم من الصحابة فيما يحكم به، فإن وافق رأيهم رأيَه أمضاه، وإن لم يوافق رأيهم رأيه نظر في الأمر بعد ذلك. وهذا يعني أن عثمان t قد أعفى القضاة الثلاثة في المدينة من ولاية القضاء وأبقاهم مستشارين له في كل شجار يرفع إليه مع استشارة آخرين، ويرى بعضهم أنه لم يثبت نص صريح يفيد الإعفاء، وغاية ما ورد في ذلك يدل على أن عثمان t قد أقر قضاة عمر بالمدينة، ولكنه تحمل عنهم النظر في كثير من القضايا الكبيرة مع استشارتهم فيها، ومنشأ هذا الخلاف تَعَارضُ الروايات الواردة في ذلك:
* روى البيهقي في سننه، ووكيع في أخبار القضاة واللفظ له، عن عبد الرحمن بن سعيد قال: أخبرني جدي، قال: رأيت عثمان بن عفان في المسجد، إذ جاءه الخصمان، قال لهذا: اذهب فادع عليا، وللآخر: اذهب فادع طلحة بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن، فجاءوا فجلسوا، فقال لهما: تكلما، ثم يقبل عليهم فيقول: أشيروا عليَّ، فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهما، وإلا نظر فيقومون مسلِّمين، ولا يعلم أن عثمان بن عفان استعمل قاضيا بالمدينة إلى أن قُتل t.
* جاء في تاريخ الطبري عند الحديث على أعمال عثمان: وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابت، وهذا يشعر بأن عثمان أبقى زيدا على ولاية القضاء، ويستلزم الإذن له بالفصل في الخصومات، وما دام الجمع بين النصين ممكنا، فإن الأخذ به أولى من الأخذ بأحد النصين في غير المرجح، ويجمع بين النصين بأن عثمان أبقى قضاة المدينة للفصل في بعض الخصومات، ولكن بعضها الآخر من معضلات القضايا جعله خاصا به مع استشارة أصحابه فيها، ومنهم قضاته([2]).
وكان عثمان t يعين القضاة على الأقاليم حينا؛ مثل تعيينه كعب بن سور على قضاة البصرة، ويترك القضاء للوالي حينا آخر؛ مثل طلبه من واليه على البصرة أن يقوم بالقضاء بين الناس إضافة إلى عمل الولاية، وذلك بعد عزل كعب بن سور، وكذلك كان يعلي بن أمية واليا وقاضيا على صنعاء.([3]) ويلاحظ أن بعض الولاة كانوا يختارون قضاة بلدانهم بأنفسهم، ويكونون مسئولين أمامهم، مما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة في خلافته من القضاة.([4]) والمأثور عن عثمان كتبه ورسائله إلى أمراء الأمصار، وإلى أمراء الأجناد بالثغور وإلى عامة المسلمين، وهذا يدعو إلى غلبة الظن بأنه جعل القضاء من اختصاص الولاة، يتولونه بأنفسهم، أو يعينون له من يستطيع القيام به.([5]) ففي الوقت الذي نجد فيه مراسلات كثيرة بين عمر وقضاة الأمصار نجد ندرة في المراسلات في عهد عثمان بينه وبين أولئك القضاة([6]).
* ابن عمر يعتذر عن القضاء:
قال عثمان لابن عمر: اقض بين الناس، فقال: لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ»؟ قال عثمان: بلى، قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني، فأعفاه، وقال: لا تخبر بهذا أحدا([7]).
* دار القضاء:
تذكر بعض كتب التاريخ أن من مآثر ذي النورين اتخاذه دارا للقضاء، كما يظهر ذلك من رواية رواها ابن عساكر عن أبي صالح مولى العباس قال: أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه فأتيته في دار القضاء إلى آخر الحديث، فإذا صح فيكون عثمان هو أول من اتخذ في الإسلام دارا للقضاء، وقد كان الخليفتان قبله يجلسان للقضاء في المسجد كما هو مشهور([8]).
* أشهر القضاة في خلافة عثمان:
1- زيد بن ثابت (المدينة).
2- أبو الدرداء (دمشق).
3- كعب بن سور (البصرة).
4- أبو موسى الأشعري (البصرة بالإضافة إلى ولايته).
5- شريح (الكوفة).
6- يعلى بن أمية (اليمن).
7- ثمامة (صنعاء).
8- عثمان بن قيس بن أبي العاص (مصر) ([9]).
هذا وقد ترك الخليفة الراشد أحكاما فقهية في مجال القصاص والجنايات والحدود والتعزير والعبادات والمعاملات، كان لها الأثر الواضح في المدارس الفقهية الإسلامية، وهذه بعض الأحكام التي أصدرها عثمان أو أفتى بها:
أولاً: فيما يتعلق بالقصاص والحدود والتعزير:
1- أول قضية واجهت عثمان قضية قتل:
أول قضية حكم فيها عثمان قضية عبيد الله بن عمر، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها، وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفينة بالسيف فقتله، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله، وكان قد قيل إنهما مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله أعلم.([10]) وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده، فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله، فقال علي: ما من العدل تركه، وأمر بقتله. وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، قد برأك الله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك، فودى([11]) عثمان أولئك القتلى من ماله؛ لأن أمرهم إليه؛ إذ لا وارث لهم إلا بيت المال، والإمام يرى الأصلح في ذلك، وخلى سبيل عبيد الله.([12]) وقد جاءت رواية في الطبري تفيد بأن القماذبان بن الهرمزان قد عفا عن عبيد الله، عن أبي منصور قال: سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبيه، قال: كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض، فمر فيروز بأبي ومعه خنجر له رأسان، فتناوله منه، وقال: ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟ فقال: آنس به، فرآه رجل، فلما أصيب عمر قال: رأيت هذا مع الهرمزان، دفعه إلى فيروز، فأقبل عبيد الله فقتله، فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، ثم قال: يا بني، هذا قاتل أبيك، وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله، فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي، إلا أنهم يطلبون إلي فيه، فقلت لهم: ألي قتله؟ قالوا: نعم (وسبوا عبيد الله)، فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لا، وسبوه، فتركته لله ولهم، فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم.([13])
ولا يوجد تعارض بين هذه الرواية والرواية الأخرى التي تذكر أن الخليفة عثمان عفا عن عبيد الله بن عمر وتحمل هو الدية الشرعية لورثة الهرمزان؛ لأنه يوجد في فهم جميع الصحابة حق لابن الهرمزان في القصاص، وقد استجاب لرجائهم له في العفو على النحو السالف ذكره، كما أن عفو الخليفة يرجع إلى سلطة التحقيق في الجريمة, والحكم فيها هو للخليفة وليس لابن المقتول، فيكون عبيد الله قد اعتدى على حق الخليفة، ومن ثم فرواية العفو منه تنصرف إلى العفو بسبب هذا الحق، وهذه المخالفة من عبيد الله حيث أضاع على الدولة أمرا هاما هو معرفة الخلايا التي تتصل بالجريمة من الجناة والأشخاص والجهات التي كانت خلف هذه المؤامرة، كما ينصرف العفو من الخليفة إلى من ليس لهم ولي وهم جفينة وابنة المجوسي القاتل، ولا يوجد خلاف في الروايات والمصادر التاريخية على أن الخنجر الذي قتل به عمر ابن الخطاب كان بيد الهرمزان وجفينة قبل الحادث، وقد شاهد ذلك اثنان من الصحابة وهما عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر، ورواية عبد الرحمن بن أبي بكر تفيد أن القاتل أبا لؤلؤة كان مع هذين الشريكين يتناجون ثلاثتهم، فلما باغتهم سقط الخنجر من بينهم، وبعد قتل عمر وجدوا أنه نفس الخنجر الذي وصفه الشاهدان.([14]) وبالتالي فالهرمزان وجفينة يستحقان القتل، أما ابنة أبي لؤلؤة الذي قتل نفسه ليخفي المشتركين معه، فهذه قتلت خطأ ولا يقتل فيها أحد، وقد رأى عبيد الله أنها من المشاركين في القتل؛ حيث كانت تخفى السلاح لأبيها.([15])
2- قتل اللصوص:
إن شبابا من شباب أهل الكوفة في ولاية الوليد بن عقبة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه، فنذر بهم، فخرج عليهم بالسيف، فلما رأى كثرتهم استصرخ فقالوا له: اسكت، فإنما هي ضربة حتى نريحك من روعة هذه الليلة، وأبو شريح الخزاعي مشرف عليهم، فصاح بهم وضربوه فقتلوه، وأحاط الناس بهم فأخذوهم، وفيهم زهير بن جندب الأزدي ومورع بن أبي مورع الأسدي، وشبيل بن أبي الأزدي في عدة، فشهد عليهم أبو شريح وابنه أنهم دخلوا عليه, فمنع بعضهم بعضا من الناس، فقتله بعضهم، فكتب فيه إلى عثمان فكتب إليه في قتلهم، فقتلهم على باب القصر في الرحبة، وقال في ذلك عمر بن عاصم التميمي:
لا تأكلوا أبدا جيرانكم سَرَفا
|
|
أهل الزعارة في ملك ابن عفان
|
وقال أيضا:
إن ابن عفان الذي جربتم
|
|
فطم اللصوص بمحكم الفرقان
|
ما زال يعمل بالكتاب مهيمنا
|
|
في كل عنق منهم وبنان([16])
|
3- رجل قتل تاجرا لماله:
كان ذلك في خلافة عثمان، وكانت العقوبة القتل قصاصا([17]).
4- عقوبة الساحر:
حدث في عهد عثمان بن عفان أن جارية لحفصة سحرتها، فاعترفت الجارية بذلك، فأمرت حفصة بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرتها واعترفت، فسكت عثمان، وعثمان لم ينكر على حفصة القتل ولكنه أنكر عليها الافتئات على حق الإمام في إقامة الحدود، فإن أمر الحدود إلى الإمام، وهذا ما يدل عليه قول ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت؛ يعني أن القضاء فيها واضح، وأن استحقاقها القتل لا تدفعه شبهة([18]).
5- جناية الأعمى:
الأعمى مع قائده كالآلة، يتحرك بأمره، وهو مع مُجَالسه غفل، يتحرك وهو قد يتردى في حركته أو يتضرر، فلا يتوقع أنه يتحاشا إضرار غيره بحركته وهو لا يراه، ولذلك فإنه إذا ما جنى على قائده أو من جالسه دون قصد فجنايته هدر، قال عثمان بن عفان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء فهو هدر([19]).
6- جناية المقتتلين على بعضهما:
قد يقع شجار بين الأشخاص فيجني كل واحد من المتشاجرين على صاحبه، فإن حصل شيء من هذا فالواجب القصاص، أن هذه الجناية عمد؛ إذ الظاهر أن كل واحد منهما حريص على أن ينال من صاحبه، قال عثمان بن عفان t: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص([20]).
7- الجناية على الحيوان:
إذا وقعت الجناية على الحيوان فالواجب فيها الضمان بالقيمة، فعن عقبة بن عامر قال: قتل رجل في خلافة عثمان بن عفان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقُوِّم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، وأغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا([21]).
8- الجناية على الصائل:
إذا صال شخص على مال شخص آخر أو على نفسه أو على عرضه فقتله المصول عليه أثناء اعتدائه فدمه هدر، فقد روى ابن حزم في المحلي أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله، فارتفعوا إلى عثمان فأبطل دمه([22]).
9- استتابة المرتد وحدّه:
لا يقام الحد على المرتد حتى يستتاب ثلاثا، فإن أصر على ردته قُتل، وحدث أن أخذ عبد الله بن مسعود بالكوفة رجالا ارتدوا عن الإسلام، وأخذوا ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، فكتب فيهم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فكتب عثمان إليه: أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا([23]).
10- إني قتلت فهل لي من توبة:
قال رجل لعثمان: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عثمان من أول سورة غافر: "حم ` تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ` غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ" [غافر: 1- 3] ثم قال له: اعمل ولا تيأس.([24]) والجدير بالذكر أن التوبة من الآثام إذا ارتكبت في حق العباد لا بد فيها من أداء الحقوق لأصحابها أو تنازلهم عنها([25]).
11- حد الخمر:
المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاقب الحر إذا شرب الخمر بأربعين جلدة، ضربه القوم بالنع0ال وأطراف الثياب امتهانا له، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر في أول خلافته، ثم لم يلبث أن زاد العقوبة بمشورة من الصحابة إلى ثمانين جلدة، لما رأى الناس يتحاقرون هذه العقوبة ولا يرتدعون بها. أما عثمان بن عفان فقد ثبت عنه أنه جلد الحر أربعين جلدة، وثبت عنه أنه جلده ثمانين جلدة، ولم يكن ذلك منه عن تشهٍّ أو هوى، ولكنه فرق بين الشاربين, فلم يعاقب من كان شربه زلة منه عقوبة من أدمن شربها، فجعل عقوبة من كان شربه لها أول مرة، وكانت من زلة أربعين جلدة، وجعل عقوبة من اعتاد شربها ومن أدمن عليها ثمانين جلدة، وكأنه كان يجعل الأربعين الأولى حدا، والأربعين الثانية تعزيرا([26]).
12- إقامة الحد على أخيه من أمه الوليد بن عقبة:
عن حصين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد فشهد عليه رجلان -أحدهما حمران- أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولّ حارّها من تولى قارّها([27]), فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعليٌّ يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنَّة، وهذا أحب إليَّ.([28]) ويؤخذ من هذا الحديث بأن سلف عثمان -رضي الله عنهم- نفذوا هذا الحد, وبأن للمنفذ أو المأمور أن ينيب عنه غيره. ويؤخذ منه أيضا: قوة عثمان في الحق، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم؛ فالوليد بن عقبة بن أبي معيط أخوه لأمه([29])، وتنفيذ الأحكام الشرعية هو أحب أعمال الشرطة.([30])
13- سرقة الغلام:
لا يقام حد السرقة إلا إذا كان السارق بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، وقد أتى إلى عثمان بغلام سرق، فقال: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت، فلم يقطعه.([31])
14- الحبس تعزيرًا:
استعار ضابي بن الحارث البرجمي في زمان الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلبا يدعى قرحان يصيد الظباء، فحبسه عنهم, فنافره الأنصاريون واستغاثوا عليه بقومه فكاثروه، فانتزعوه منه وردوه على الأنصار، فهاجمهم وقال في ذلك:
تجشَّم دوني وفد قرحان خطة
|
|
تضلُّ لها الوجناء وهي حسير
|
فباتوا شباعا ناعمين كأنما
|
|
حباهم ببيت المرزبان أمير
|
فكلبكم لا تتركوا فهو أمكم
|
|
فإن عقوق الأمهات كبير
|
فاسْتَعدوا عليه عثمان، فأرسل إليه فعزره وحبسه كما كان يصنع بالمسلمين، فاستثقل ذلك، فما زال في الحبس حتى مات فيه([32]).
15- حد القذف بالتعريض:
كان عثمان يقيم حد القذف بالتعريض به، فقد قال رجل لآخر: (يا ابن شامة الوذر) -يعرض له بزنا أمه- فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال الرجل: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد؛ أي حد القذف، ولم يلتفت إلى تفسير مراده مما قال.([33])
16- عقوبة الزنا:
إذا ثبت الزنا على رجل أو امرأة وكان حُرًّا محصنًا فإنه يعاقب بالرجم بالحجارة حتى الموت، وقد زنت امرأة محصنة في عهد عثمان بن عفان فقضى عثمان برجمها ولم يحضر رجمها([34]).
17- التعزير بالنفي والطرد:
بلغ عثمان أن ابن الحبكة النهدي يعالج نيرنجًا -قال محمد بن سلمة: إنما نيرج أخذ كالسحر وليس به- فأرسل إلى الوليد بن عقبة ليسأله عن ذلك، فإن أقر به فأوجعه، فدعا به فسأله، فقال: إنما هو رفق وأمر يعجب منه، فأمر به فعزر، وأخبر الناس خبره وقرأ عليهم كتاب عثمان: إنه قد جد بكم، فعليكم بالجد، وإياكم والْهُزَّال، فكن الناس عليه، وتعجبوا من وقوف عثمان على مثل خبره، فغضب فنفر في الذين نفروا، فضرب معهم، فكتب إلى عثمان فيه، فلما سيَّر إلى الشام من سيَّر، سير كعب بن ذي الحبكة ومالك بن عبد الله -وكان دينه على دينه- إلى دنياوند، فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليد:
لعمري لئن طردتني ما إلى التي
|
|
طمعت بها من سقطتي لسبيل
|
رجوتُ رجوعي يا ابن أروى ورجعتي
|
|
إلى الحق دهرًا غال ذلك غُول
|
وإن اغترابي في البلاد وجفوتي
|
|
وشتمي في ذات الإله قليل
|
وإن دعائي كل يوم وليلة
|
|
عليك بدُنيا وندِكُم لطويل([35])
|
18- دفع الناس عن جنازة العباس:
عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: لما أتى بجنازة العباس بن عبد المطلب إلى موضع الجنائز تضايق الناس فتقدموا به إلى البقيع، ولقد رأيتنا يوم صلينا عليه بالبقيع، وما رأيت مثل ذلك الخروج على أحد من الناس قط، وما يستطيع أحد أن يدنو من سريره، وغلب عليه بنو هاشم، فلما انتهوا إلى اللحد ازدحموا عليه، فأرى عثمان اعتزل وبعث الشرطة يضربون الناس عن بني هاشم، حتى خلص بنو هاشم فكانوا هم الذين نزلوا في حفرته ودلوه في اللحد.([36]) وهذا يدل على كثرة رجال الشرطة آنذاك، ويعتبر عثمان t لدى بعض المؤرخين([37]) أول من اتخذ صاحب شرطة من الخلفاء، وقد أسند هذه المهمة في المدينة إلى الصحابي الجليل المهاجر ابن قنفذ بن عمير القرشي.([38]) وهذا يدل على عنايته بها، وأن صيتها قد ذاع في عهده. وفي الكوفة كان عبد الرحمن الأسدي على شرطة سعيد بن العاص (واليها لعثمان) كما كان نصير بن عبد الرحمن على شرطة معاوية بن أبي سفيان (والي عثمان على الشام) ([39]).
وفي الحقيقة لا يعلم خليفة في الإسلام بعد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- يقيم الحدود على القريب والبعيد، والشريف والوضيع، والغني والفقير ولا يبالي، ويعطي كل ما يطلب منه من إصلاح أو حقوق كعثمان t، وكفاه فخرا أن ينتمي لحكم الخلافة الراشدة([40]).
ثانيًا: في العبادات والمعاملات:
1- إتمام عثمان الصلاة بمنى وعرفات:
في حج عام 29هـ صلى عثمان t بالناس بمنى أربعا، فأتى آتٍ عبدَ الرحمن بن عوف، فقال: هل لك في أخيك قد صلى بالناس أربعا؟ فصلى عبد الرحمن بأصحابه ركعتين، ثم خرج حتى دخل على عثمان، فقال له: ألم تصلِّ في هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ قال: بلى، قال: أفلم تصل مع أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى، قال: أفلم تصل مع عمر ركعتين؟ قال: بلى، قال: ألم تصل صدرا من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى، قال: فاسمع مني يا أبا محمد([41])، إني أخبرت أن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان، هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين، وقد اتخذت بمكة أهلا، فرأيت أن أصلي لخوف ما أخاف على الناس، وأخرى قد اتخذت بها زوجة، ولي بالطائف مال، فربما أطلعته فأقمت فيه بعد الصدر، فقال عبد الرحمن بن عوف: ما من هذا شيء لك فيه عذر، أما قولك: اتخذت أهلا، فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت وتقدم بها إذا شئت، إنما تسكن بسكناك، وأما قولك: ولي مال بالطائف فإنك بينك وبين الطائف مسيرة ثلاثة ليال وأنت لست من أهل الطائف، وأما قولك: يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون: هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين وهو مقيم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل، ثم أبو بكر مثل ذلك، ثم عمر، فضرب الإسلام بجرانه، فصلى لهم عمر حتى مات ركعتين، فقال عثمان: هذا رأي رأيته، فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا محمد، غير ما يعلم؟ قال: لا، قال: فما أصنع؟ قال: اعمل بما تعلم، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول (يعني تصلي معه أربعا)([42]).
إن عثمان صنع ما صنع من إتمام الصلاة في منى وعرفات شفقة على ضعفاء المسلمين أن يفتنوا في دينهم، فقد أبدى لفعله سببا معقولا حينما سأله عبد الرحمن بن عوف
عنه وعما دعاه إليه، فلما أطلعه عثمان على وجهة نظره، أخذ عبد الرحمن بقوله وأتم الصلاة بأصحابه، وكذلك صنع عبد الله بن مسعود وغيره من جمهور الصحابة، فتابعوه ولم يخالفوه؛ لأنه إمام راشد تجب متابعته فيما لم يخرج عن حدود الشريعة المطهرة، ولو كان فيما جاء به عثمان أدنى شبهة لمخالفة نص شرعي ما أمكن مطلقا جمهور الصحابة أن يتابعوه.([43])
والذي أبداه عثمان في تحاوره مع عبد الرحمن بن عوف واحتج به لرأيه معقول المعنى، ولو تأمل فيه ناظر في أسرار الدين وحكم الشريعة لرأى أن إتمام الصلاة الذي انتهى إليه رأي عثمان أرجح حينئذ من قصرها، وقد حدث من الأمور ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فخاف عثمان أن يفتن الناس في صلاتهم، ولا سيما جفاة الأعراب في مضاربهم، ومن بعدت بلادهم في أطراف الأرض، وقد لا يتصل بهم من أهل العلم من يعلمهم ويرشدهم، فأراد عثمان بما صنع حسم هذا الشر المخوف على كثير من ضعفاء المسلمين، وقد بالغ عثمان t في إبعاد الشبهة عن نفسه، فقال: إنه اتخذ بمكة أهلا، وله بالطائف مال ربما نظر إليه وأقام فيه بعد انتهاء الموسم، فيكون حينئذ مقيما ففرضه الإتمام، وذلك منه t من دقيق النظر في الدين، وفهم أسراره وحكمه.([44])
وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر، منهم: عائشة، وعثمان وسلمان، وأربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.([45]) فعثمان t لم يوجب القصر في السفر، وإنما كان يتجه كما رآه فقهاء المدينة ومالك والشافعي وغيرهما، ثم إنها مسألة اجتهادية، ولذلك اختلف فيها العلماء؛ فقوله فيها لا يوجب تكفيرا ولا تفسيقا.([46]) وأما قول ابن مسعود t: الخلاف شر([47]), وفي رواية: إني أكره الخلاف([48])، ففيه ترشيد لنا وتذكير على استحباب الخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد، ويحسن بالمسلم أن يستحضرها ويحاول أن يقلل الخوض والجدال في الفروع المختلف فيها([49])؛ إذ الظروف المحيطة بنا لا تساعدنا على إضاعة مزيد من الوقت الثمين في الجدل والخلاف عما يجب أن نفعله لمواجهة التحديات الخطيرة([50]), كما أن في فعل ابن مسعود وابن عوف -رضي الله عنهما- من الصلاة خلف عثمان بيانا لحرص الصحابة على الاجتماع والوحدة، وهذا خلق عظيم من أخلاق جيل النصر.
2- زاد الأذان الثاني يوم الجمعة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» ([51])، وهذه الزيادة من سنة الخلفاء الراشدين، ولا شك أن عثمان من الخلفاء الراشدين ورأى مصلحة أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رقعة المدينة، فاجتهد في هذا ووافقه جميع الصحابة، واستمر العمل به لم يخالفه أحد حتى في زمن علي وزمن معاوية وزمني بني أمية وبني العباس إلى يومنا هذا، فهي سنة بإجماع المسلمين.([52]) ثم هو له أصل في الشرع، وهو الأذان الأول في الفجر، فقاس عثمان هذا الأذان عليه.([53])
لقد سن عثمان ذلك أخذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأذانه الذي شرعه في الفجر قبل دخول الوقت لينبه النائم ويستعد اليقظان ومريد الصيام، فهو مستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآخذ من طريقته، وقد اختلف أهل العلم: هل أوقعه قبيل دخول الوقت كما هو الحال في الأذان الأول من الفجر أم أوقعه في الوقت؟ ويميل الحافظ إلى أن وقوعه كان إعلاما بالوقت، قال في فتح الباري: وتبين أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله، وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى.([54]) وأما الذين قالوا: إنه أحدث قبيل دخول الوقت، قالوا: لأن الغرض منه الإعلام بالجمعة والسعي إليها على غرار الأذان الأول في الفجر، فلو كان بعد دخول الوقت لما أدى المعنى المطلوب إلا بتأخير الجمعة بعض الشيء وهو خلاف السنة، وبه يُستغنى عما أحدثه في التذكير والذكر وغيرهما مما أشار إليه الحافظ ولم ينكره إلا بقوله: (واتباع السلف الصالح أولى) ([55]).
3- اغتساله كل يوم منذ أسلم:
كان عثمان بن عفان يغتسل كل يوم منذ أسلم([56])، وقد صلى ذات يوم الصبح بالناس وهو جنب دون أن يدري، فلما أصبح رأى في ثوبه احتلاما، فقال: كبرت والله إني لأراني أجنب ولا أعلم، ثم أعاد الصلاة([57]) ولم يعد من صلى خلفه([58]).
4- سجود التلاوة:
كان عثمان بن عفان يرى أن سجود التلاوة يجب على المكلف التالي للقرآن, وعلى الجالس لسماع القرآن، أما من سمعه من غير قصد فليس عليه سجود التلاوة، فقد مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد.([59]) وقوله: على من استمع: يعني على من قصد السماع. وقال t: إنما السجدة على من جلس لها([60])، وروى عن عثمان أن الحائض إذا استمعت السجدة تومئ بها إيماء ولا تتركها، ولا تسجد لها سجود الصلاة([61]).
5- صلاة الجمعة في السواحل:
قال الليث بن سعد: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة([62]).
6- استراحة عثمان في الخطبة:
عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة حتى شق القيام على عثمان فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما([63]).
7- جعل القنوت قبل الركوع:
قال أنس: إن أول من جعل القنوت قبل الركوع -أي دائما- عثمان؛ لكي يدرك الناس الركعة([64]).
8- أعلم الناس بأحكام الحج:
يقول محمد بن سيرين: كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك عثمان بن عفان، ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما([65]).
9- النهي عن الإحرام قبل الميقات:
لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: إن هذا نصر من الله لا بد لي من أن أشكره عليه، ولأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا - خراسان- محرما، فأحرم من نيسابور وخلف على خراسان الأحنف بن قيس، فلما قضى عمرته أتى عثمان، وذلك في السنة التي قتل فيها، فقال له عثمان: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور([66]).
10- سفر المعتدة للحج والعمرة:
المعروف أن المعتدة لا تبيت إلا في بيتها، ولا تسافر إلا بعد انتهاء عدتها؛ لأن سفرها يقتضي مبيتها في غير بيتها، والحج لا يخلو من سفر، ولذلك فإن عثمان كان يرى أن المعتدة لا يلزمها الحج ما دامت في العدة، و كان t يرجع المعتدة حاجة أو معتمرة من الجحفة وذي الحليفة([67]).
11- النهي عن متعة الحج:
نهى عثمان المتعة أو الجمع بينهما ليعمل بالأفضل لا ليبطل المتعة، ولا يخفى على عثمان ومن دونه أن من أراد الإحرام فهو مخير بين الإفراد والقران والتمتع، ولكنه t رأى الإفراد أفضل من الاثنين، فعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا -رضي الله عنهما- وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى عليٌّ ذلك أهلَّ بهما وقال: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.([68]) ولم ينكر عثمان على علي ذلك منه؛ لأن عليا t يخشى أن يحمل غيره النهي على الإبطال والتحريم، وإنما قال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، ليظهر جواز ذلك وأنها سنة ماضية، وكلاهما مجتهد مأجور.([69])
وفي الحديث من الفوائد الظاهرة: مناظرة العلماء ولاة الأمر بقصد إشاعة العلم ومناصحة المسلمين، وسعة صدر الولاة لاجتهاد العلماء في المسائل التي يتسع معها الاجتهاد، وأن المجتهد لا يجبر مجتهدا آخر باتباعه لسكوت عثمان عن علي، وفيه أن العلم يسبق القول والعمل([70]).
12- أكل لحم الصيد:
لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صاده هو، أو صاده غيره من الحلال([71]), فعن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب، فلما كان بالروحاء قدم لهم لحم طير (يعاقيب)، فقال عثمان: كلوا، وكره أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا؟ قال عثمان: لست في ذلكم مثلكم، إنما صيدت لي، وأميتت باسمي، أو قال: من أجلي.([72]) وقد تكرر ذلك من عثمان مرة أخرى، كما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أُتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: ألا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي([73]).
13- كراهية الجمع بين القرابة في الزواج:
أخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه، عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن([74]).
14- في الرضاعة:
روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أرضعتهم([75]).
15- في الخلع:
عن الرُبيع بنت معوذ قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام -وكان زوجها- قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فجئت عثمان وهو محصور فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها.([76]) وفي رواية: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان([77]).
16- يجب الإحداد على المعتدة لوفاة زوجها:
ومن الإحداد ترك الزينة، وترك المبيت في غير البيت الذي توفى فيه زوجها إلا لضرورة، ويجوز لها أن تخرج نهارا لقضاء حاجتها، ولكنها لا تبيت في المساء إلا في بيتها([78])؛ فعن فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله، فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعيد له، فقتلوه بطرف القدوم، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله أو أمر بي فنوديت، فقال: (كيف قلت؟) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان ابن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك؟ فأخبرته، فاتبعه وقضى به.([79]) ولذلك كان عثمان يتشدد في أمر مبيت المرأة المعتدة خارج بيتها، فقد حدث أن امرأة توفي عنها زوجها زارت أهلها في عدتها، فضربها الطلق فأتوا عثمان فسألوه فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق([80]).
17- لا تنكحها إلا نكاح رغبة:
جاء رجل إلى عثمان في خلافته وقد ركب، فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، فقال له عثمان: إني الآن مستعجل، فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك، فركب خلفه، فقال: إن لي جارا طلق امرأته في غضبه، ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم ابتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة([81]).
18- طلاق السكران:
كان عثمان بن عفان t يرى أن كل ما يتكلم به السكران فهو هدر، فلا تصح عقوده، ولا فسوخه، ولا إقراره، ولا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعي ما يقول ولا يريد ما يقول، ولا إلزام لغير إرادة.([82]) قال عثمان t: ليس لسكران ولا مجنون طلاق([83]).
19- هبة الوالد لولده:
إذا نحل الأب ولده نحلة، كان عليه أن يشهد على هذه الهبة، فإذا أشهد عليها اعتبر هذا الإشهاد قبضا لها، وصح أن تبقى بعد ذلك في يد الأب، فقد ورد عن عثمان بن عفان t قوله: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحلة، فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي جائزة وإن وليها أبوه([84])، وأما إذا لم يشهد ولم يسلمها للولد فهي هبة غير لازمة. قال عثمان t: ما بال أقوام يعطي أحدهم ولده العطية، فإن مات ولده قال: مالي وفي يدي، وإن مات هو قال: وهبته، لا يثبت من الهبة إلا ما حازه الولد من مال أبيه([85]).
20- الحجر على السفيه:
كان عثمان بن عفان يرى الحجر على السفيه؛ فقد حدث أن اشترى عبد الله بن جعفر أرضا بمبلغ ستين ألف دينار، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب، فقرر على أن الأرض لا تساوي هذا المبلغ من المال، وأن عبد الله بن جعفر قد غُبِن فيها غبنًا فاحشا، بل إنه قد تصرف تصرفا أخرق، وأعرب أنه سيتوجه نحو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ليطلب منه الحجر على عبد الله بن جعفر لسفهه وإساءته التصرف في ماله، فأسرع عبد الله بن جعفر إلى الزبير -وكان تاجرا حاذقا- وقال له: إني ابتعت بيعا بكذا وكذا، وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر عليَّ، فقال له الزبير: فأنا شريكك في البيع، وأتى عليَّ عثمان بن عفان فقال له: إن ابن أخي اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي، فاحجر عليه، وقال الزبير لعثمان: أنا شريكه في هذا البيع، فقال عثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟([86])يعني: إننا لا نستطيع أن نحكم على جعفر بالسفه لتصرف تصرَّفه شريكه فيه الزبير؛ لأن الزبير لا يمكن أن يشارك في تصرف تجاري أخرق لحذقه بالتجارة([87]).
21- الحجر على المفلس:
كان عثمان بن عفان t يرى الحجر على المفلس، وإذا حجر على مفلس اقتسم الدائنون ماله بنسبة ديونهم، لكن إن وجد بعض دائنيه سلعته التي باعه إياها بعينها عنده، جاز له أن يفسخ البيع ويأخذ سلعته([88]), فهو أحق بها من غيره([89]).
22- تحريم الاحتكار:
كان عثمان بن عفان t يمنع الاحتكار وينهى عنه([90])، ويظهر أن عثمان بن عفان كان كسلفه عمر بن الخطاب لا يفرق في تحريم الاحتكار بين الطعام وغيره؛ لأن نهيه عن الاحتكار كان عاما، خاصة أن ما ورد عن رسول الله في تحريم الاحتكار منه ما هو مطلق في كل شيء، ومنه ما هو مقيد عند الجمهور لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه([91]).
23- ضوال الإبل:
روى مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مرسلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.([92]) وقد كان فعل عمر تبعا لحديث الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني t قال: جاء أعرابي النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها([93]), ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك، أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها([94]).
وقد رأى الأستاذ الحجوي أن هذا الاجتهاد من عثمان بن عفان t مبني على المصلحة المرسلة؛ أنه رأى الناس مدوا أيديهم إلى ضوال الإبل، فجعل راعيا يجمعها، ثم تباع قياما بالمصلحة العامة.([95]) غير أن الأستاذ عبد السلام السليماني، رد على هذا القول بقوله: غير أنه من الصعب التسليم بمقالة الأستاذ الحجوي على إطلاقها؛ لأن المصلحة المرسلة هي التي لم ينص الشارع لا على اعتبارها ولا على إلغائها، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على حكم ضوال الإبل في الحديث المذكور أعلاه، فهي إذن مصلحة معتبرة نص عليها النبي بنفسه، فلا يصح أن يقال إن ما فعله عثمان من بيع ضوال الإبل يعد مصلحة مرسلة، فالمصلحة المرسلة لا تكون في مقابلة النص.
والذي يظهر لنا أن اجتهاد عثمان في هذه القضية بني على المصلحة العامة فعلا لكنها ليست مصلحة مرسلة، وأن هذه القضية من القضايا القابلة للاجتهاد، والتي يمكن أن يتغير حكمها بتغير الأزمنة والأحوال, وبالنظر إلى ما يحقق مصلحة أصحاب ضوال الإبل؛ لأن علة الحكم فيها على ما يظهر، هي المحافظة على هذه الإبل إما بأعيانها أو في شكل ثمنها وكلا الأمرين مصلحة، ولا شك أن سيدنا عثمان بصنيعه هذا كان هدفه تحقق المصلحة العامة؛ لأنه رأى أن ترك الإبل على حالها -كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمن عمر- يعرضها للضياع، بعد أن تغيرت أخلاق الناس، وأصبحوا يمدون أيديهم لضوال الإبل، فرأى أن يقطع الطريق عليهم بما فعل، وهو اجتهاد سليم وحكم سديد بلا ريب([96]).
24- توريث المرأة المطلقة في مرض الموت:
طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريض فورَّثها عثمان منه بعد انقضاء مدة عدتها، وقد روى أن شريحا كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض, فأجاب عمر: أن ورِّثها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا ميراث لها. فبعد أن اتفقا على أن طلاق المريض مرض الموت لا يزيل الزوجية كسبب موجب للإرث، جعل عمر حدا لذلك وهو العدة، بينما لم يجعل عثمان حدا لذلك، وقال: ترث مطلقها سواء مات في العدة أو بعدها، وليس في المسألة نص يرجع إليه، والباعث على الحكم هو معاملة الزوج بنقيض قصده؛ لأن الزوج بطلاقه في مرض الموت يعتبر فارا من توريث زوجته([97]).
25- توريث المطلقة ما لم تنقضِ عدتها:
قال عثمان بن عفان: إذا مات أحد الزوجين قبل الحيضة الثالثة للمطلقة ورث الحي منهما الميت([98]), ولا يمنع التوارث بينهما طوال فترة العدة، كما إذا حاضت المعتدة حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها؛ فقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية، فقيل له: إن امرأتك ترث، فقال: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد من النساء اللائي يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللائي لم يحضن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة الوفاة وورثت زوجها حبان بن منقذ([99]).
26- توريث الحميل:
إذا سبيت امرأة من الكفار ومعها طفل تحمله مدعية أنه ولدها، وهو ما يسمى بـ (الحميل)، فإنها لا تصدق بدعواها، ولا يجري التوارث بينها وبينه إلا إذا أقامت البينة على أنه ابنها. وقد استشار عثمان في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبدى كل منهما رأيه, وقال عثمان آنئذ: ما نرى أن نورث مال الله إلا بالبينات، وقال: لا يورث الحميل إلا ببينة([100]).
هذه بعض اجتهادات ذي النورين أثرت في المؤسسة القضائية في مجال القصاص والحدود والجنايات والتعزير، كما أنه ساهم في تطوير المدارس الفقهية الإسلامية باجتهاداته الدالة على سعة اطلاعه، وغزارة علمه وعمق فهمه واستيعابه لمقاصد الشريعة الغراء، فهو خليفة راشد، أعماله تسترشد بها الأمة في مسيرتها الطويلة لنصرة دين الله تعالى وإعزازه.
([1]) تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي، ص83، 84.
([2]) النظم الإسلامية، (1/378)، وقائع ندوة أبي ظبي، 1405هـ.
([3]) عصر الخلافة الراشدة، ص143.
([4]، 4) النظم الإسلامية (1/378).
([5]) النظم الإسلامية، (1/378).
([6]) الولاية على البلدان (2/92).
([7]) مسند الإمام أحمد، رقم (475)، حسن لغيره.
([8]) أشهر مشاهير الإسلام (4/740).
([9]) عصر الخلافة الراشدة، ص159، 160.
([10]) البداية والنهاية (7/154).
([11]) ودى: وقع دية القتلى.
([12]) البداية والنهاية (7/154).
([13]) تاريخ الطبري (5/243)، إسناده لا يصح.
([14]) الطبقات الكبرى (3/350-355).
([15]) الخلافة والخلفاء الراشدون، ص218، 1219.
([16]) تاريخ الطبري (5/272).
([17]) عصر الخلافة الراشدة، ص153.
([18]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص169، 170.
([19]) المصدر نفسه، ص99.
([20]) المصدر نفسه، ص100.
([21]) موسوعة فقه عثمان، ص102. (2) المصدر نفسه، ص103.
([23]) المصدر نفسه، ص150. (4) سنن البيهقي (8/17).
([25]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص93.
([26]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص93.
([27]) أي: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها.
([28]) شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الحدود (11/216).
([29]) ولاية الشرطة في الإسلام، د. نمر الحميداني، ص105.
([30]) المصدر نفسه، ص104.
([31]) صحيح التوثيق، ص77, موسوعة فقه عثمان، ص171.
([32]) تاريخ الطبري (5/420).
([33]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص247.
([34]) المصدر نفسه، ص164.
([35]) تاريخ الطبري (5/419).
([36]) الطبقات (4/32).
([37]) تاريخ خليفة بن خياط، ص179.
([38]) ولاية الشرطة في الإسلام، ص105.
([39]) المصدر نفسه، ص106.
([40]) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (1/409).
([41]) أبو محمد كنية عبد الرحمن بن عوف.
([42]) تاريخ الطبري (5/268).
([43]) عثمان بن عفان، صادق عرجون، ص192. (2) المصدر السابق، ص194.
([45]) كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني، ص312.
([46]) الرياض النضرة، ص566. (5) تاريخ الطبري (5/268).
([48]) القواعد الفقهية للندوي، ص336. (7) فقه الأولويات، محمد الوكيلي، ص169.
([50]) الفكر الإسلامي بين المثالية والتطبيق، كامل الشريف، ص29.
([51]) سنن أبي داود، كتاب السنة رقم (4607). سنن الترمذي، كتاب العلم، رقم (2676).
([52]) حقبة من التاريخ، عثمان الخميس، ص88. (3) المصدر نفسه، ص89.
([54]) فتح الباري (4/345).
([55]) السنة والبدعة، عبد الله باعلوي الحضرمي، ص132، 133.
([56]) فضائل الصحابة رقم (756)، إسناد حسن.
([57]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص190.
([58]) المصدر نفسه، ص192.
([59]) الخلافة الراشدة والدولة الأموية، د. يحيى اليحيى، ص444.
([60]، 5) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص168.
([62]) فتح الباري (2/441).
([63]) الخلافة الراشدة، يحيى اليحيى، ص(444).
([64]) المصدر نفسه، ص444، فتح الباري (2/569).
([65]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص112.
([66]) سنن البيهقي (5/31)، موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص17.
([67]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص112.
([68]) البخاري، كتاب الحج، رقم (1563).
([69]) شهيد الدار عثمان بن عفان، ص86.
([70]) شهيد الدار عثمان بن عفان، ص86.
([71]، 3) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص20.
([72]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص20.
([73]) سنن البيهقي (5/191)، موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص20.
([74]) الخلافة الراشدة، د. يحيى اليحيى، ص449.
([75]) الفتح (5/18).
([76]) الطبقات (8/448). (2) الخلافة الراشدة، د. يحيى اليحيى، ص449.
([78]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص244. (4) المصدر نفسه، ص224، الموطأ (2/591).
([80]) المصدر نفسه، ص225. (6) المصدر نفسه، ص81.
([82]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص53, الفتاوى (14/72).
([83]) الفتاوى (33/61)، موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص53.
([84]) سنن البيهقي (6/170), موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص288.
([85]) الفتاوى (31/154).
([86]) سنن البيهقي (6/661), موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص119.
([87]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص119.
([88]) سنن البيهقي (6/46).
([89]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص119.
([90]) موطأ مالك (2/651).
([91]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص15.
([92]) موطأ مالك، ص648، 649، طبعة دار الآفاق الجديدة.
([93]) العفاص: الوعاء الذي تحفظ فيه النفقة، والوكاء: الخيط الذي يربط به.
([94]) البخاري، كتاب اللقطة رقم (2427، 2428، 2429).
([95]) الفكر السامي (1/245). (2) الاجتهاد في الفقه الإسلامي، ص143، 144.
([97]) تاريخ التشريع الإسلامي للخضري، ص118. نشأة الفقه الاجتهادي، محمد السايس، ص27. الاجتهاد في الفقه الإسلامي، ص142.
([98]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص28.
([99]) سنن البيهقي (7/419). موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص29.
([100]) موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص28.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 3130
تاريخ التسجيل : 31 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 2,291
- شكراً و أعجبني للمشاركة

- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 12
معدل تقييم المستوى
: 16

الفصل الرابع الفتوحات في عهد عثمان بن عفان
تمهيد:
شجع خبر مقتل عمر بن الخطاب أعداء الإسلام وخصوصا في بلاد الفرس والروم إلى الطمع في استرداد ملكهم، فبدأ يزدجر ملك الفرس يخطط في العاصمة التي يقيم فيها وهي مدينة (فرغنة) عاصمة سمرقند، وأما زعماء الروم فقد تركوا بلاد الشام وانتقلوا إلى القسطنطينية العاصمة البيزنطية، وبدأوا في عهد عثمان في البحث عن الوسائل التي تمكنهم من استرداد ملكهم. وكانت بقايا جيوش الروم في مصر وقد تحصنوا بالإسكندرية في عهد عمر بن الخطاب، فطلب عمرو بن العاص منه أن يأذن بفتحها، وكانت معززة بتحصينات كثيرة وكانت المجانيق فوق أسوارها، وكان هرقل قد عزم أن يباشر القتال بنفسه ولا يتخلف أحد من الروم؛ لأن الإسكندرية هي معقلهم الأخير.([1]) وفي عصر عثمان تجمع الروم في الإسكندرية وبدأوا يبحثون عن وسيلة لاسترداد ملكهم فيها، حتى وصل بهم الأمر إلى نقض الصلح واستعانوا بقوة الروم البحرية([2])، فأمدوهم بثلاثمائة سفينة بحرية تحمل الرجال والسلاح.
ولقد واجه عثمان ذلك كله بسياسة تتسم بالحسم والعزم وتمثلت في الخطة الآتية:
1- إخضاع المتمردين من الفرس والروم وإعادة سلطان الإسلام إلى هذه البلاد.
2- استمرار الجهاد والفتوحات فيما وراء هذه البلاد؛ لقطع المدد عنهم.
3- إقامة قواعد ثابتة يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد الإسلامية.
4- إنشاء قوة بحرية عسكرية لافتقار الجيش الإسلامي إلى ذلك([3]).
كانت معسكرات الإسلام ومسالحه في عهد عثمان هي عواصم أقطاره الكبرى، فمعسكر العراق الكوفة والبصرة، ومعسكر الشام في دمشق بعد أن خلص الشام كله لمعاوية بن أبي سفيان ومعسكر مصر، وكان مركزه الفسطاط، وكانت هذه المعسكرات تقوم بحماية دولة الإسلام ومواصلة الفتوحات، ونشر الإسلام([4]).
([1]) الخلافة والخلفاء الراشدون، ص221.
([2]) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ص324.
([3]) الخلافة والخلفاء الراشدون، ص222.
([4]) عثمان بن عفان صادق عرجون، ص 199، 200.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 3130
تاريخ التسجيل : 31 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 2,291
- شكراً و أعجبني للمشاركة

- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 12
معدل تقييم المستوى
: 16

المبحث الأول فتوحات عثمان في المشرق
أولاً: فتوحات أهل الكوفة: أذربيجان 24 هـ:
كانت مغازي أهل الكوفة الري وأذربيحان، وكان يرابط بها عشرة آلاف مقاتل؛ ستة آلاف بأذربيجان، وأربعة آلاف بالري، وكان جيش الكوفة العامل أربعين ألف مقاتل، يغزو كل عام منهم عشرة آلاف، فيصيب الرجل غزوة كل أربعة أعوام. ولما أخلص عثمان t الكوفة للوليد ابن عقبة انتفض أهل أذربيجان، فمنعوا ما كانوا قد صالحوا عليه حذيفة بن اليمان أيام عمر، وثاروا على واليهم عقبة بن فرقد، فأمر عثمان الوليد أن يغزوهم، فجهز لهم قائده سليمان بن ربيعة الباهلي، وبعثه مقدمة أمامه في طائفة من الجند، ثم سار الوليد بعده في جماعة من الناس، فأسرع إليه أهل أذربيجان طالبين الصلح على ما كانوا صالحوا عليه حذيفة، فأجابهم الوليد وأخذ طاعتهم، وبث فيمن حولهم السرايا وشن عليهم الغارات، فبعث عبد الله بن شبيل الأحمسي في أربعة آلاف إلى أهل موقان والببر الطيلسان، فأصاب من أموالهم وغنم وسبي، ولكنهم تحرزوا منه فلم يفلّ حدَّهم، ثم جهز سليمان الباهلي في اثني عشر ألفا إلى أرمينية فأخضعها وعاد منها مليء اليدين بالغنائم، وانصرف الوليد بعد ذلك عائدا إلى الكوفة.([1])
ولكن أهل أذربيجان تمردوا أكثر من مرة، فكتب الأشعث بن قيس والي أذربيجان إلى الوليد بن عقبة فأمده بجيش من أهل الكوفة، وتتبع الأشعث الثائرين وهزمهم هزيمة منكرة، فطلبوا الصلح فصالحهم على صلحهم الأول، وخاف الأشعث أن يعيدوا الكَرَّة فوضع حامية من العرب وجعل لهم عطايا وسجلهم في الديوان، وأمرهم بدعوة الناس إلى الإسلام. ولما تولى أمرهم سعيد بن العاص عاد أهل أذربيجان وتمردوا على الوالي الجديد، فبعث إليه جرير بن عبد الله البجلي فهزمهم وقتل رئيسهم، ثم استقرت الأمور بعد أن أسلم أكثر شعبها وتعلموا القرآن الكريم. وأما الري فقد صدر أمر الخليفة عثمان إلى أبي موسى الأشعري وفي وقت ولايته على الكوفة، وأمره بتوجيه جيش إليها لتمردها، فأرسل إليها قريظة بن كعب الأنصاري فأعاد فتحها([2]).
ثانيًا: مشاركة أهل الكوفة في إحباط تحركات الروم:
عندما انتهى الوليد بن عقبة من مهمته في أذربيجان وعاد إلى الموصل جاءه أمر من الخليفة عثمان نصه: (أما بعد، فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إليَّ يخبرني أن الروم قد أجلبت([3]) على المسلمين بجموع عظيمة، وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة، فإذا أتاك كتابي هذا فابعث رجلا ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي([4])، والسلام). فقام الوليد في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أبلى المسلمين في هذا الوجه بلاء حسنا، ورد عليهم بلادهم التي كفرت، وفتح بلادا لم تكن افتتحت، وردهم سالمين غانمين مأجورين، فالحمد لله رب العالمين. وقد كتب إليَّ أمير المؤمنين يأمرني أن أندب منكم ما بين العشرة آلاف إلى الثمانية آلاف، تمدون إخوانكم من أهل الشام، فإنهم قد جاشت عليهم الروم، وفي ذلك الأجر العظيم والفضل المبين. فانتدبوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهلي، فانتدب الناس، فلم يمضِ ثالثة حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة، فمضوا حتى دخلوا وأهل الشام إلى أرض الروم، وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بن خالد الفهري، وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلي، فشنوا الغارات على أرض الروم، فأصاب الناس ما شاءوا من سبي، وملأوا أيديهم من المغنم، وافتتحوا بها حصونا كثيرة.([5]) وفي جهاد الوليد وغزوه يقول بعض الرواة: رأيت الشعبي جلس إلى محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة، فذكر محمد غزوة مسلمة بن عبد الملك، فقال الشعبي: كيف لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته؟ إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا ما قصر ولا انتقض عليه أحد حتى عزل من عمله([6]).
ثالثـًا: غزوة سعيد بن العاص طبرستان 30 هـ:
غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين يريد خراسان ومعه حذيفة بن اليمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الحسن والحسين, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد خراسان، فسبق سعيدا ونزل أبرشهر، وبلغ نزوله أبرشهر سعيدا، فنزل سعيد قوميس، وهي صلح، صالحهم حذيفة بعد نهاوند، فأتى جرجان فصالحوه على مائتي ألف، ثم أتى طميسة، وهي كلها من طبرستان جرجان، وهي مدينة على ساحل البحر، وهي في تخوم جرجان، فقاتله أهلها حتى صلى صلاة الخوف، فقال لحذيفة: كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره فصلى بها سعيد صلاة الخوف وهم يقتتلون، وضرب يومئذ سعيد رجلا من المشركين على حبل عاتقه، فخرج السيف من تحت مرفقه، وحاصرهم, فسألوا الأمان فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلا واحدا، ففتحوا الحصن، فقتلهم جميعا إلا رجلا واحدا، وحوى ما كان في الحصن، فأصاب رجل من بني نهد سفطا عليه قفل، فظن فيه جواهر، وبلغ سعيدا، فبعث إلى النهدي فأتاه بالسفط فكسروا قفله، فوجدوا فيه سفطا ففتحوه فإذا فيه خرقة صفراء وفيها أيران: كميت وورد.([7]) وعندما قفل سعيد إلى الكوفة، مدحه كعب بن جعبل فقال:
فنعم الفتى إذا جال جيلان دونه
|
|
وإذا هبطوا من دستبي ثم أبهرا
|
تعلم سعيد الخير أن مطيتي
|
|
إذا هبطت أشفقت مِنْ أن تُعْقرا
|
كأنك يوم الشعب لَيْث خفَّية
|
|
تحرَّدَ من ليث العرين وأصْحَرَا
|
تسوس الذي ما ساس قبلك واحد
|
|
ثمانين ألفا دارعين وحُسَّرا([8])
|
رابعًا: هروب ملك الفرس (يزدجرد) إلى خراسان:
قدم ابن عامر البصرة ثم خرج إلى فارس فافتتحها، وهرب يزدجرد من وجوز -وهي أردشير خرة- في سنة ثلاثين، فوجه ابن عامر في أثره مجاشع بن مسعود السلمي، فاتبعه إلى كرمان، فنزل مجاشع السيرجان بالعسكر, وهرب يزدجرد إلى خراسان([9]).
خامسًا: مقتل يزدجرد ملك الفرس 31 هـ:
اختلف في سبب ذكر قتله كيف كان، قال ابن إسحاق: هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو، فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم، فبعثوا إلى الترك يستفزونهم عليه، فأتوه فقتلوا أصحابه، وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقر الأرحاء([10]) على شط المرغاب([11]) فأوى إليه ليلا، فلما نام قتله.([12]) وجاء في رواية عند الطبري: بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إياها، فأخذ على طريق الطبسين وقهمستان، حتى شارف مرو في زهاء أربعة آلاف رجل، ليجمع من أهل خراسان جموعا، ويكر إلى العرب ويقاتلهم، فتلقاه قائدان متباغضان متحاسدان كانا بمرو، يقال لأحدهما براز والآخر سنجان، ومنحاه الطاعة، وأقام بمرو، وخص براز فحسده ذلك سنجان، وجعل براز يبغي سنجان الغوائل، ويوغل صدر يزدجرد عليه، وسعى سنجان حتى عزم على قتله، وأفشى ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرأة من نسائه كان براز واطأها، فأرسلت إلى براز بنسوة زعمت بإجماع يزدجرد على قتل سنجان، وفشا ما كان عزم عليه يزدجرد من ذلك، فنذر([13]) سنجان وأخذ حذره، وجمع جمعا كنحو أصحاب براز، ومن كان مع يزدجرد من الجند، وتوجه نحو القصر الذي كان يزدجرد نازله، وبلغ ذلك براز، فنكص عن سنجان لكثرة جموعه، ورعب جمع سنجان يزدجرد وأخافه، فخرج من قصره متنكرا، ومضى على وجهه راجلا لينجو بنفسه، فمشى نحو من فرسخين حتى وقع إلى رحا فدخل بيت الرحا فجلس فيه كالا([14]) لغبا([15])، فرآه صاحب الرحا ذات هيئة وطرة وبرزة كريمة، ففرش له، فجلس وأتاه بطعام فطعم، ومكث عنده يوما وليلة، فسأله صاحب الرحا أن يأمل له بشيء فبذل له منطقه مكللة بجوهر كانت عليه، فأبى صاحب الرحا أن يقبلها، وقال: إنما كان يرضيني من هذه المنطقة أربعة دراهم كنت أطعم بها وأشرب، فأخبره أنه لا ورق معه، فتملقه صاحب الرحا حتى إذا غفا قام إليه بفأس له فضرب بها هامته فقتله، واحتز رأسه وأخذ ما كان عليه من ثياب ومنطقه, وألقى جيفته في النهر الذي كان تدور بمائه رحاه وبقر بطنه، وأدخل فيه أصولا من أصول طرفاء([16]) كانت نابتة في ذلك النهر لتجس جثته في الموضع الذي ألقاه فيه، فلا يسفل فيعرف ويطلب قاتله، وما أخذ من سلبه, وهرب على وجهه.([17]) وجاء في رواية: وجاءت الترك في طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله، فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته، وأخذوا ما كان مع كسرى، ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه
إلى اصطخر([18]).
وقد ذكر الطبري حديثين مطولين، وأحدهما أطول من الآخر يتضمن ضروبا من الاضطرابات تقلب فيها، وأنواعا من الدوائر دارت عليه حتى كانت منيته آخرها.([19]) وقد قال يزدجرد لمن أراد قتله في بعض الروايات ألا يقتلوه وقال لهم: ويحكم، إنا نجد في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنيا، مع ما هو قادم عليه، فلا تقتلوني وائتوا بي إلى الدهقان، أو سرحوني إلى العرب فإنهم يستحيون مثلي من الملوك.([20]) وكان مُلْك يزدجرد عشرين سنة منها أربعة سنين في دعة، وباقي ذلك هاربا من بلد إلى آخر، خوفا من الإسلام وأهله، وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا على الإطلاق.([21]) فسبحان ذي العظمة والملكوت، الملك الحق الحي الدائم الذي لا يموت، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.([22]) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملوك الفرس والروم: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». ([23])
سادسًا: تعاطف النصارى مع يزدجرد بعد مقتله:
بلغ قتل يزدجرد رجلا من أهل الأهواز كان مطرانا على مرو يقال له إيلياء، فجمع من كان قبله من النصارى، وقال لهم: إن ملك الفرس قد قتل، وهو ابن شهريار بن كسرى، وإنما شهريار ولد شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل ملتها من غير وجه، ولهذا الملك عنصر في النصرانية مع ما نال النصارى في ملك جده كسرى من الشرف. وقبل ذلك في مملكة ملوك من أسلافه من الخير، حتى بنى لهم بعض البِيَع، وسدد لهم بعض ملتهم، فينبغي لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان إسلافه وجدته شيرين إلى النصارى، وقد رأيت أن أبني له ناووسا([24]), وأحمل جثته في كرامة حتى أواريها فيه، فقال النصارى: أمرنا لأمرك أيها المطران تبع، ونحن لك على رأيك هذا مواطئون، فأمر المطران فبنى في جوف بستان المطارنة بمرو ناووسا، ومضى بنفسه ومعه نصارى مرو حتى استخرج جثة يزدجرد من النهر وكفنها، وجعلها في تابوت، وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتى أتوا به الناووس الذي أمر ببنائه له وواروه فيه، وردموا بابه([25]).
سابعًا: فتوحات عبد الله بن عامر 31 هـ:
في هذه السنة 31 هـ شخص عبد الله بن عامر إلى خراسان ففتح أبرشهر وطوس وبيورد ونسا حتى بلغ سرخس، وصالح فيها أهل مرو. وقد جاء في رواية عن السكن بن قتادة العُريني قال: فتح ابن عامر فارس ورجع إلى البصرة، واستعمل على إصطخر شريك بن الأعور الحارثي، فبنى شريك مسجد إصطخر، فدخل على ابن عامر رجل من بني تميم كنا نقول: إنه الأحنف -ويقال: أوس بن جابر الجشمي جُشَم تميم- فقال له: إن عدوك منك هارب، وهو لك هائب، والبلاد واسعة، فسِرْ فإن الله ناصرك ومعز دينه، فتجهز ابن عامر، وأمر الناس بالجهاز للمسير، واستخلف على البصرة زيادا، وسار إلى كرمان، ثم أخذ إلى خراسان؛ فقوم يقولون: أخذ طريق أصبهان، ثم سار إلى خراسان، واستعمل على كرمان مجاشع بن مسعود السلمي، وأخذ ابن عامر على مفازة وابَر، وهي ثمانون فرسخا، ثم سار إلى الطَّبَسين يريد أبرشهر، وهي مدينة نيسابور، وعلى مقدمته الأحنف بن قيس، فأخذ إلى قُهستان، وخرج إلى أبرشهر فلقيه الهباطلة، وهم أهل هراة، فقاتلهم الأحنف فهزمهم، ثم أتى ابن عامر نيسابور.([26])
وجاء في رواية: نزل ابن عامر على أبرشهر فغلب على نصفها عنوة، وكان النصف الآخر في يد كناري، ونصف نساوطوس، فلم يقدر ابن عامر أن يجوز إلى مرو، فصالح كنارى، فأعطاه ابنه أبا الصلت ابن كنارى وابن أخيه سليمًا رهنًا. ووجه عبد الله بن خازم إلى هراة، وحاتم بن النعمان إلى مرو، وأخذ ابن عامر ابني كنارى، فصار إلى النعمان بن الأفقم النصري فأعتقهما([27])، وفتح ابن عامر ما حول مدينة أبرشهر، كطوس وبيورد، ونسا وحمران، حتى انتهى إلى سرخس، وسرح ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي -عدى الرباب- إلى ببهق وهو من أبرشهر، بينهما وبين أبرشهر ستة عشر فرسخا، ففتحها وقتل الأسود بن كلثوم، وكان فاضلا في دينه، وكان من أصحاب عامر بن عبد الله العنبري. وكان عامر يقول بعدما أخرج من البصرة: ما آسى من العراق على شيء إلا على ظماء الهواجر، وتجاوب المؤذنين، وإخوان مثل الأسود بن كلثوم.([28]) واستطاع ابن عامر أن يتغلب على نيسابور، وخرج إلى سرخس، فأرسل إلى أهل مرو يطلب الصلح، فبعث إليهم ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي، فصالح براز مرزبان مرو على ألفي ألف ومائتي ألف([29]).
ثامنًا: غزوة الباب وبلنجر سنة 32هـ:
كتب عثمان بن عفان t إلى سعيد بن العاص: أن اغزُ سلمان الباب، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: أن الرعية قد أبطر كثيرا منهم البطنة، فقصر، ولا تقتحم بالمسلمين، فإني خاشٍ أن يبتلوا، فلم يزجر ذلك عبد الرحمن عن غايته، وكان لا يقصر عن بلنجر، فغزا سنة تسع من إمارة عثمان حتى إذا بلغ بلنجر حصروها ونصبوا عليها المجانيق والعرادات([30])، فجعل لا يدنو منها أحد إلا أعنتوه أو قتلوه، فأسرعوا في الناس([31])، ثم إن الترك اتعدوا يوما فخرج أهل بلنجر، وتوافت إليهم الترك فاقتتلوا، فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة (وكان يقال له ذو النورين)، وانهزم المسلمون فتفرقوا، فأما من أخذ طريق سلمان بن ربيعة فحماه حتى خرج من الباب، وأما من أخذ طريق الخزر وبلادها فإنه خرج على جيلان وجرجان وفيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة، وأخذ القوم جسد عبد الرحمن فجعلوه في سفط فبقى في أيديهم، فهم يستسقون به إلى اليوم ويستنصرون به.([32])
1- مقتل يزيد بن معاوية: غزا أهل الكوفة بلنجر سنين من إمارة عثمان لم تَئِم([33]) فيهن امرأة، ولم ييتم فيهن صبي من قتل، حتى كان سنة تسع من خلافة عثمان قبل المزاحفة بيومين رأى يزيد بن معاوية أن غزالا جيء به إلى خبائه لم يرَ غزالا أحسن منه حتى لف في ملحفته، ثم أتى به قبر عليه أربعة نفر لم يرقبوا أشد استواء منه ولا أحسن منه حتى دفن فيه، فلما تفادى الناس على الترك رمى يزيد بحجر، فهشم رأسه، فكأنما زين ثوبه بالدماء زينة، وليس بتلطخ، فكان ذلك الغزال الذي رأى.([34]) وكان يزيد رقيقا جميلا رحمه الله، وبلغ ذلك عثمان فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتكث أهل الكوفة، اللهم تب عليهم وأقبل بهم.([35])
2- ما أحسن حمرة الدماء في بياضك: كان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه أبيض: ما أحسن حمرة الدماء في بياضك، فأصيب عند الالتحام مع العدو بجراحة، فرأى قباءه كما اشتهى وقتل.([36])
3- ما أحسن لمع الدماء على الثياب: كان القرشع يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب، فلما كان يوم المزاحفة قاتل القرشع حتى خُرِّق بالحراب، فكأنما كان قباؤه ثوبا أرضه بيضاء ووشيه أحمر، وما زال الناس ثبوتا حتى أصيب، وكانت هزيمة الناس مع مقتله([37]).
4- إن هؤلاء يموتون كما تموتون: كان الترك في تلك المعركة قد اختفوا في الغياض([38])، وكانوا قد خافوا المسلمين واعتقدوا أن السلاح لا يعمل فيهم، واتفق أن تركيًا اختفى في غيضة ورشق مسلمًا بسهم فقتله، فنادى في قومه إن هؤلاء يموتون، فلم تخافوهم؟ فاجترأ الترك على المسلمين وخرجوا عليهم من مكانهم وأوقعوا بهم، واشتد القتال فثبت عبد الرحمن حتى استشهد.([39])
5- صبرًا آل سلمان: جاء في رواية أخرى: حين استشهد عبد الرحمن، أخذ الراية أخوه سلمان بن ربيعة الباهلي وقاتل بها، ونادى مناد: (صبرا آل سلمان)، فقال سلمان: أو ترى جزعا، وخرج سلمان ومعه أبو هريرة الدوسي على جيلان([40]) فقطعوها إلى جرجان([41]) منسحبا من معركة خاسرة([42]), بعد أن دفن أخاه عبد الرحمن بنواحي بلنجر([43])، وبهذا الانسحاب أنقذ سلمان بقية باقية من جيش أخيه([44]).
وقد رجح هذه الرواية محمود شيت خطاب وقال: إن الانسحاب أشبه بقتال المسلمين يومئذ، وذلك في حالة اشتداد الضغط عليهم من العدو وتكبدهم خسائر فادحة بالأرواح، والانسحاب هو من أجل الانحياز إلى فئة من المسلمين، ليعيدوا الكرة ثانية على عدوهم. وقد جاء سلمان بن ربيعة مددًا لعبد الرحمن بأمر عثمان بن عفان، فليس من المعقول أن يبقى ومدده في (الباب)، وليس من المعقول أن يتركه أخوه عبد الرحمن هناك وهو يخوض معركة قاسية شرسة، يكون فيها القائد بأمسِّ الحاجة إلى الجندي الواحد، فكيف يترك عبد الرحمن جيشا كاملا على رأسه أخوه دون أن يستفيد منه في المعركة؟
إن المؤرخين القدامى كانوا يستعملون تعبير (الهزيمة) وهم يريدون بها تعبير الانسحاب؛ ذلك لأن أكثرهم مدنيون لا يفرقون بين هذين التعبيرين, (الهزيمة) وهي ترك ساحة القتال بدون نظام ولا قيادة فهي كارثة، و(الانسحاب) وهو ترك ساحة القتال وفق خطة مرسومة بقيادة واحدة، فهو -أي الانسحاب- صفحة من صفحات القتال، الهدف منه إعادة الكرة على العدو بعد إكمال متطلبات المعركة عَدَدًا وعُدَدًا، وعسى ألا يقع المؤرخون المحدثون في مثل هذا الخطأ في التعبير، فلا يفرقون بين (الهزيمة) و(الانسحاب)؛ لأن الفرق بين التعبيرين شاسع بعيد([45]).
تاسعًا: أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام 32 هـ:
لما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيدُ بن العاص على ذلك الفرع سلمانَ بن ربيعة، وأمدهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة، فتنازع حبيب وسلمان على الإمرة، وقال أهل الشام: لقد هممنا بضرب سلمان، فقال في ذلك الناس: إذن والله نضرب حبيبًا ونحبسه، وإن أبيتم كثرت القتلى فيكم وفينا، حتى قال في ذلك رجل من أهل الكوفة وهو أوس بن مغراء:
إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم
|
|
وإن ترحلوا نحو ابن عفان نَرْحَل
|
وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا
|
|
وهذا أمير في الكتائب مُقْبل
|
ونحن ولاةُ الثغر كنا حُمَاته
|
|
ليالي نرمي كل ثغر وننكل([46])
|
وتغلب المسلمون على الفتنة بتوفيق الله ثم بوجود أمثال حذيفة بن اليمان، الذي كان على الغزو بأهل الكوفة، فقد غزا ذلك الثغر ثلاث غزوات، فقتل عثمان t في الثالثة.([47])
عاشرًا: فتوحات ابن عامر سنة 32 هـ:
وفيها فتح ابن عامر مرو الروذ، والطالقان والفارياب، والجوزجان، وطخارستان؛ فقد بعث ابن عامر الأحنف بن قيس إلى مرو روذ فحصر أهلها، فخرجوا إليهم فقاتلوهم، فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى حصنهم فأشرفوا عليه، قال: يا معشر العرب، ما كنتم عندنا كما نرى، ولو علمنا أنكم كما نرى لكانت لنا ولكم حال غير هذه، فأمهلونا ننظر يومنا، وارجعوا إلى عسكركم، فرجع الأحنف، فلما أصبح غاداهم وقد أعدوا له الحرب، فخرج رجل من العجم معه كتاب من المدينة، فقال: إني رسول فأمنوني، فأمنوه، فإذا رسول من مرزبان مرو ابن أخيه وترجمانه، وإذا كتاب المرزبان إلى الأحنف، فقرأ الكتاب، قال: فإذا هو إلى أمير الجيش، إنا نحمد الله الذي بيده الدول، يغير ما شاء من الملك، ويرفع من شاء بعد الذلة، ويضع من شاء بعد الرفعة، إنه دعاني إلى مصالحتك وموادعتك ما كان من إسلام جدي، وما كان رأي من صاحبكم من الكرامة والمنزلة، فمرحبا بكم وأبشروا، وأنا أدعوكم إلى الصلح فيما بينكم وبيننا، على أن أؤدي إليكم خراجا ستين ألف درهم، وأن تقروا بيدي ما كان ملك الملوك كسرى أقطع جد أبي حيث قتل الحية التي أكلت الناس، وقطعت السبيل من الأرضين والقرى بما فيها من الرجال، ولا تأخذوا من أحد من أهل بيتي شيئا من الخراج، ولا تخرج المرزبة([48]) من أهل بيتي إلى غيركم، فإن جعلت ذلك لي خرجت إليك، وقد بعثت إليك ابن أخي ماهك ليستوثق منك.
فكتب إليه الأحنف: بسم الله الرحمن الرحيم، من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مرو روذ ومن معه من الأساورة والأعاجم، سلام على من اتبع الهدى، وآمن واتقى، أما بعد: فإن ابن أخيك ماهك قدم عليَّ، فنصح لك جهده، وأبلغ عنك، وقد عرضت ذلك على من معي من المسلمين, وأنا وهم فيما عليك سواء، وقد أجبناك إلى ما سألت وعرضت على أن تؤدي على أكرَتِك([49]) وفلاحيك والأرضين التي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لما كان من قتله الحية التي أفسدت الأرض وقطعت السبيل، والأرض لله ولرسوله يورثها من يشاء من عباده، وإن عليك نصرة المسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة، إن أحب المسلمون ذلك وأرادوه، وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من وراءك من أهل ملتك, جار لك بذلك مني كتاب يكون لك بعدي، ولا خراج عليك ولا على أحد من أهل بيتك من ذوي الأرحام، وإن أنت أسلمت واتبعت الرسول كان لك من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وأنت أخوهم، ولك بذلك ذمتي وذمة أبي وذمم المسلمين وذمم آبائهم، شهد على ما في هذا الكتاب جزء بن معاوية، أو معاوية بن جزء السعدي، وحمزة بن الهرماس, وحميد بن الخيار المازنيان، وعياض بن ورقاء الأسيدي، وكتب كيسان مولى بني ثعلبة يوم الأحد من شهر المحرم، وختم أمير الجيش الأحنف بن قيس، ونقش خاتم الأحنف نعبد الله([50]).
حادي عشر: القتال بين جيش الأحنف وأهل طخارستان والجوزجان والطالقان والفارياب:
صالح ابن عامر أهل مرو، وبعث الأحنف في أربعة آلاف إلى طخارستان فأقبل حتى نزل موضع قصر الأحنف من مرو روذ، وجمع له أهل طخارستان، وأهل الجوزجان والطالقان والفارياب، فكانوا ثلاثة زحوف، ثلاثين ألفا، وأتى الأحنف خبرهم وما جمعوا له، فاستشار الناس فاختلفوا فبين قائل: نرجع إلى مرو، وقائل: نرجع إلى أبرشهر، وقائل: نقيم نستمد، وقائل: نلقاهم فنناجزهم، فلما أمسى الأحنف خرج يمشي في العسكر، ويستمع حديث الناس، فمر بأهل خباء ورجل يوقد تحت خزيرة([51]), أو يعجن، وهم يتحدثون ويذكرون العدو، فقال بعضهم: الرأي للأمير أن يسير إذا أصبح، حتى يلقى القوم حيث لقيهم، فإنه أرعب لهم فيناجزهم، فقال صاحب الخزيرة أو العجين: إن فعل ذلك فقد أخطأ وأخطأتم، أتأمرونه أن يلقى حد العدو مصحرا في بلادهم، فيلقى جمعا كثيرا بعدد قليل، فإن جالوا جولة اصطلمونا([52])، ولكن الرأي له أن ينزل بين المرغاب والجبل، فيجعل المرغاب عن يمينه والجبل عن يساره، فلا يلقاه من عدوه وإن كثروا إلا عدد أصحابه، فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال فضرب عسكره، وأقام فأرسل إليه أهل مرو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه، فقال: إني أكره أن أستنصر بالمشركين، فأقيموا على ما أعطيناكم وجعلنا بيننا وبينكم، فإن ظفرنا فنحن على ما جعلنا لكم وإن ظفروا بنا وقاتلوكم فقاتلوا عن أنفسكم، فوافق المسلمين صلاة العصر، فعاجلهم المشركون فناهضوهم، فقاتلوهم وصبر الفريقان حتى أمسوا والأحنف يتمثل بشعر ابن جُؤيَّة الأعرجي:
أحقُّ من لم يكره المنية
|
|
حزوَّرٌ([53]) ليس له ذرية([54])
|
وجاء في رواية: فقاتلهم حتى ذهب عامة الليل ثم هزمهم الله، فقتلهم المسلمون حتى انتهوا إلى رَسْكن -وهي على اثنى عشر فرسخا من قصر الأحنف-. وكان مرزبان مرو روذ قد تربص بحمل ما كانوا صالحوه عليه، لينظر ما يكون من أمرهم، فلما ظفر الأحنف سرح رجلين إلى المرزبان، وأمرهما ألا يكلماه حتى يقبضاه, ففعلا، فعلم أنهم لم يصنعوا ذلك به إلا وقد ظفروا، فحمل ما كان عليه([55]), وبعث الأحنف الأقرع بن حابس في جريدة خيل([56]) إلى الجوزجان حيث بقية كانت بقيت من الزحوف الذين هزمهم الأحنف، فقاتلهم فجال المسلمون جولة فقتل فرسان من فرسانهم، ثم أظفر الله المسلمين بهم فهزموهم وقتلوهم، فقال كُثير النهشلي:
سقى مزنُ السحاب إذا استهلت([57])
|
|
مصارع فتية بالجوزجان
|
إلى القصرين من رُسْتاق خُوط
|
|
أقادهم هناك الأقرعان([58])
|
ثاني عشر: صلح الأحنف مع أهل بلخ 32 هـ:
سار الأحنف من مرو الروذ إلى بلخ فحاصرهم، فصالحه أهلها على أربعمائة ألف، فرضي منهم بذلك، واستعمل ابن عمه، وهو أسيد بن المتشمس ليأخذ منهم ما صالحوه عليه، ومضى إلى خارزم فأقام حتى هجم عليه الشتاء، فقال لأصحابه: ما تشاءون؟ فقالوا: قد قال عمر بن معد يكرب:
إذا لم تستطع أمرًا فدعه
|
|
وجاوزه إلى ما تستطيع
|
فأمر الأحنف بالرحيل، ثم انصرف إلى بلخ، وقد قبض ابن عمه ما صالحهم عليه، وكان وافق -وهو يجيبهم- المهرجان، فأهدوا إليه هدايا من آنية الذهب والفضة ودنانير ودراهم ومتاع وثياب، فقال ابن عم الأحنف: هذا ما صالحناكم عليه؟ قالوا: لا، ولكن هذا شيء نصنعه في هذا اليوم بمن ولينا نستعطفه به، قال: وما هذا اليوم؟ قالوا: المهرجان، قال: ما أدري ما هذا؟ وإني لأكره أن أرده ولعله من حقي، ولكن أقبضه وأعزله حتى أنظر فيه، فقبضه، وقدم الأحنف فأخبره، فسألهم عنه، فقالوا له مثل ما قالوا لابن عمه، فقال: آتى به الأمير، فحمله إلى ابن عامر، فأخبره عنه، فقال: اقبضه يا أبا بحر، فهو لك؟ قال: لا حاجة لي فيه، فقال ابن عامر: ضمه إليك يا مسمار، فضمه القرشي وكان مضَمًّا.([59])
ثالث عشر: لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج محرما معتمرا من موقفي هذا:
ولما رجع الأحنف إلى ابن عامر قال الناس لابن عامر: ما فتح على أحد ما قد فتح عليك فارس وكرمان وسجستان وعامة خراسان، قال: لا جرم، لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج محرما معتمرا من موقفي هذا، فأحرم بعمرة من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على إحرامه من خراسان، وقال: ليتك تضبط ذلك من الوقت الذي يحرم منه الناس([60]).
رابع عشر: هزيمة قارِن في خراسان:
لما رجع ابن عامر من الغزو استخلف قيس بن الهيثم على خراسان، فأقبل قارن في جمع من الترك، أربعين ألفا، فالتقاه عبد الله بن خازم السلمي في أربعة آلاف، وجعل لهم مقدمة ستمائة رجل، وأمر كلا منهم أن يجعل على رأس رمحه نارا، وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم, فناوشتهم المقدمة، فاشتغلوا بهم وأقبل عبد الله بن خازم بمن معه من المسلمين فأحاطوا بهم، فولى المشركون مدبرين، واتبعهم المسلمون يقتلون من شاءوا وقتل قارن فيمن قتل، وغنموا سبيًا كثيرا، وأموالا جزيلة، ثم بعث عبد الله بن خازم بالفتح إلى ابن عامر، فرضي عنه وأقره على خراسان، وذلك أنه كان قد احتال على الوالي السابق قيس بن الهيثم السلمي حتى أخرجه من خراسان، ثم تولى حرب قارن، فلما هزمه وغنم عسكره، رضي عليه ابن عامر، وأقره على ولاية خراسان([61]).
وهكذا تصدى الخليفة الراشد عثمان لحركات التمرد في المشرق، وواصل فتوحاته، ولم تفتّ تلك الثورات في عضد المسلمين، ولم تنل من عزم الخليفة الذي كان كُفئًا لها؛ حيث واجهها بالعزم والرأي والسرعة في تصريف الأمور، وتسيير النجدات، وإسناد كل عمل إلى من يحسنه كما يظهر من تتبع الأحداث في تاريخ الطبري وابن كثير والكلاعي، بما لا يدع شكًا في أن اختيار عثمان للقادة الذين قاموا بهذه الانتصارات وتطويق هذه القلاقل كان اختيارا موفقا، مع العلم أن أعباء الجهاد كانت أشق وأكبر وأحوج إلى التوجيه؛ لامتداد خطوط القتال، وتعدد الفتن، وتباعد المسافات بين البلدان.
إن علاج تلك المعضلات التي فاجأت عثمان t بعد ولايته، وتصدى لها بالعزم والسداد والسرعة والحيطة والأناة لدليل على قوة شخصيته ونفاذ بصيرته، وكان له بعد ذلك أكبر الفضل -بعد الله- في تثبيت مهابة الدولة بعدما أصابها من الوهن والتخلخل عند مقتل عمر t، وكانت ثمرات تلك الوقفات الرائعة:
أ- إخضاع المتمردين وإعادة سلطة المسلمين عليهم.
ب- ازدياد الفتوحات الإسلامية إلى ما وراء البلاد المتمردة؛ منعا لارتداد الهاربين إليها، وانبعاث الفتن والدسائس من قِبَلها.
ج- اتخاذ المسلمين قواعد ثابتة يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد التي خضعت للمسلمين.
فهل كانت تلك الفتوحات العظيمة والسياسة الحكيمة والضبط للأقاليم يمكن أن تتحقق لو كان عثمان t ضعيفا غير قادر على اتخاذ القرار([62]), كما يزعم من وقع وتورط في روايات الرفض والتشيع والاستشراق، ومن سار على نهجهم السقيم؟!!.
خامس عشر: من قادة فتح بلاد المشرق في عهد عثمان: الأحنف بن قيس:
كانت الفتوحات في عهد عثمان t عظيمة، فرأيت من المناسب أن نسلط الأضواء على بعض قادة الفتوح في عهد عثمان، وبما أنني تحدثت عن فتوح المشرق، فلا بد إذن من إعطاء صورة مشرقة عن أحد قادة تلك الفتوح، فاخترت الأحنف بن قيس.
1- نسبه وأهله:
هو أبو بحر، الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة التميمي([63])، واسمه الضحاك وقيل: صخر.([64]) وأمه حبَّة بنت عمرو بن قُرْط الباهلية([65]), كان أخوها الأخطل بن قرط من الشجعان، وقد قال الأحنف مفاخرا بخاله هذا: ومن له خال مثل خالي؟([66])
2- حياته:
كان من سادات التابعين وأكابرهم، وسيدا مطاعا في قومه([67])، وسيد أهل البصرة([68])، وكان موضع ثقة الناس جميعا بمختلف طبقاتهم وأهوائهم وميولهم، وكان أحد الحكماء الدهاة العقلاء([69])، ذا دين وذكاء وفصاحة([70])، وكان سيد قومه موصوفا بالعقل والدهاء والعلم والحلم، يضرب بحلمه المثل، وقد قال فيه الشاعر:
إذا الأبصار أبصرت ابن قيس
|
|
ظللن مهابة منه خشوعا([71])
|
وقال عنه خالد بن صفوان: كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه.([72]) وإليك بعض صفاته التي أثرت فيمن حوله:
أ- حلمه:
كان الأحنف حليما يضرب بحلمه المثل، سئل عن الحلم: ما هو؟ فقال: الذل مع الصبر. وكان يقول إذا عجب الناس من حلمه: إني لأجد ما تجدون، ولكني صبور، ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري([73])؛ لأنه قتل ابن أخ له بعض بنيه، فأتى القاتل مكتوفا يقاد إليه، فقال: ذعرتم الفتى، ثم أقبل على الفتى فقال: بئس ما فعلت، نقصت عددك وأوهنت عضدك، وأشمت عدوك، وأسأت لقومك، خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة، ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير وجهه.([74]) وقال رجل للأحنف: علمني الحلم يا أبا بحر، فقال: هو الذل يا ابن أخي، أفتصبر عليه؟ وقال: لست حليما ولكنني أتحالم.([75]) ومن أخبار حلمه، أن رجلا شتمه فسكت عنه، وأعاد الرجل فسكت عنه، وأعاد فسكت عنه، فقال الرجل: والهفاه، ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده.([76]) وكان يقول: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه.([77]) ولكن حلمه كان حلم القوي القدير لا حلم العاجز الضعيف، فقد قاتل في بعض المواطن قتالا شديدا، فقال له رجل: يا أبا بحر أين الحلم؟ فقال: عند الحي([78]).
ب- عقله:
كان الأحنف عاقلا راجح العقل، قال مرة: من كان فيه أربع خصال ساد قومه غير مدافع: من كان له دين يحجزه، وحسب يصونه، وعقل يرشده، وحياء يمنعه([79]).
وقال: العقل خير قرين، والأدب خير ميراث، والتوفيق خير رفيق.([80]) وقال: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي. وكان يقول إذا ذكر عنده رجل: دعوه يأكل رزقه ويأتي عليه أجله.([81]) وشكا ابن أخيه وجع الضرس فقال: ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة ما ذكرتها لأحد.([82]) وقال: ما نازعني أحد فوقي إلا عرفت له قدره، ولا كان دوني إلا رفعت قدري عنه، ولا كان مثلي إلا تفضلت عليه([83]).
ج- علمه:
كان عالما ثقة مأمونا، قليل الحديث، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري.([84]) وروى عنه الحسن البصري وعروة بن الزبير وغيرهما.([85]) وقد كان من الفقهاء البارزين أيام معاوية.
د- حكمته:
كان حكيما ينطق بالحكمة والموعظة الحسنة، سئل عن المروءة، فقال: التقى والاحتمال، ثم أطرق ساعة وقال:
وإذا جميل الوجه لم
|
|
يأتِ الجميل فما حماله؟
|
ما خير أخلاق الفتى
|
|
إلا تقاه واحتماله
|
وسئل عن المروءة فقال: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وبر الوالدين، والحلم عند الغضب، والعفو عند المقدرة([86]).
وقال: رأس الأدب آلة المنطق، ولا خير في قول إلا بفعل، ولا منظر إلا بمخبر، ولا في مال إلا بجود، ولا في صديق إلا بوفاء، ولا في فقه إلا بورع، ولا في صدقة إلا بنية.([87])
وقال: أحي المعروف بإماتة ذكره.([88]) وقال: كثرة الضحك تذهب الهيبة، وكثرة المزاح تذهب المروءة، ومن لزم شيئا عرف به.([89]) وقال: جنبوا مجلسنا الطعام والنساء؛ فإني لأبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه، وإن المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه([90]).
وقال: السؤدد مع السواد. يريد: من لم يطر له اسم على ألسنة العامة بالسؤدد لم ينفعه ما طار له في الخاصة([91]).
هـ- بلاغته:
كان فصيحا مفوَّها([92])، خطب مرة فقال: بعد حمد الله والثناء عليه: يا معشر الأزد وربيعة: أنتم إخواننا في الدين، وشركاؤنا في الصهر، وأشقاؤنا في النسب، وجيراننا في الدار، ويدنا على العدو، والله لأزد البصرة أحب إلينا من تميم الكوفة، ولأزد الكوفة أحب إلينا من تميم الشام، فإن استشرف شنان حسد صدوركم، ففي أحلامنا وأموالنا سعة لنا ولكم([93]).
لقد كان حاضر البديهة قوي الحجة منطقيا، جاء الأحنف إلى قوم يتكلمون في دم فقال: احكموا، فقالوا: نحكم بديتين، فقال: ذلك لكم، فلما سكتوا قال: أنا أعطيكم ما سألتم, غير أني قائل لكم شيئا: إن الله -عز وجل- قضى بدية واحدة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية واحدة، وأنتم اليوم طالبون، وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبين، فلا يرضى الناس منكم إلا بمثل ما سننتم لأنفسكم، فقالوا: نردها دية واحدة([94]).
وسمع الأحنف رجلا يقول: ما أبالي أمدحت أم ذممت، فقال له: لقد استرحت من حيث تعب الكرام([95]).
و- إيثاره:
كان الأحنف يحب لغيره ما يحبه لنفسه، بل كان يؤثر غيره على نفسه بالخير والمعروف, ويرضى نفسه الرضية المطمئنة إلى ما أصاب غيره بجهده من خير، فعندما جاء الأحنف إلى عمر في المدينة، عرض أمير المؤمنين عليه جائزة، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما قطعنا الفلوات ودأبنا الروحات والعشيات للجوائز، وما حاجتي إلا حاجة من خلفي، فزاده ذلك عند عمر خيرا([96]).
ز- أمانته:
كان الأحنف أمينا غاية الأمانة، وقد مر بنا عندما استعمل ابن عمه على أهل بلخ، وقد قبض ابن عمه ما صالحوه عليه من آنية الذهب والفضة ودنانير ودراهم ومتاع وثياب، فقال ابن عمه لهم: هذا ما صالحناكم عليه؟ فقالوا: لا، ولكن هذا شيء نضعه في هذا اليوم بمن ولينا نستعطف به، قال: وما هذا اليوم؟ فقالوا:
المهرجان.([97]) فقال: ما أدري ما هذا، وإني لأكره أن أرده ولعله من حقي، ولكن أقبضه وأعزله حتى أنظر، فقبضه, وقدم الأحنف فأخبره، فسألهم عنه، فقالوا مثل ما قالوا لابن عمه، فقال: آتي به الأمير، فحمله إلى عبد الله ابن عامر فأخبره عنه، فقال: اقبضه يا أبا بحر فهو لك، فقال الأحنف: لا حاجة لي فيه.([98]) لقد كان يتحرج حتى من الهدايا، وكان يكتفي بسهمه من الغنائم.([99])
ح- أَنَاته:
كان الأحنف شديد الأناة، لا يقدم على عمل إلا بعد أن يحسب له ألف حساب. قيل له: يا أبا بحر, إن فيك أناة شديدة، فقال: قد عرفت من نفسي عجلة في أمور ثلاثة: في صلاتي إذا حضرت حتى أصليها، وجنازتي إذا حضرت حتى أغيبها في حفرتها، وابنتي إذا خطبها كفيئها حتى أزوجه([100]).
ط- ورعه:
كان الأحنف مؤمنا ورعا قوي الإيمان، فقد سارع إلى اعتناق الإسلام أول ما بلغته الدعوة الإسلامية، وأسلم قومه بإشارته([101]), وبسط حمايته القوية الأمينة على الدعاة الأولين([102])، وثبت على عقيدته عندما ارتد أكثر قومه وأكثر العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد للدفاع عنها ونشرها حق الجهاد، وأبلى في ذلك أعظم البلاء. قال الحسن البصري عنه: ما رأيت شريف قوم أفضل منه.([103]) قال الأحنف: حبسني عمر بن الخطاب عنده بالمدينة سنة، يأتيني كل يوم وليلة فلا يأتيه عني إلا ما يحب.([104]) فكتب عمر بعد نجاح الأحنف في الاختبار العمري -وما أصعبه وأدقه من اختبار- معه كتبًا إلى الأمير على البصرة يقول: الأحنف سيد أهل البصرة.([105]) وكتب إلى موسى الأشعري أن يشاور الأحنف ويسمع منه،([106]) وقال له عمر بعد أن حبسه حولا عنده: يا أحنف، قد بلوتك وخبرتك، فلم أر إلا خيرا، ورأيت علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك([107]).
لقد كان الأحنف رجلا صالحا كثير الصلاة بالليل، وكان يسرج المصباح ويصلي ويبكي حتى الصباح، وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول لنفسه: إذا لم تصبر على المصباح، فكيف تصبر على النار الكبرى.([108]) وقيل له: إنك تكثر الصوم وإن ذلك يرق المعدة، فقال: إني أعده لسفر طويل.([109]) واستعمل الأحنف على (خراسان) فلما أتى فارس أصابته جنابة في ليلة باردة، فلم يوقظ أحدا من غلمانه ولا جنده، وانطلق يطلب الماء، فأتى على شوط وشجر حتى سالت قدماه دمًا، فوجد الثلج فكسره واغتسل.([110]) وكان قلما خلا إلا دعا بالمصحف، وكان النظر في المصاحف خلقا في الأولين.([111]) وكان في دعائه: اللهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك، وإن تعذبني فأنا أهل ذاك.([112]) ومن دعائه: اللهم هب لي يقينا تهون به علىَّ مصيبات الدنيا.([113]) ومرت به جنازة فقال: رحم الله من أجهد نفسه لمثل هذا اليوم.([114]) وكان يقول: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر([115]).
هذه بعض صفات شخصية الأحنف، استحوذ بها على ثقة الناس به وحبهم وتقديرهم له، وهذه الصفات تجعل من يتحلى بها شخصية قوية نافذة يندر وجودها بين الناس في كل زمان ومكان، وقلما يجود بها الدهر إلا نادرا.([116])
لقد كان الأحنف من قادة الفتوحات في عهد عثمان t، وقد تميز في قيادته لجيوش الفتح لبلاد المشرق بقدرته على إعداد الخطط الصحيحة الناجحة، وإعطاء القرارات السريعة الصائبة، كما كان لشجاعته الشخصية وإقدامه أثر كبير في وضع تلك الخطط والقرارات في حيز التنفيذ، لقد كان يبذل قصارى جهده في إعداد خططه العسكرية وإعطاء ذوي الرأي، بل يتجول سرًّا في الليل بين عامة رجاله يتسمع أحاديثهم، فإذا وجد رأيا سديدا يبدونه فيما بينهم سارع إلى العمل به، لا يهمه أن يأخذ الحكمة من أي وعاء، وقد كان هذا القائد الميداني في عهد عثمان يقاتل عدوه بسيفه وعقله معًا؛ فقد كان على جانب عظيم من الشجاعة والإقدام، حتى إنه كان يستأثر بالخطر دون رجاله، ويؤثرهم بالراحة والأمن، كما كان على جانب عظيم من الدهاء، فيوفر بدهائه على قواته كثيرًا من الجهود والمشقات.([117])
لقد كان الأحنف رجلا في أمة, وأمة في رجل، إنه سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه، كما كان يقول عنه عمر بن الخطاب t([118]).
لقد أطنبت في الحديث عن الأحنف لأنه من ضمن قادة الفتوح في عهد عثمان، وممن أسهم في صناعة الحياة في عصر الخليفة الراشد الثالث الذي وجهت إليه سهامهم الكاذبة في ولاته وقادة حربه.
([1]) تاريخ الطبري (5/246).
([2]) الخلافة والخلفاء الراشدون، ص224.
([3]) أجلبت: تجمعت للحرب.
([4]،3 ) تاريخ الطبري (5/247).
([6]) عثمان بن عفان، صادق عرجون، ص201.
([7]) تاريخ الطبري (5/270).
([8]) المصدر نفسه (5/271).
([9]) المصدر نفسه (5/288).
([10]) الأرحاء: جمع رحا: الطاحون. (2) المرغاب: نهر بمرو.
([12]) تاريخ الطبري (5/295). (4) نذر: علم.
([14]) كالا: متعبا. (6) لغبا: متعبا أشد التعب.
([16]) طرفاء: شجر.
([17]) خلافة عثمان، للسلمي، ص57.
([18]) تاريخ الطبري (5/297). (2) الاكتفاء، للكلاعي (4/417).
([20]) المصدر نفسه (4/418), تاريخ الطبري (5/302).
([21]) خلافة عثمان، د. السلمي، ص57.
([22]) الاكتفاء للكلاعي (4/419).
([23]) مسلم في الفتن، رقم (2918، 2919).
([24]) الناووس: حجر منقور تجعل فيه جثة الميت.
([25]) تاريخ الطبري (5/304).
([26]) المصدر نفسه (5/305).
([27]) المصدر نفسه (5/306).
([28]) تاريخ الطبري (5/307).
([29]) المصدر نفسه (5/307).
([30]) العرادة: آلة حربية كالمنجنيق، ترمي بالحجارة المرمى البعيد لدك الحصون.
([31]) تاريخ الطبري (5/308).
([32]) المصدر نفسه (5/309).
([33]) لم تئم امرأة: لم تفقد زوجها.
([34]) تاريخ الطبري (5/310). الذي رأى: أي في نومه.
([35]) المصدر نفسه (5/311).
([36]، 4) المصدر نفسه (5/310).
([38]) الغياض: جمع غيضة، وهي المواضع التي يكثر فيه الشجر ويلتف.
([39]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، محمود خطاب، ص151.
([40]) جيلان: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان.
([41]) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان.
([42]) تاريخ الطبري (5/309), قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص151.
([43]) معجم البلدان (2/278).
([44]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص151.
([45]) المصدر نفسه، ص152، 153.
([46]) تاريخ الطبري (5/311)، البداية والنهاية (7/166).
([47]) تاريخ الطبري (5/311).
([48]) المرزبة: الرئاسة عند العجم، والمرزبان: الرئيس المقدم فيهم.
([49]) الأكرة: جمع أكار: الحراث.
([50]) تاريخ الطبري (5/316).
([51]) الخزيرة: الحساء من الدسم والدقيق.
([52]) اصطلم: اقتلعه من أصله.
([53]) الحزوَّر: الغلام القوي.
([54], 3) تاريخ الطبري (5/317).
([55]) تاريخ الطبري (5/317).
([56]) جريدة الخيل: كتيبة الخيل التي لا رجالة فيها.
([57]) استهلت السحابة: أمطرت واشتد مطرها.
([58]) تاريخ الطبري (5/318).
([59]) تاريخ الطبري (5/319).
([60]) البداية والنهاية (7/167)، تاريخ الطبري (5/319).
([61]) البداية والنهاية (7/167).
([62]) تحقيق مواقف الصحابة (1/408، 409).
([63]) جمهرة أنساب العرب، ص217, طبقات ابن سعد (7/95).
([64]، 3) قادة فتح السند وأفغانستان، محمود خطاب، ص285.
([66]) جمهرة أنساب العرب، ص212.
([67]) قادة فتح السند وأفغانستان، ص285.
([68]) الإصابة (1/103)، أسد الغابة (1/55).
([69]، 8، 9) قادة فتح السند وأفغانستان، ص304.
([72]) تهذيب ابن عساكر (7/13).
([73]) الاستيعاب (3/1294).
([74]) وفيات الأعيان (2/188).
([75]، 3، 4) قادة فتح السند وأفغانستان، ص306.
([78]) المصدر نفسه، ص306، يعني بها: تركته في الدار.
([79]) المصدر نفسه، ص306. (7) تهذيب ابن عساكر (7/19).
([81]) المصدر نفسه (7/21). (9) المصدر نفسه (7/16).
([83]) قادة فتح السند وأفغانستان، ص307.
([84]) طبقات ابن سعد (7/93).
([85]) قادة فتح السند وأفغانستان، ص308.
([86]) قادة فتح السند وأفغانستان، ص308.
([87]) تهذيب ابن عساكر (7/19، 20).
([88]) البداية والنهاية (7/331).
([89]) وفيات الأعيان، لابن خلكان (2/187).
([90]) وفيات الأعيان (2/188).
([91]، 7، 8) قادة فتح السند وأفغانستان، ص309.
([94]،2) وفيات الأعيان (2/188). (3) تهذيب ابن عساكر (7/12).
([97]) المهرجان: أحد أعياد الفرس. (5) تاريخ الطبري (5/319).
([99]) قادة فتح السند وأفغانستان، محمود خطاب، ص313.
([100]) طبقات ابن سعد (7/96).
([101]) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي (1/78).
([102]) قادة فتح السند وأفغانستان، ص314. (4) البداية والنهاية (7/331).
([104]،6) قادة فتح السند وأفغانستان، ص314. (7) تهذيب ابن عساكر (7/12).
([107]) طبقات ابن سعد (7/94). (9) البداية والنهاية (7/331).
([109]) طبقات ابن سعد (7/94)، قادة فتح السند وأفغانستان، ص315.
([110]) طبقات ابن سعد (7/94).
([111]) طبقات ابن سعد، (7/95).
([112]) قادة فتح السند وأفغانستان، ص315، ترجمة الأحنف لخصتها من هذا الكتاب القيم مع الرجوع لبعض المصادر.
([113]، 4) تهذيب ابن عساكر (7/16). (5) البداية والنهاية (7/331).
([116]) قادة فتح السند وأفغانستان، ص316. (7) المصدر نفسه، ص320.
([118]) المصدر نفسه، ص322.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 3130
تاريخ التسجيل : 31 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 2,291
- شكراً و أعجبني للمشاركة

- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 12
معدل تقييم المستوى
: 16

المبحث الثاني الفتوحات في الشــــــــــام
أولاً: فتوحات حبيب بن مسلمة الفهري:
مر بنا أن الروم أجلبت على المسلمين بالشام بجموع عظيمة أول خلافة عثمان، فكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة بالكوفة أن يمد إخوانه بالشام, فأمدهم بثمانية آلاف عليهم سلمان ابن ربيعة الباهلي، فظفر المسلمون بعدوهم بعد أن غزوهم في أرض الروم فأسروا منهم وغنموا. وكان تحالف الروم والترك قد تجمع لملاقاة المسلمين الذين غزوا أرمينية من الشام، وكان على المسلمين حبيب بن مسلمة وكان صاحب كيد لعدوه، فأجمع أن يبيِّت قائدهم الموريان، أي يباغته ليلا، فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية يذكر ذلك، فقالت: فأين موعدك؟ قال: سرادق الموريان أو الجنة.. ثم بيتهم فغلبهم, وأتى سرادق الموريان فوجد امرأته قد سبقته إليه.([1]) وواصل حبيب جهاده وانتصاراته المتوالية في أراضي أرمينية وأذربيجان، ففتحها إما صلحا أو عنوة([2]).
لقد كان حبيب بن مسلمة الفهري من أبرز القادة الذين حاربوا في أرمينية البيزنطية؛ فقد أباد جيوشا بأكملها للعدو, وفتح حصونا ومدنا كثيرة.([3]) كما غزا ما يلى ثغور الجزيرة العراقية من أرض الروم فافتتح عدة حصون هناك، مثل شمشاط وملطية وغيرهما، وفي سنة 25 هـ غزا معاوية الروم فبلغ عمورية فوجد الحصون التي بين أنطاكية وطرسوس خالية، فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة، وواصل قائده قيس بن الحر العبسي الغزو في الصيف التالي، ولما فرغ هدم بعض الحصون القريبة من أنطاكية كي لا يفيد منها الروم([4]).
ثانيًا: أول من أجاز الغزو البحري عثمان بن عفان:
كان معاوية بن أبي سفيان وهو أمير الشام يلح على عمر بن الخطاب في غزو البحر، ويصف له قرب الروم من حمص ويقول: إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم، حتى كان ذلك يأخذ بقلب عمر، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف لي البحر وراكبه، فإن نفسي تنازعني إليه، فكتب إليه عمرو: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، إن ركن خرق القلب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة، والشك كثرة، هم كدود على عود، إن مال غرق، وإن نجا برق، فلما قرأ عمر بن الخطاب كتاب عمرو بن العاص كتب إلى معاوية: لا والذي بعث محمدا بالحق، لا أحمل فيه مسلما أبدا، وتالله لمسلم أحب إليَّ مما حوت الروم، فإياك أن تعرض لي، وقد تقدمت إليك، وقد علمت ما لقى العلاء مني، ولم أتقدم إليه في ذلك.([5]) ولكن الفكرة لم تبرح نفس معاوية، وقد رأى في الروم ما رأى، فطمع في بلادهم وفي فتحها، فلما تولى الخلافة عثمان عاود معاوية الحديث وألح به على عثمان، فرد عليه عثمان قائلا: (إني قد شهدت ما رد عليك عمر -رحمه الله- حين استأذنته في غزو البحر)، ثم كتب إليه معاوية مرة أخرى يهون عليه ركوب البحر إلى قبرص فكتب إليه: (فإن ركبت معك امرأتك فاركبه مأذونا وإلا فلا). ([6]) كما اشترط عليه الخليفة عثمان t أيضا بقوله: (لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه). ([7]) فلما قرأ معاوية كتاب عثمان نشط لركوب البحر إلى قبرص، فكتب لأهل السواحل يأمرهم بإصلاح المراكب وتقريبها إلى ساحل حصن عكا، فقد رمه ليكون ركوب المسلمين منه إلى قبرص([8]).
ثالثـًا: غزوة قبرص:
أعد معاوية المراكب اللازمة لحمل الجيش الغازي، واتخذ ميناء عكا مكانا للإقلاع، وكانت المراكب كثيرة وحمل معه زوجه فاختة بنت قرظة، كذلك حمل عبادة بن الصامت امرأته أم حرام بنت ملحان معه في تلك الغزوة([9]).
وأم حرام هذه هي صاحبة القصة المشهورة، عن أنس بن مالك t أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي من رأسه, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي في سبيل الله» كما قال في الأولى، قالت: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت من الأولين» فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت([10]).
ورغم أن معاوية t لم يجبر الناس على الخروج، فقد خرج معه جيش عظيم من المسلمين([11])، مما يدل على أن المسلمين قد هانت في أعينهم الدنيا بما فيها، فأصبحوا لا يعبأون بها بالرغم من أنها قد فتحت عليهم أبوابها، فصاروا يرفلون في نعيمها.
إن المسلمين قد تربوا على أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الله اصطفاهم لنصرة دينه وإقامة العدل ونشر الفضيلة، والعمل على إظهار دين الله على كل ما عداه، وهم يعتقدون أن هذه المهمة هي رسالتهم الحقيقية، وأن الجهاد في سبيل الله هو سبيل الحصول على مرضاة الله، فإن هم قصروا في مهمتهم وقعدوا عن أداء واجبهم فيمسك الله عنهم نصره في الدنيا، ويحرمهم مرضاته في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. من أجل هذا هرعوا مع معاوية وتسابقوا إلى السفن يركبونها، ولعل حديث أم حرام قد ألم بخواطرهم فدفعهم إلى الخروج للغزو في سبيل الله تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد انتهاء فصل الشتاء في سنة ثمان وعشرين من الهجرة (649م) ([12]).
وسار المسلمون من الشام وركبوا من ميناء عكا متوجهين إلى قبرص، ونزل المسلمون إلى الساحل، تقدمت أم حرام لتركب دابتها، فنفرت الدابة وألقت أم حرام على الأرض فاندقت عنقها فماتت.([13]) وترك المسلمون أم حرام بعد دفنها في أرض الجزيرة عنوانا على مدى التضحيات التي قدمها المسلمون في سبيل نشر دينهم، وعرف قبرها هناك بقبر المرأة الصالحة([14]).
واجتمع معاوية بأصحابه وكان فيهم: أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وأبو الدرداء، وأبو ذر الغفاري، وعبادة بن الصامت، وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن بشر المازني، وشداد ابن أوس بن ثابت، والمقداد بن الأسود، وكعب الحبر بن ماتع، وجبير بن نفير الحضرمي([15])، وتشاوروا فيما بينهم وأرسلوا إلى أهل قبرص يخبرونهم أنهم لم يغزوهم للاستيلاء على جزيرتهم([16])، ولكن أرادوا دعوتهم لدين الله ثم تأمين حدود الدولة الإسلامية بالشام؛ وذلك لأن البيزنطيين كانوا يتخذون من قبرص محطة يستريحون فيها إذا غزوا ويتموَّنون منها إذا قل زادهم، وهي بهذه المثابة تهدد بلاد الشام الواقعة تحت رحمتها، فإذا لم يطمئن المسلمون على مسالمة هذه الجزيرة لهم وخضوعها لإرادتهم فإن وجودها كذلك سيظل شوكة في ظهورهم وسهما مسددا في حدودهم، ولكن سكان الجزيرة لم يستسلموا للغزاة ولم يفتحوا لهم بلادهم، بل تحصنوا في العاصمة ولم يخرجوا لمواجهة المسلمين، وكان أهل الجزيرة ينتظرون تقدم الروم للدفاع عنهم، وصد هجوم المسلمين عليها([17]).
رابعًا: الاستسلام وطلب الصلح:
تقدم المسلمون إلى عاصمة قبرص (قسطنطينا) وحاصروها، وما هي إلا ساعات حتى طلب الناس الصلح، وأجابهم المسلمون إلى الصلح، وقدموا للمسلمين شروطًا واشترط عليهم المسلمون شروطا، وأما شرط أهل قبرص فكان في طلبهم ألا يشترط عليهم المسلمون شروطا تورطهم مع الروم؛ لأنهم لا قبل لهم بهم، ولا قدرة لهم على قتالهم، وأما شروط المسلمين:
1- ألا يدافع المسلمون عن الجزيرة إذا هاجم سكانها محاربون.
2- أن يدل سكان الجزيرة المسلمين على تحركات عدوهم من الروم.
3- أن يدفع سكان الجزيرة للمسلمين سبعة آلاف ومائتي دينار في كل عام.
4- ألا يساعدوا الروم إذا حاولوا غزو بلاد المسلمين، ولا يطلعوهم على أسرارهم([18]).
وعاد المسلمون إلى بلاد الشام، وأثبتت هذه الحملة قدرة المسلمين على خوض غمار المعارك البحرية بجدارة، وأعطت المسلمون فرصة المران على الدخول في معارك من هذا النوع مع العدو المتربص بهم سواء بالهجوم على بلاد الشام أم على الإسكندرية([19]).
خامسًا: عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامي في الشام:
استعمل معاوية بن أبي سفيان على البحر عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني فزارة، فغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر، ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب، وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده، وألا يبتليه بمصاب أحد منهم، ففعل، حتى إذا أراد أن يصيبه وحده خرج في قاربه طليعة، فانتهى إلى المرفأ من أرض الروم، وعليه سؤَّال يعترُّون([20]) بذلك المكان، فتصدق عليهم، فرجعت امرأة من السؤَّال إلى قريتها، فقالت للرجال: هل لكم في عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرفأ، قالوا: أي عدوة الله، ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس؟ فوبختهم وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى عبد الله على أحد، فثاروا إليه، فهجموا عليه، فقاتلوه وقاتلهم، فأصيب وحده، وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه فجاءوا حتى أرقوا، والخليفة منهم سفيان بن عوف الأزدي، فخرج فقاتلهم، فضجر وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم، فقالت جارية عبد الله: واعبد الله، ما هكذا كان يقول حين يقاتل، فقال سفيان: وكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا، فترك ما كان يقول ولزم: الغمرات ثم ينجلينا، وأصيب في المسلمين يومئذ وذلك آخر زمان عبد الله بن قيس الجاسي([21])، وقيل لتلك المرأة التي استثارت الروم على عبد الله بن قيس: كيف عرفته؟ قالت: كان كالتاجر، فلما سألته أعطاني كالملك، فعرفت أنه عبد الله بن قيس([22]).
وهكذا حينما أراد الله تعالى أن يمن بالشهادة على هذا القائد العظيم أتيحت له وهو في وضع لا يضر بسمعة المسلمين البحرية؛ حيث كان وحده يتطلع ويراقب الأعداء، فكانت تلك الكائنة الغريبة التي أبصرت غورها تلك المرأة الذكية من نساء تلك البلاد؛ حيث رأت ذلك الرجل يظهر في مظاهره الخارجية بمظهر التجار العاديين، ولكنه يعطي عطاء الملوك، فلقد رأت فيه أمارات السيادة مع بساطة مظهره، فعرفت أنه قائد المسلمين الذي دوخ المحاربين في تلك البلاد، وهكذا كانت سماحة ذلك القائد وسخاؤه البارز حتى مع غير المسلمين سببا في كشف أمره، ومعرفة مركزه، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فيتم بذلك الهجوم عليه وظفره بالشهادة.
وهكذا يضرب قادة المسلمين المثل العليا بأنفسهم لتتم الإنجازات الكبرى على أيديهم، وليكونوا قدوة صالحة لمن يخلفهم؛ فقد قام هذا القائد الملهم بمهمة الاستطلاع بنفسه ولم يكل الأمر إلى جنوده، وفي انفراده بهذه المهمة مظنة للتورط مع الأعداء والهلاك على أيديهم، ولكنه مع ذلك يغامر بنفسه فيتولى هذه المهمة، ثم نجده يتخلق بأخلاق الإسلام العليا حتى مع نساء الأعداء وضعفتهم، فيمد إليهم يد الحنان والعطف، ويسخو لهم بالمال الذي هو من أعز ما يملك الناس، ونجده قبل ذلك مع جنده رفيقا صبورا، لا معنفا ولا مستكبرا، وإذا ادلهمت الخطوب تفاءل بانكشاف الغمة ولم يلجأ إلى لوم أصحابه وتعنيفهم، ولم يهيمن عليه الارتباك الذي يفسد العمل، ويعجل بالخلل والفوضى، وأما خليفته سفيان الأزدي فلعله وقع فيما وقع فيه من الارتباك والاشتغال بطرح اللائمة على جنده لكونه حديث العهد بأمور القيادة، ولكن مما يحفظ له أنه لما نبهته جارية عبد الله بن قيس إلى ذلك الأسلوب الحكيم الذي كان أميره ينتهجه في القيادة سارع في التأسي به في ذلك، ولم يحمله التكبر على عدم سماع كلمة الحق وإن صدرت من جارية مغمورة. وهذا مثل من أمثلة التجرد من هوى النفس، هذا الخلق العظيم الذي كان غالبا في الجيل الأول، وبه تم إنجاز الفتوحات العظيمة ونجاح الولاة والقادة في إدارة الأمة، فلله در أبناء ذلك الجيل: ما أبلغ ذكرهم، وما أبعد غورهم، وما أعظم وطأتهم في الأرض على الجبارين، وما أعذب لمساتهم في الأرض على المستضعفين والمساكين.([23])
سادسًا: القبارصة ينقضون الصلح:
في سنة اثنتين وثلاثين هجرية، وقع سكان قبرص تحت ضغط رومي عنيف أجبرهم على إمداد جيش الروم بالسفن ليغزوا بها بلاد المسلمين، وبذلك يكون القبرصيون قد أخلوا بشروط الصلح، وعلم معاوية بخيانة أهل قبرص فعزم على الاستيلاء على الجزيرة ووضعها تحت سلطان المسلمين، فقد هاجم المسلمون الجزيرة هجوما عنيفا فقتلوا وأسروا وسلبوا؛ هجم عليها جيش معاوية من جهة وعبد الله بن سعد من الجانب الآخر، فقتلوا خلقا كثيرا، وسبوا سبيا كثيرا وغنموا مالا جزيلا.([24]) وتحت ضغط القوات الإسلامية اضطر حاكم قبرص أن يستسلم للفاتحين ويلتمس منهم الصلح، فأقرهم معاوية على صلحهم الأول.([25]) وخشى معاوية أن يتركهم هذه المرة بغير جيش يرابط في الجزيرة فيحميها من غارات الأعداء ويضبط الأمن فيها حتى لا تتمرد على المسلمين، فبعث إليهم اثني عشر ألفا من الجنود، ونقل إليهم جماعة من بعلبك, وبنى هناك مدينة، وأقام فيها مسجدا، وأجرى معاوية على الجنود أرزاقهم. وظل الحال على ذلك، الجزيرة هادئة والمسلمون آمنون من هجمات الروم المفاجئة، ولاحظ المسلمون أن أهل قبرص ليس فيهم قدرات عسكرية، وهم مستضعفون أمام من يغزوهم، وأحس المسلمون أن الروم يغلبونهم على أمرهم ويسخرونهم لمصالحهم فرأوا أن من حقهم عليهم أن يحموهم من ظلم الروم، وأن يمنعوهم من تسلط البيزنطيين، وقال إسماعيل بن عياش: أهل قبرص أذلاء مقهورون يغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم، فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحميهم([26]).
سابعًا: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه:
وقد جاء في سياق هذه الغزوة المذكورة خبر أبي الدرداء t حينما نظر إلى سبي الأعداء فبكى، ثم قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. فانظر إلى هؤلاء القوم بينما هم ظاهرون قاهرون لمن ناوأهم، فلما تركوا أمر الله -عز وجل- وعصوه صاروا إلى ما ترى.([27]) وجاء في رواية: فقال له جبير بن نفير: أتبكي وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك، فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى، سلط الله عليهم السبي، وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة، وقال: ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره!!.([28])
إن ما تفوه به أبو الدرداء يعتبر مثلا للبصيرة النافذة والفقه في أمر الله تعالى، فهذا الصحابي الجليل يبكي حسرة على هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم، فلم ينقادوا لدعوة الحق فباءوا بهذا المصير المؤلم؛ حيث تحولوا من الملك والعزة إلى الاستسلام والذلة لإصرارهم على لزوم الباطل والتكبر على الخضوع لدعوة الحق، ولو أنهم عقلوا وتدبروا لكان في دخولهم في الإسلام بقاء ملكهم وعمران ديارهم والظفر بحماية دولة الإسلام، وإن هذا التفكير العميق من أبي الدرداء مظهر من مظاهر الرحمة والعطف تفتحت عنه نفسه الزكية، فتشكل ذلك في الظاهر على هيئة دموع تنحدر من عيني هذا الرجل العظيم، ليعبر عما يجول في نفسه من نظرات الحنان والرحمة والأسى على مصير تلك الأمة التي اجتمع لها البقاء على الضلال والمآل السيئ بزوال الملك والوقوع في الذل والهوان، وإنه بقدر ما يفرح المسلم بدخول الناس في الإسلام فإنه يحزن من رؤية الكافرين وهم يعيشون في ضلال مع إدراكه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبد في الآخرة، فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم في الأسر والتشرد وتعرضهم للقتل في الحياة الدنيا؟([29])
ثامنًا: عبادة بن الصامت يقسم غنائم قبرص:
قال عبادة بن الصامت لمعاوية -رضي الله عنهما-: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين والناس يكلمونه في الغنائم، فأخذ وبرة من بعير وقال: «ما لي مما أفاء الله عليكم من هذه الغنائم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»، فاتق الله يا معاوية واقسم الغنائم على وجهها، ولا تعطِ منها أحدا أكثر من حقه، فقال له معاوية: قد وليتك قسمة الغنائم، وليس أحد بالشام أفضل منك ولا أعلم، فاقسمها بين أهلها واتق الله فيها. فقسمها عبادة بين أهلها وأعانه أبو الدرداء وأبو أمامة([30]).
([1]) تاريخ الطبري (5/248)
([2]) الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، حمدي شاهين، ص252.
([3]) حروب الإسلام في الشام في عهود الخلفاء الراشدين، محمد أحمد باشميل، ص577.
([4]) الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، ص253.
([5]) تاريخ الطبري (5/258).
([6]) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية، د. سليمان بن صالح (2/538).
([7]) تاريخ الطبري (5/260).
([8]) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/538).
([9]) البداية والنهاية (7/159).
([10]) البخاري، رقم: 2877.
([11]) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، د. محمد السيد الوكيل، ص356.
([12]) المصدر نفسه، ص356.
([13]) البداية والنهاية (7/159).
([14]) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ص357.
([15]) المصدر نفسه، ص357.
([16]) المصدر نفسه، ص357.
([17]) المصدر نفسه، ص357.
([18]) تاريخ الطبري (5/261).
([19]) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ص 358، 359.
([20]) يعترون: يعترضون للناس دون أن يسألوهم.
([21]) تاريخ الطبري (5/260).
([22]) المصدر نفسه (5/260).
([23]) التاريخ الإسلامي (12/402).
([24]) جولة تاريخية، ص359، 360.
([25]) البلاذري، ص158.
([26]) جولة تاريخية، ص361.
([27]) التاريخ الإسلامي (12/396).
([28]) البداية والنهاية (7/159)
([29]) التاريخ الإسلامي (12/397).
([30]) الرياض النضرة في مناقب العشرة، لأبي جعفر أحمد، الشهير بالمحب الطبري، ص561.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 3130
تاريخ التسجيل : 31 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 2,291
- شكراً و أعجبني للمشاركة

- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 12
معدل تقييم المستوى
: 16

المبحث الثالث فتوحات الجبهة المصــــــــــرية
أولاً: ردع المتمردين في الإسكندرية:
كبر على الروم خروج الإسكندرية من أيديهم، وظلوا يتحينون الفرص لإعادتها إلى حوزتهم، فراحوا يحرضون مَنْ بالإسكندرية مِنَ الروم على التمرد والخروج على سلطان المسلمين؛ ذلك لأن الروم كانوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون الاستقرار في بلادهم بعد خروج الإسكندرية من ملكهم.([1]) وصادف تحريض الروم لأهل الإسكندرية هوى في نفوس سكانها فاستجابوا للدعوة، وكتبوا إلى قسطنطين بن هرقل يخبرونه بقلة عدد المسلمين ويصفون له ما يعيش فيه الروم بالإسكندرية من الذل والهوان.([2]) وكان عثمان t قد عزل عمرو بن العاص عن مصر، وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وفي أثناء ذلك وصل منويل الخصى قائد قوات الروم إلى الإسكندرية لإعادتها وتخليصها من يد المسلمين، ومعه قوات هائلة يحملهم في ثلاثمائة مركب مشحونة بكل ما يلزم هذه القوات من السلاح والعتاد([3]).
علم أهل مصر بأن قوات الروم قد وصلت إلى الإسكندرية، فكتبوا إلى عثمان يلتمسون إعادة عمرو بن العاص ليواجه القوات الغازية فإنه أعرف بحربهم، وله هيبة في نفوسهم، فاستجاب الخليفة لطلب المصريين، وأبقى ابن العاص أميرا على مصر([4])، ونهب منويل وجيشه الإسكندرية وغادروها بعد أن تركوها قاعا صفصفا, ليعيثوا فيما حولها من القرى ظلما وفسادا، وأمهلهم عمرو بن العاص ليمعنوا في الإفساد وليشعر المصريون بالفرق الهائل بين حكامهم من المسلمين وحكامهم من الروم، ولتمتلئ قلوب المصريين على الروم حقدا وغضبا فلا يكون لهم من حبهم والعطف عليهم أدنى حظ، وخرج منويل بجيشه من الإسكندرية يقصد مصر السفلى دون أن يخرج إليهم عمرو أو يقاومهم أحد، وتخوف بعض أصحابه, وعمرو كان له رأي آخر، فقد كان يرى أن يتركهم يقصدونه، ولا شك أنهم سينهبون أموال المصريين، وسيرتكبون من الحماقات في حقهم ما يملأ قلوبهم حقدا عليهم وغضبا منهم، فإذا نهض المسلمون لمواجهتهم عاونهم المصريون على التخلص منهم، وحدد عمرو سياسته هذه بقوله:
«دعهم يسيروا إليَّ، فإنهم يصيبون من مروا به، فيخزي بعضهم ببعض».([5]) وقد صدق حدس عمرو، وأمعن الروم في إفسادهم ونهبهم وسلبهم، وضج المصريون من فعالهم، وأخذوا يتطلعون إلى من يخلصهم من شر هؤلاء الغزاة المفسدين.([6])
وصل منويل إلى نقيوس، واستعد عمرو للقائه وعبأ جنده، وسار بهم نحو عدوه الشرس، وتقابل الجيشان عند حصن نقيوس على شاطئ نهر النيل، واستبسل الفريقان أيما استبسال، وصبر كل فريق صبرا أمام خصمه مما زاد الحرب ضراوة واشتعالا، ودفع بالقائد عمرو إلى أن يمعن في صفوف العدو، ويقدم فرسه بين فرسانهم، ويشهر سيفه بين سيوفهم، ويقطع به هامات الرجال وأعناق الأبطال، وأصاب فرسه سهم فقتله، فترجل عمرو وانضم إلى صفوف المشاة، ورآه المسلمون فأقبلوا على الحرب بقلوب كقلوب الأسود لا يهابون ولا يخافون قعقعة السيوف.([7]) وأمام ضربات المسلمين وهنت عزائم الروم وخارت قواهم، فانهزموا أمام الأبطال الذين يريدون إحدى الحسنيين، وقصد الروم في فرارهم الإسكندرية لعلهم يجدون في حصونهم المنيعة وأسوارها الشاهقة ما يواري عنهم شبح الموت الذي يلاحقهم([8]).
وخرج المصريون بعد أن رأوا هزيمة الروم يصلحون للمسلمين ما أفسده العدو الهارب من الطرق، ويقيمون لهم ما دمره من الجسور، وأظهر المصريون فرحتهم بانتصار المسلمين على العدو الذي انتهك حرماتهم واعتدى على أموالهم وممتلكاتهم، وقدموا للمسلمين ما ينقصهم من السلاح والمؤونة([9]).
ولما وصل عمرو الإسكندرية ضرب عليهم الحصار ونصب عليها المجانيق وظل يضرب أسوار الإسكندرية حتى أوهنها، وألح عليها بالضرب حتى ضعف أهلها وتصدعت أسوارها وفتحت المدينة الحصينة أبوابها، ودخل المسلمون الإسكندرية وأعملوا سيوفهم في الروم يقتلون المقاتلين، ويأسرون النساء والذرية، وهرب من نجا من الموت لاجئين إلى السفن ليفروا بها عائدين من حيث أتوا، وكان منويل في عداد القتلى، ولم يكف المسلمون عن القتل والسبي حتى أمر عمرو بذلك لما توسط المسلمون المدينة، ولما لم يكن هناك من يقاوم أو يتصدى لهم.([10]) ولما فرغ المسلمون أمر عمرو ببناء مسجد في المكان الذي أوقف فيه القتال وسماه مسجد الرحمة.([11])
وعادت إلى العاصمة العتيدة طمأنينتها، وعادت السكينة إلى قلوب المصريين فيها، فرجع إليها من كان قد فر منها أمام الزحف الرومي الرهيب، وعاد بنيامين بطريرك القبط إلى الإسكندرية بعد أن فر مع الفارين، وأخذ يرجو عمرو ألا يسيء معاملة القبط لأنهم لم ينقضوا عهدهم ولم يتخلوا عن واجبهم، ورجاه كذلك ألا يعقد صلحا مع الروم، وأن يدفنه إذا مات في كنيسة يحنس([12]).
وجاء المصريون من كل حدب وصوب إلى عمرو يشكرونه على تخليصهم من ظلم الروم، ويطلبون منه إعادة ما نهبوا من أموالهم ودوابهم معلنين ولاءهم وطاعتهم، فقالوا: إن الروم قد أخذوا دوابنا وأموالنا ولم نخالف نحن عليكم وكنا على الطاعة، فطلب منهم عمرو أن يقيموا البينة على ما ادعوا، ومن أقام بينة وعرف من له بعينه رده([13]) عليه، وهدم عمرو سور الإسكندرية، وكان ذلك في سنة 25 هـ. وأصبحت الإسكندرية آمنة من جهاتها كلها رغم هدم سورها، فقد كان شرقيها في قبضة المسلمين وكذلك جنوبها، وأما غربيها فقد أمنه عمرو بن العاص بفتح برقة وزويلة وطرابلس الغرب، وصالح أهل هذه البلاد على الجزية فكانوا يدفعونها طائعين، وأما شمالها فكان في قبضة الروم، وقد تلقوا درسا على يد المسلمين لم يترك لهم فرصة للتفكير في العودة، وحتى لو فكروا في العودة فهيهات أن يدخلوها وليس لهم فيها نصير ولا معين، وقوات المسلمين تراقب البحر بكل يقظة واهتمام([14]).
ثانيًا: فتح بلاد النوبة:
كان عمرو بن العاص قد شرع في فتح بلاد النوبة بإذن من الخليفة عمر، فوجد حربا لم يتدرب عليها المسلمون وهي الرمي بالنبال في أعين المحاربين حتى فقدوا مائة وخمسين عينا في أول معركة، ولهذا قبل الجيش الصلح, ولكن عمرو بن العاص رفض للوصول إلى شروط أفضل([15])، وعندما تولى ابن سعد ولاية مصر غزا النوبة في عام إحدى وثلاثين هجرية فقاتله الأساود من أهل النوبة قتالا شديدا، فأصيبت يومئذ عيون كثيرة من المسلمين، فقال شاعرهم:
لم تر عين مثل يوم دُمقلة
|
|
والخيل تعدو بالدروع مثقلة([16])
|
فسأل أهل النوبة عبد الله بن سعد المهادنة، فهادنهم هدنة بقيت إلى ستة قرون([17])، وعقد لهم عقدا يضمن لهم استقلال بلادهم ويحقق للمسلمين الاطمئنان إلى حدودهم الجنوبية، ويفتح النوبة للتجارة والحصول على عدد من الرقيق في خدمة الدولة الإسلامية، وقد اختلط المسلمون بالنوبة والبجة، واعتنق كثير منهم الإسلام([18]).
ثالثـًا: فتح إفريقية:
كان من مقاصد حملة عمرو بن العاص t لبرقة وطرابلس وبقية مناطق ليبيا، فتح البلاد وإزالة الطاغوت الروماني عن قلوب العباد حتى تتضح لهم السبل وتفترق لهم الطرق، وتصبح حرية الاختيار في متناول تلك الشعوب، بعد تلك الحملة المباركة التي كانت سببا في دخول ذلك النور إلى تلك المناطق المظلمة بعبادة الأصنام والتقرب إليها بالقرابين، واتخاذ الأنداد والأرباب من البشر من دونه سبحانه وتعالى، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وعن حملة عبد الله بن سعد على إفريقية([19]) يقول الدكتور صالح مصطفى: وفي سنة 26 هـ/646م عُزِل عمرو بن العاص t عن ولاية مصر، واستعمل عليها عبد الله بن سعد t، وكان عبد الله بن سعد يبعث جرائد الخيل كما كانوا يفعلون أيام عمرو بن العاص فيصيبون من أطراف إفريقية ويغنمون([20])، وكانت جرائد الخيل تقصد إفريقية (تونس) تمهيدا لفتحها ومعرفة وضعها، فكان حال هذه الجرائد أشبه ما يكون بكتائب الاستطلاع التي تعتبر مقدمة الجيش وعيونه، فلما اجتمعت عند عبد الله بن سعد معلومات كافية عن إفريقية من ناحية مداخلها ومخارجها، وقوتها وعدادها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي كتب حينئذ إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان يخبره بهذه المعلومات الهامة عن إفريقية، يستأذن بناء على تلك المعلومات بفتحها، فكان له ما طلب. يقول الدكتور صالح مصطفى: ولما استأذن عبد الله بن سعد الخليفة عثمان بن عفان في غزو إفريقية، جمع الصحابة واستشارهم في ذلك، فأشاروا عليه بفتحها، إلا أبو الأعور سعيد بن زيد، الذي خالفه متمسكا برأي عمر بن الخطاب في ألا يغزو أفريقية أحد من المسلمين، ولما أجمع الصحابة على ذلك دعا عثمان للجهاد، واستعدت المدينة -عاصمة الخلافة الإسلامية- لجميع المتطوعين وتجهيزهم، وترحيلهم إلى مصر لغزو إفريفية تحت قيادة عبد الله بن سعد. وقد ظهر الاهتمام بأمر تلك الغزوة جليا، وهذا يتضح من الذين خرجوا إليها من كبار الصحابة، ومن خيار شباب آل البيت، وأبناء المهاجرين الأوائل وكذلك الأنصار؛ فقد خرج في تلك الغزوة الحسن والحسين، وابن عباس وابن جعفر وغيرهم.
هذا وقد خرج من قبيلة مهرة وحدها في غزوة عبد الله بن سعد ستمائة رجل، ومن غنث سبعمائة رجل، ومن ميدعان سبعمائة رجل، وعندما بات الاستعداد تامًا خطب عثمان فيهم، ورغبهم في الجهاد، وقال لهم: لقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد فيكون الأمر إليه، وأستودعكم الله. ويقال: إن عثمان t قد أعان في هذه الغزوة بألف بعير يحمل عليها ضعفاء الناس، وعندما وصل هذا الجيش إلى مصر انضم إلى جيش عبد الله بن سعد، وتقدم من الفسطاط تحت قيادة عبد الله ذلك الجيش الذي يقدر بعشرين ألفا يخترق الحدود المصرية الليبية، وعندما وصلوا إلى برقة انضم إليهم عقبة بن نافع الفهري ومن معه من المسلمين، ولم يواجه الجيش الإسلامي أية صعوبات أثناء سيرهم في برقة؛ وذلك لأنها ظلت وفية لما عاهدت المسلمين عليه من الشروط زمن عمرو بن العاص، حتى إنه لم يكن يدخلها جابي الخراج، وإنما كانت تبعث بخراجها إلى مصر في الوقت المناسب. ومما يؤكد بقاء برقة على عهدها لعمرو بن العاص، ما ذكر أنه سمع يقول: قعدت مقعدي هذا، وما لأحد من قبط مصر علي عهد إلا أهل أنطابلس([21])، فإن لهم عهدًا يوفي لهم به، كما أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: ولولا مالي بالحجاز لنزلت برقة، فما أعلم منزلا أسلم ولا أعزل منها([22]).
وهكذا انطلقت هذه الحملة المباركة نحو إفريقية, وكان ذلك بعد انضمام قوات عقبة بن نافع إليها، إلا أن عبد الله بن سعد قائد الحملة ما فتئ يرسل الطلائع والعيون في جميع الاتجاهات لاستكشاف الطرق وتأمينها ورصد تحركات العدو وضبطها؛ تحسبا لأي كمين أو مباغتة تطرأ على حين غفلة، فكان من نتائج تلك الطلائع الاستطلاعية أن تم رصد مجموعات من السفن الحربية تابعة للإمبراطورية الرومانية، حيث كانت هذه السفن الحربية قد رست في ساحل ليبيا البحري بالقرب من مدينة طرابلس، فما هي إلا برهة من الزمن حتى كان ما تحمله هذه السفن غنيمة للمسلمين، وقد أسروا أكثر من مائة من أصحابها، وتعتبر هذه أول غنيمة ذات قيمة أصابها المسلمون في طريقهم لفتح إفريقية.([23])
وواصل عبد الله بن سعد السير إلى إفريقيا، وبث طلائعه وعيونه في كل ناحية، حتى وصل جيشه إلى مدينة سبيطلة بأمان، وهناك التقى الجمعان؛ جيش المسلمين بقيادة عبد الله ابن سعد وجيش جرجير حاكم إفريقية، وكان تعداد جيشه يبلغ حوالي مائة وعشرين ألفا، وكان بين القائدين اتصالات مستمرة ورسائل متبادلة، فَحْوَاها عرض الدعوة الإسلامية على جرجير ودعوته للدخول في الإسلام، ويستسلم لأمر الله سبحانه، أو أن يدفع الجزية، ويبقى على دينه خاضعا لسيادة الإسلام، ولكن كل تلك العروض رفضها وأصر واستكبر هو وجنوده، وضاق الأمر بالمسلمين، ونشبت المعركة بين الجمعين وحمى الوطيس بينهما لعدة أيام، حتى وصل مدد بقيادة عبد الله بن الزبير، وكانت نهاية هذا المستكبر الطاغي جرجير على يديه([24]).
ولما رأى الروم الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبيطلة، غارت أنفسهم وتجمعوا وكاتب بعضهم بعضا في حرب عبد الله بن سعد إياهم، فخافوه وراسلوه وجعلوا له جعلا على أن يرتحل بجيشه، وألا يعترضوه بشيء ووجهوا إليه ثلاثمائة قنطار من الذهب في بعض الروايات، وفي البعض الآخر مائة قنطار، جزية في كل سنة على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم، فقبل ذلك منهم وقبض المال، وكان في شرط صلحهم أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم، وما أصابوه بعد الصلح رده عمر إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد: إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم، وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن الروم في باطن العسكر إلى أن يضجروا ويملوا, فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة، فلعل الله ينصرنا عليهم، فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك، فلما كان الغد فعل عبد الله ما اتفقوا عليه، وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم عندهم مسرجة، ومضى الباقون فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديدا، فلما أذن بالظهر همَّ الروم بالانصراف على العادة فلم يمكنهم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم، ثم عاد عنهم والمسلمون؛ فكل الطائفتين ألقى سلاحه ووقع تعبا، فعند ذلك أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريحا من شجعان المسلمين وقصد الروم فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبروا فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون، وقتل جرجير، قتله ابن الزبير، وانهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأخذت ابنة الملك جرجير سبية، ونازل عبد الله بن سعد المدينة وحاصرهم حتى فتحها، ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في غيرها، فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينار.
ولما فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا، وسيِّر عسكرا إلى حصن الأجم، وقد احتمى به أهل تلك البلاد فحصرهم وفتحه بالأمان فصالحه أهل إفريقية كما مر معنا، ونفل عبد الله بن الزبير ابنة الملك وأرسله ابن سعد إلى عثمان بالبشارة بفتح إفريقية([25]).
رابعًا: بطولة عبد الله بن الزبير في فتح إفريقية:
هذا ولقد كان لعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- موقف عظيم في البطولة والشجاعة، وقد ذكره الحافظ ابن كثير حيث قال: لما قصد المسلمون -وهم عشرون ألفا- إفريقية، وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وفي جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومائة ألف، وقيل في مائتي ألف، فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة، فوقف المسلمون في موقف لم ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه.
قال عبد الله بن الزبير: نظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون، وجاريتان تظلانه بريش الطواويس، فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح فسألته أن يبعث معي من يحمي ظهري، وأقصد الملك، فجهز معي جماعة من الشجعان، فأمر بهم فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه، وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك، فلما اقتربت منه أحس مني الشر، ففر على برذونه فلحقته فصفعته برمحي وذففت -يعني أجهزت- عليه بسيفي، وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت، فلما رأى ذلك البربر فَرِقُوا وفروا كفرار القطا، واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون, فغنموا غنائم جمة وأموالا عظيمة وسبيًا عظيمًا، وذلك ببلد يقال له: (سبيطلة) على يومين من القيروان.
قال ابن كثير: فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير t وعن أبيه، وعن سائر الصحابة الكرام أجمعين([26]).
إن ما قام به ابن الزبير نوع من الطموح نحو المعالي المحفوفة بالأهوال بدون تدرج سابق، لقد كان عمره آنذاك سبعا وعشرين سنة، ولم يذكر له قبل ذلك مواقف بطولية من نوع المغامرات، فكيف أقدم على هذه المغامرة الهائلة التي يغلب على الظن أو يكاد يقرب من اليقين في عرف الناس العاديين أن فيها الهلاك؟!! وإن الاحتمالات التي يمكن أن ترد في مثل هذه المغامرة أن يدور في خلد المغامر أمران:
1- أن ينجح في هجومه فيقضي على ملك البربر، ويتفرق جنده كما هي عادة الكفار، وفي ذلك نصر مؤزر للمسلمين، وكفاية لهم عن خوض معركة شرسة قد تخوف منها المسلمون.
2- أن يتقبله الله شهيدا، وفي ذلك الوصول إلى أسمى الأماني، وأبلغ الدرجات التي يطمح إليها الصالحون ويتنافسون على بلوغها، كما أن في ذلك من إرهاب الكفار وإثارة الرعب فيهم الشيء الكثير؛ حيث سيتوقع الكفار أن المسلمين الذين سيقاتلونهم كلهم من هذا النوع الجريء الفتاك؛ إذ أنه يكفي المغامر شجاعة أن يقذف بنفسه في وسط المعركة الملتهبة، إنه لا يقدم على هذه الوثبة العالية إلا العظماء الذين يتصورون الجنة من وراء تلك الوثبة ويشتاقون للعيش فيها. ولقد كان ابن الزبير وثب تلك الوثبة متجردا من علائق الدنيا وأثقالها المثبطة، طامحا إلى ما أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله على قدر طاقتهم، سواء انتصروا على أعدائهم أو نالوا الشهادة.([27])
وقد جاء في هذا الخبر أن البربر بعدما قتل ملكهم فروا من جيش المسلمين كفرار القَطَا، وأن المسلمين تبعوهم يقتلون ويأسرون منهم من غير مقاومة، وإن هذا الخبر دليل على أن الله تعالى مع أوليائه المؤمنين، وأنه يقيض لهم إذا صدقوا ما يخلصهم من الشدائد وينقذهم من المآزق، فإن المسلمين قد وقعوا في معضلة كبرى؛ حيث أحاط بهم أعداؤهم الذين يفوقونهم ست مرات في العدد أو أكثر، وكان على المسلمين أن يقاتلوهم من كل جانب، وهو أمر عسير على جيش صغير بالنسبة لكثرة عدوه، كما جاء في قول الراوي: فوقف المسلمون في موقف لم ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه، فقيض الله لهم هذا البطل المغوار الذي أقدم على مغامرة نادرة المثال، فأنقذ الله به ذلك الجيش الإسلامي من عسرة كان يعاني منها.([28])
ولا ننسى موقف الأبطال الذين كانوا مع عبد الله بن الزبير يحمون ظهره، فإنهم قد شاركوه في تلك المخاطرة، ولئن لم يذكر التاريخ أسماءهم فإن عملهم الفدائي قد بقي مخلدا في الدنيا برفع ذكر هذه الأمة حينما تفاخر بأبطالها، وفي الآخرة بما ينتظرون من وعد الله للمجاهدين الصادقين([29]).
هذا وقد قدَّم المسلمون الغالي والرخيص في فتوحات إفريقية، واستشهد منهم الكثير، وممن توفى منم غازيا بإفريقية في خلافة عثمان أبو ذؤيب الهذلي وكان شاعرا مشهورا، وهو الذي قال:
وإذا المنية أنشبت أظفارها
|
|
ألفيت كل تميمة لا تنفع
|
وتجلدي للشامتين أريهم
|
|
أني لريب الدهر لا أتضعضع([30])
|
خامسًا: معركة ذات الصواري:
أصيب الروم بضربة حاسمة في إفريقية، وتعرضت سواحلهم للخطر بعد سيطرة الأسطول الإسلامي على سواحل المتوسط من ردوس حتى برقة، فجمع قسطنطين بن هرقل أسطولا بناه الروم من قبل، فخرج بألف سفينة لضرب المسلمين ضربة يثأر لها لخسارته المتوالية في البر، فأذن عثمان t لصد العدوان، فأرسل معاوية مراكب الشام بقيادة بسر بن أرطأة، واجتمع مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح في مراكب مصر، وكانت كلها تحت أمرته، ومجموعها مائتا سفينة فقط، وسار هذا الجيش الإسلامي وفيه أشجع المجاهدين المسلمين ممن أبلوا في المعارك السابقة؛ فقد انتصر هؤلاء على الروم من قبل في معارك عديدة، فشوكة عدوهم في أنفسهم محطمة، لا يخشونه ولا يهابونه، على الرغم من قلة عدد سفنهم إذا قيست بعدد سفن عدوهم. خرج المسلمون إلى البحر وفي أذهانهم وقلوبهم إعزاز دين الله وكسر شوكة الروم، ولقد كان لهذه المعركة التاريخية أسباب، منها:
1- الضربات القوية التي وجهها المسلمون إلى الروم في إفريقية.
2- أصيب الروم في سواحلهم الشرقية والجنوبية بعد أن سيطر المسلمون بأسطولهم عليها.
3- خشية الروم من أن يقوى أسطول المسلمين فيفكروا في غزو القسطنطينية.
4- أراد قسطنطين بن هرقل استرداد هيبة ملكه بعد الخسائر المتتالية برًّا، وعلى شواطئه في بلاد الشام ومصر وساحل برقة.
5- كما أراد الروم خوض معركة ظنوا أنها مضمونة النتائج، كي تبقى لهم السيطرة في المتوسط، فيحافظوا على جزره، فينطلقوا منها للإغارة على شواطئ بلاد العرب.
6- محاولة استرجاع الإسكندرية بسبب مكانتها عند الروم، وقد ثبت تاريخيا مكاتبة سكانها لقسطنطين بن هرقل ملك الروم. هذه بعض أسباب معركة ذات الصواري([31]).
أين وقعت هذه المعركة؟
وهذا السؤال لم يجد المؤرخون له جوابا موحدا؛ فالمراجع العربية لم تحدد مكانها، باستثناء مرجع واحد على ما نعلم صرح بالمكان بدقة، وآخر قال اتجه الروم إليه.
* في (فتح مصر وأخبارها) ([32])ذكر الكتاب خطبة عبد الله بن سعد بن أبي السرح وقال: قد بلغني أن هرقل قد أقبل إليكم في ألف مركب. ولم يحدد مكان المعركة.
* (الطبري) ([33]) في أخبار سنة 31هـ، ربط حدوث ذات الصواري بما أصاب المسلمون من الروم في إفريقية، وقال: فخرجوا في جمع لم يجتمع للروم مثله قط.
* ولم يذكر (الكامل في التاريخ) ([34]) مكان الموقعة أيضا، ولكنه ربط سبب وقوعها بما أحرزه المسلمون من نصر في إفريقية بالذات.
* وفي (البداية والنهاية) ([35]): فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي السرح من أصاب من الفرنج والبربر بلاد إفريقية، حميت الروم واجتمعت على قسطنطين بن هرقل، وساروا إلى المسلمين في جمع لهم لم ير مثله منذ كان الإسلام؛ خرجوا في خمسمائة مركب وقصدوا عبد الله بن سعد بن أبي السرح في أصحابه من المسلمين ببلاد المغرب.
* (تاريخ الأمم الإسلامية): ([36]) لم يذكر مكان الموقعة أيضا([37])، ورجح الدكتور شوقي أبو خليل أن المعركة كانت على شواطئ الإسكندرية، وذلك
للأسباب التالية:
* كتاب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) يذكر صراحة: غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية([38]).
* تاريخ ابن خلدون يذكر([39]): ثم بعث ابن أبي السرح السرايا ودوخ البلاد فأطاعوا وعاد إلى مصر، ولما أصاب ابن أبي السرح إفريقية ما أصاب، ورجع إلى مصر خرج قسطنطين بن هرقل غازيا إلى الإسكندرية في ستمائة مركب.
* ربطت المراجع العربية التي لم تحدد موقع المعركة بين حدوث المعركة وبين ما خسره الروم في شمال إفريقية بالذات.
* الأسطول الرومي صاحب ماض عريق، فهو سيد المتوسط قبل ذات الصواري، فهو أجرأ على مهاجمة السواحل الإسلامية، ولذلك رجح الدكتور شوقي أبو خليل مجيء الأسطول الرومي إلى شواطئ الإسكندرية لاستعادتها بسبب مكانتها عند الروم، ومكاتبة أهلها لملكهم السابق، وهو بذلك يقضي أيضا على الأسطول الفتي في مهده، الذي شرع العرب في بنائه بمصر، فتبقى للروم السيطرة والسطوة في مياه المتوسط وجزره.
* المراجع الأجنبية تعرف ذات الصواري بموقعة (فو###ة)، وفو###ة هو ثغر يقع غرب مدينة الإسكندرية، بالقرب من مدينة مرسى مطروح، فهي تحدد الموقع تماما([40]).
* أحداث المعركة:
قال مالك بن أوس بن الحدثان: كنت معهم في ذات الصواري، فالتقينا في البحر، فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط، وكانت الريح علينا -أي لصالح مراكب الروم- فأرسينا ساعة، وأرسوا قريبا منا، وسكتت الريح عنا، قلنا للروم: الأمن بيننا وبينكم، قالوا: ذلك لكم، ولنا منكم.([41]) كما طلب المسلمون من الروم: إن أحببتم ننزل إلى الساحل فنقتتل حتى يكتب لأحدنا النصر، وإن شئتم فالبحر. قال مالك بن أوس: فنخروا نخرة واحدة، وقالوا: بل الماء الماء، وهذا يظهر لنا ثقة الروم بخبرتهم البحرية، وأملهم في النصر لممارستهم أحواله وفنونه، مرنوا عليه فأحكموا الدراية بثقافته وأنوائه فطمعوا بالنصر فيه، خصوصا أنهم يعلمون حداثة عهد المسلمين به([42]).
بات الفريقان تلك الليلة في عرض البحر، وموقف المسلمين حرج، فقال القائد المسلم لصحبه: أشيروا عليَّ؟ فقالوا: انتظر الليلة بنا لنرتب أمرنا ونختبر عدونا، فبات المسلمون يصلون ويدعون الله -عز وجل- ويذكرونه ويتهجدون، فكان لهم دوي كدوي النحل على نغمات تلاطم الأمواج بالمراكب، أما الروم فباتوا يضربون النواقيس في سفنهم، وأصبح القوم، وأراد قسطنطين أن يسرع في القتال، ولكن عبد الله بن سعد بن أبي السرح لما فرغ من صلاته إماما بالمسلمين للصبح، استشار رجال الرأي والمشورة عنده، فاتفق معهم على خطة رائعة: فقد اتفقوا على أن يجعلوا المعركة برية على الرغم من أنهم في عرض البحر، فكيف تم للمسلمين ذلك؟ أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لامست سفنهم سفن العدو، فنزل الفدائيون أو رجال الضفادع البشرية في عرفنا الحالي إلى الماء، وربطوا السفن الإسلامية بسفن الروم، ربطوها بحبال متينة، فصار 1200 سفينة في عرض البحر، كل عشرة أو عشرين منها متصلة مع بعضها، فكأنها قطعة أرض ستجري عليها المعركة، وصفَّ عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن يعظهم ويأمرهم بتلاوة القرآن الكريم، خصوصا سورة الأنفال؛ لما فيها من معاني الوحدة والثبات والصبر([43]).
وبدأ الروم القتال، فهم في رأيهم قد ضمنوا النصر عندما قالوا: بل الماء الماء، وانقضوا على سفن المسلمين بدافع الأمل بالنصر، مستهدفين توجيه ضربة أولى حاسمة يحطمون بها شوكة الأسطول الإسلامي، فنقض الروم صفوف المسلمين المحاذية لسفنهم، وصار القتال كيفما اتفق, وكان قاسيا على الطرفين، وسالت الدماء غزيرة اصطبغت بها صفحة الماء، فصار أحمر، وترامت الجثث في الماء، وتساقطت فيه, وضربت الأمواج السفن حتى ألجأتها إلى الساحل، وقتل من المسلمين الكثير، وقتل من الروم ما لا يحصى، حتى وصف المؤرخ البيزنطي (ثيوفانس) هذه المعركة بأنها كانت يرموكا ثانيا على الروم.([44]) ووصفها الطبري بقوله: إن الدم كان غالبا في الماء في هذه المعركة([45])، حاول الروم أن يغرقوا سفينة القائد المسلم عبد الله بن أبي السرح، كي يبقى جند المسلمين دون قائد، فتقدمت من سفينته سفينة رومية، ألقت إلى عبد الله السلاسل لتسحبها وتنفرد بها، ولكن علقمة بن يزيد الغطيفي أنقذ السفينة والقائد بأن ألقى بنفسه على السلاسل وقطعها بسيفه([46]).
وصمد المسلمون رغم كل شيء، وصبروا كعادتهم في معاركهم، فكتب الله -عز وجل- لهم النصر بما صبروا، واندحر ما تبقى من الأسطول الرومي، وكاد الأمير قسطنطين أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين -كما ذكر ابن عبد الحكم- لكنه تمكن من الفرار لما رأى قواه تنهار وجثث جنده على سطح الماء تلقى بها الأمواج إلى الساحل. لقد رأى أسطوله الذي تأمل فيه خيرا ونصرا وإعادة كرامة يغرق قطعة بعد قطعة، ففر مدبرا والجراحات في جسمه، والحسرة تأكل فؤاده، يجر خيبة وفشلا، فوصل جزيرة صقلية([47])، وألقت به الريح هناك، فسأله أهله عن أمره فأخبرهم، فقالوا: شمت النصرانية، وأفنيت رجالها، لو دخل المسلمون لم نجد من يردهم([48]) فقتلوه، وخلوا من كان معه من المراكب([49]).
* نتائج ذات الصواري:
1- كانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحر خاضها المسلمون، أظهر فيها الأسطول الفتيُّ الصبر والإيمان، والجَلَد والفكر السليم بما تفتَّق عنه الذهن الإسلامي من خطة جعلت المعركة صعبة على أعدائهم، فاستحال عليهم اختراق صفوف المسلمين بسهولة، كما استخدم المسلمون خطاطيف طويلة يجرون بها صواري وشرع سفن الأعداء، الأمر الذي انتهى بكارثة بالنسبة للروم.
2- كانت ذات الصواري حدا فاصلا في سياسة الروم إزاء المسلمين، فأدركوا فشل خططهم في استرداد هيبتهم، أو استرجاع مصر أو الشام، وانطلق المسلمون في عرض هذا البحر الذي كان بحيرة رومية، وانتهى اسم (بحر الروم) إلى الأبد، واستطاع المسلمون فتح قبرص وكريت وكورسيكا وسردينيا وصقلية وجزر البليار، ووصلوا إلى جنوة ومرسيليا.
3- قتل قسطنطين فتولى ابن قسطنطين الرابع من بعده، وكان حَدَثًا صغير السن، مما جعل الظروف مواتية لقيام حملة بحرية وبرية إسلامية تستهدف عاصمة روما (القسطنطينية) فيما بعد.
4- الإعداد الروحي قبل المعركة -أو ما يسمى بالتوجيه المعنوي في أيامنا هذه- له قيمته في تحقيق النصر؛ حيث تتجه القلوب إلى الله بصدق، فهذا المؤمن الذي بات ليله في تهجد وذكر، يستمد العون من الله، من عظمته وعزته، بعد أن هيأ الأسباب، يلقى الأعداء بروح عالية لا يهاب الموت، فالله أكبر من كل شيء، وهذه المعارك التي نصف أحداثها التاريخية هي وصفة طبية نعرضها للتطبيق والنهج، لنستفيد منها في حياتنا؛ فحياة الصحابة ما هي إلا للقدوة وسيرة للاتباع.([50])
5- أصبح البحر المتوسط بحيرة إسلامية، وصار الأسطول الإسلامي سيد مياه البحر المتوسط، وهذا الأسطول ليس للتسلط والقرصنة بل للدعوة إلى الله وكسر شوكة المشركين، ونشر الحضارة المنبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
6- عكف المسلمون على دراسة علوم البحرية، وصناعة السفن، وكيفية تسليحها، وأسلوب القتال من فوقها، وعلوم الفلك المتصلة بتسييرها في البحار، ومعرفة مواقعهم على المصورات البحرية المختلفة، فيما بعد، فعرفوا الاصطرلاب (البوصلة الفلكية), وطوروها إلى المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البحارة الغربيون أمثال: كرستوف كولومبس، وأمريكوفيسبوشي في اكتشافاتهم([51]).
7- لقد كانت هذه المعركة مظهرا من مظاهر تفوق العقيدة الصحيحة الصلبة على الخبرة العسكرية والتفوق في العدد والعُدَد، فلقد كان الروم هم أهل البحر منذ القدم، وقد مروا بتجارب طويلة في الحروب البحرية، بينما كان المسلمون حديثي عهد بركوب البحر والقتال البحري، ولكن الله تعالى أدلى المسلمين عليهم برغم التفوق المذكور؛ لأنه سبحانه قد سخر أولئك المؤمنين لنشر دينه وإعلاء كلمته في الأرض. وإن مما يشاد به في هذه المعركة قوة قائدها عبد الله بن سعد بن أبي السرح ورباطة جأشه، ومقدرته الجيدة على إدارة الحروب، وهي بعد ذلك لون من ألوان بسالة المسلمين واستقالتهم في الحروب بأنفسهم في سبيل إعزاز دينهم ورفع شأن دولتهم([52]).
سادسًا: أهم الدروس والعبر والفوائد في فتوحات عثمان:
1- تحقيق وعد الله للمؤمنين:
قال ابن كثير في حديثه عن عثمان بن عفان t:... ففتح الله على يديه كثيرا من الأقاليم والأمصار، وتوسعت المملكة الإسلامية، وامتدت الدولة المحمدية، وبلغت الرسالة المصطفوية في مشارق الأرض ومغاربها، وظهر للناس مصداق قوله تعالى: "وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" [النور: 55]، وقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" [التوبة: 33]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله».([53]) وهذا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطد في زمان عثمان ([54]).
2- التطور في فنون الحرب والسياسة:
كانت الحروب تنشأ بين الشعوب من أجل قطعة من الأرض يراد تملكها، أو بسبب اعتداء يقع على بلد أو قبيلة، ولكنها في عهد النبوة والعهد الراشدي أصبحت بسبب المبادئ؛ فالمسلمون يريدون أن تكون عقيدتهم هي السائدة والمهيمنة في الأرض، فاصطدمت بعقائد فاسدة ومنحرفة كعقائد المشركين والمجوس، على أن هذا لم يكن كل شيء في التطور الحربي، بل نجد لونا جديدا آخر وهو ما كان يعرضه المجاهدون المسلمون على أعدائهم من: الإسلام أو الجزية أو المناجزة، ونتج عن تلك الفتوح سياسة فذة أرضت جميع الشعوب إلا من كان في قلبه حقد على العدل والمساواة ممن كانت تحدثهم نفوسهم بالفتن والعصيان، وهؤلاء اضطروا المسلمين أحيانا إلى الشدة معهم والتنكيل بهم([55]).
3- بدء التجنيد الإلزامي في عهد عمر واستمراره في عهد عثمان:
كانت معركة القادسية من أسباب اتخاذ الفاروق لقرار التجنيد الإلزامي، فقد أمر عماله على الأقاليم بإحضار كل فارس ذي نجدة أو رأى أو فرس أو سلاح، فإن جاء طائعا وإلا حشروه حشرا وقادوه مقادا، واستعجلهم في ذلك بحزمه المشهور قائلا: لا تدعوا أحدا إلا وجهتموه إليَّ، والعَجَلَ العجل.([56]) وكان عمر يفكر في التجنيد الإلزامي الموقوف للجهاد، فلما دوَّن الديوان ورتب للمسلمين أرزاقهم السنوية، خرجت فكرته إلى حيز الوجود، واقترنت نشأة الديوان بنشأة التجنيد النظامي الرسمي، وحددت للجنود النظاميين عطاياهم ورواتبهم من بيت مال المسلمين، وعندما أذن عثمان لمعاوية بالغزو بحرا أمره أن يخير الناس ولا يكرههم؛ حتى لا يذهب أحد إلى هذا الضرب من الغزو إلا طائعا مختارا، أما التجنيد برا لإتمام حركة الفتوح، فقد ظل في عهده إلزاميا على أصحاب الرواتب والأرزاق من الجنود النظاميين([57]).
4- اهتمام عثمان بحدود الدولة الإسلامية:
ترتب على توسع الدولة الإسلامية في عهد عثمان t الاستمرار في سياسة تحصين الثغور للحفاظ على حدود الدولة الإسلامية من مهاجمة الأعداء، سواء كان ذلك بشحنها بالجند المرابطين أو بناء الحاميات الدفاعية المختلفة بها، فكان أول كتاب كتبه عثمان بن عفان t في خلافته لأمر الأجناد في الثغور لحماية حدود الدولة الإسلامية قوله: أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان على ملإ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون فإني أنظر فيما أكرمني الله النظر فيه والقيام عليه ([58]).
وتسهيلا وتيسيرا للعملية الإدارية جمع الخليفة عثمان t لمعاوية بن أبي سفيان الشام والجزيرة وولاية ثغورهما في إدارة موحدة، وكلفه بغزو ثغر شمشاط بنفسه، أو أن يولي ذلك من يرتضيه من كبار قواده من أصحاب الخبرة والشجاعة الراغبين في الجهاد والحرب مع الروم.([59]) كما كتب أيضا لمعاوية بن أبي سفيان أن يلزم ثغر أنطاكية قوما، وأن يقطعهم القطائع به ففعل ذلك.([60]) وكان t يهتم بأمر الثغور ويبعث من يستعلم له عن بعضها([61])، وعندما غزا معاوية بن أبي سفيان عمورية وجد الحصون التي فيها بين ثغر أنطاكية وثغر طرسوس خالية من مقاتلة الروم، فجعل به جماعة من جند الشام والجزيرة وقنسرين وأمرهم بالوقوف عندها لتحمي ظهره أثناء انسحابه وانصرافه من غزواته، ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو سنتين يزيد بن الحر العبسي([62]) الصائفة وأمره بفعل الشيء نفسه، وكانت ولاة الصوائف والشواتي إذا دخلوا بلاد الروم فعلوا ذلك؛ حيث يخلفون بها جندا كثيفا إلى خروجهم من أرض العدو([63])، وقد أبلى معاوية بن أبي سفيان في أثناء إدارته للسواحل الشامية وفي تحصينها بلاء حسنا([64]).
وكتب عثمان لعبد الله بن سعد بن أبي السرح يأمره بالحفاظ على ثغر الإسكندرية بإلزام الجند المرابطة به وأن يجري عليهم أرزاقهم، وأن يعقب بين المرابطين من أجل أنه لا يضر بهم التجمير، فقال له: قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالإسكندرية، وقد نقضت الروم مرتين، فألزم الإسكندرية مرابطيها، ثم أجرِ عليهم أرزاقهم وأعقب بينهم في كل ستة أشهر.([65]) وكان من عادة قادة الخليفة عثمان بن عفان t إذا تقدموا في الفتوح واستولوا على حصون العدو قاموا بترميمها كمن سبقهم من القادة، ثم إسكانها جند المسلمين من المرابطين، بالإضافة إلى استحداثهم لتحصينات دفاعية جديدة، فمن تلك الحصون التي قام بترميمها معاوية بن أبي سفيان: حصون الفرات وهي سميساط([66])، وملطية([67]), وسمشاط وكمخ([68]), وقاليقلا([69])، وهي حصون استولى عليها المسلمون عند فتحهم لأرمينية في عهد عثمان t، وقاموا بترميمها وإسكانها الجند([70]).
ففي قاليقلا قام القائد حبيب بن مسلمة الفهري بإسكان ألفي رجل وأقطعهم بها القطائع، وجعلهم مرابطين بها.([71]) وقد كلف الخليفة عثمان t القائد حبيب بن مسلمة بأن يقيم بثغور الشام والجزيرة لإدارتها وحمايتها.([72]) وعندما فتح البراء بن عازب t ثغر قزوين رتب فيهم خمسمائة رجل من جند المسلمين وعين عليهم قائدا وأقطعهم أرضا وضياعا لا حق فيها لأحد، فعمروا وأجروا أنهارها وحفروا آبارها.([73]) وحين فتح سعيد بن العاص طميسة([74]) جعل بها مرابطة من ألفي رجل وعين عليهم قائدا.([75]) إلى غير ذلك من التحصينات التي أنشئت بالثغور في إدارة الخليفة عثمان بن عفان t، والتي كانت تشحن بالجند لحماية حدود الدولة الإسلامية.([76])
وعني الخليفة عثمان t في إدارته بأمر الصوائف والشواتي؛ حيث عمل على تسييرها وتسهيل أمرها في كل عام، وكان يتولاها كبار قادته وولاته أمثال معاوية بن أبي سفيان t الذي بنى جسرا بمنبج([77]) لمرور الصوائف عليه فلم يكن قبل إذ، وقد فوض الخليفة عثمان t إلى واليه معاوية في غزو الروم وتولى قيادة الصائفة من يختاره، فولي معاوية سفيان بن عوف الذي لم يزل على الصوائف في عهد عثمان t، ولم تقتصر حملات الصوائف والشواتي على الحدود البرية بل شملت كذلك البحر في عهد عثمان t([78]).
5- قسمة الغنائم بين أهل الشام والعراق:
استطاع حبيب بن مسلمة أن يهزم الروم في أرمينية قبل وصول مدد الوليد بن عقبة من الكوفة، وغنم أهل الشام غنائم كثيرة، وبعد وصول مدد أهل الكوفة اختلفوا في أمر الغنائم، مما جعل حبيبا يكتب بذلك إلى معاوية فكتب معاوية, إلى الخليفة عثمان t يخبره بذلك، فحكم عثمان بن عفان t على أهل الشام أن يقاسموا أهل العراق ما غنموا من تلك الغنائم، فلما ورد كتاب الخليفة عثمان بن عفان t حبيب بن مسلمة قرأه على جند أهل الشام، فقالوا: السمع والطاعة لأمير المؤمنين، ثم قاسموا أهل العراق وغنموا.([79])
6- الحرص على وحدة الكلمة في مواجهة العدو:
في عهد عثمان t استخلف عبد الله بن عامر على خراسان قيس بن الهيثم السلمي، حيث خرج منها فجمع قارن جمعا كثيرا من ناحية الطبسين وأهل بادغيس وهراة وقستهان، فأقبل في أربعين ألفا، فاستشار قيس بن الهيثم عبد الله بن خازم قائلا له: ما ترى؟ قال: أرى أن تخلي البلاد فإني أميرها ومعي عهد من ابن عامر، إذا كانت حرب بخراسان فأنا أميرها، وأخرج كتابا قد افتعله عمدا، فكره قيس مشاغبته وخلاه والبلاد.([80]) أحب قيس بن الهيثم بفعله هذا أن يجمع الكلمة بدلا من تفريقها حتى لا يحدث الفشل والوهن للجنود، فتكون الهزيمة، وقد تم النصر للمسلمين على الأعداء بحمد الله([81]).
7- شرط ما يحتاج إليه الجنود في بنود الصلح:
في عهد عثمان t زادت الفتوحات الإسلامية اتساعا مما جعل قادته يشترطون في بعض عهودهم للصلح بأن تكون من المواشي والطعام والشراب لإعداد ما يحتاج إليه الجيش؛ من زاد وتموين وميرة حتى تساعدهم في فتوحاتهم، فلا يتكلفون عناء حمل الميرة من القيادة المركزية ويستغنون عن طلبها؛ ليكونوا على الحرب أوفر وعلى منازلة العدو أقدر.([82])
8- جمع المعلومات عن الأعداء:
استمرت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان t, وكان t يهتم بالأخبار ويتقصاها بنفسه([83])، وسار قادته على منوال من سبقهم من القادة بالاعتناء بأمر العيون وتقصي أخبار العدو.([84]) كما أنهم جعلوها شرطا من شروط المعاهدات بينهم وبين المعاهدين حيث طلبوا منهم بأن ينصحوا وينذروا المسلمين بسير عدوهم إليهم, ومعاونتهم بأن يكونوا عليهم جواسيس وإبلاغ المسلمين بتحركاتهم([85]).
9- عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي من قادة الفتوح في عهد عثمان:
كان عبد الرحمن قائدا عَقَديًّا من الطراز الرفيع، وكان لتمسكه الشديد بعقيدته موضع ثقة رؤسائه ومرؤوسيه على حد سواء، بالإضافة إلى شجاعته وإقدامه وعلمه بأمور الدين، لذلك بقي قائدا لمنطقة (باب الأبواب) وواليا عليها منذ وفاة سراقة بن عمرو حتى استشهد، لم يعزل من منصبه على الرغم من تبدل الخلفاء وتغير الولاة والقادة في الكوفة مرجع عبد الرحمن المباشر، وكان عبد الرحمن يؤمن بوسائل حرب الفروسية الشريفة، فلا يخون ولا يغدر ولا يضرب من الخلف.([86]) وكان لسيرته الحسنة في منطقة (باب الأبواب) وجنوب بحر الخزر وغربه أثر أي أثر في استقرار الأمور واستتباب الأمن والنظام في تلك الربوع، فأصبحت تلك المناطق قاعدة أمامية لنشر الإسلام والفتح شمالا، فثبت الإسلام في تلك الأصقاع النائية في وجه مختلف المحن والتيارات منذ أربعة عشر قرنا حتى اليوم([87]).
ومن مواقفه الخالدة التي سطرها على صفحات التاريخ عندما خرج بالناس حتى قطع (الباب) فقال له الملك شهريار: ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أريد (بَلَنْجَر) والترك، قال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون (الباب). قال عبد الرحمن: لكنا لا نرضى منهم ذلك حتى نأتيهم في ديارهم، وتالله إن معنا لأقواما لو يأذن أميرنا في الإمعان لبلغت فيهم (الرَدْم). ([88]) قال الملك: وما هو؟ فأجابه عبد الرحمن: أقوام صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الأمر بنية، كانوا أصحاب حياء وتكرم في الجاهلية، فازداد حياؤهم وتكرمهم, فلا يزال هذا الأمر دائما لهم، ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم، وحتى يلفتوا عن حالهم.([89])
وقد غزا عبد الرحمن (بلنجر) غزاة في زمن عمر بن الخطاب، فقال الترك: ما اجترأ علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم من الموت، فهرب منه الترك وتحصنوا فرجع بالغنيمة والظفر بعد أن بلغه خيله (البيضاء) على رأس مائتي فرسخ من (بلنجر)، وعادوا ولم يقتل منهم أحد.([90]) ومن الواضح أن معنويات المسلمين كانت عالية جدا لتتابع انتصاراتهم، ولتمسكهم بدينهم، كما أن معنويات الأمم التي حاربوها كانت منهارة؛ لأن المسلمين غلبوا الأمم التي قاتلوها، لذلك هرب الأتراك من المسلمين وتحصنوا، فلم يحدث قتال فعلي في هذه الغزوة، فلم يسقط من المسلمين شهيد.([91]) لقد كان عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي على جانب عظيم من التقوى والخلق الكريم، وكان تصرفه مع المغلوبين له الأثر في استتباب الأمن واستقرار النظام وانتشار الإسلام، فقد كان وفيًّا غاية الوفاء، أمينا غاية الأمانة؛ فقد أرسل ملك الباب رسولا إلى ملك (الصين) مع هدايا -وذلك قبل أن يفتح المسلمون بلاده- فعاد رسوله من رحلته بعد فتح المسلمين لتلك البلاد، وكان مع الرسول العائد هدايا من ملك الصين بينها ياقوتة حمراء ثمينة، وكان ملك (الباب) حين عودة رسوله في مجلس عبد الرحمن، فتناول الملك من رسوله تلك الياقوتة ثم ناولها عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن ردها فورا إلى الملك بعد أن نظر إليها، فهتف الملك متأثرا وقال: لهذه -يعني الياقوتة- خير من هذا البلد (أي باب الأبواب)، وأيم الله لأنتم أحب إليَّ حكاما من آل كسرى، فلو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها مني، وأيم الله لا يقوم لكم شيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر.([92])
كان من حق ملك المدينة (الباب) وما حولها أن يعجب أشد العجب ويدهش أشد الدهشة بأمانة القائد المسلم ووفائه، فقد عاش هذا الملك عمره كله في دوامة عنيفة من الخيانة وفي جو مشحون بالغدر، فلما رأى أمانة المسلمين المثالية ووفائهم المطلق لم يتمالك نفسه أن نسى ملكه المضاع وملوكه الغابرين, فعبر عن شعوره بكلمات خارجة من أعماق قلبه إعجابا بما يرى ويسمع من أمانة ووفاء([93]).
كان عبد الرحمن يعلم أن الاستيلاء على الياقوتة التي لا تقدر بثمن ليس من حقه شخصيا, ولا من حق بيت مال المسلمين، فكانت تلك الياقوتة والتراب عنده سيان، فقد كان عبد الرحمن كريما مضيافا شهما غيورا، ورعا تقيا، متفقها في الدين تقيا، لا يملك شيئا من حطام الدنيا على الرغم من أنه قضى أكثر عمره غازيا وواليا، وقد استشهد في عام اثنتين وثلاثين للهجرة في منطقة (بلنجر). ([94]) ويعتبر عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي من قادة الفتح في عهد عثمان t، وقد كانت له صحبة وقد أسلم متأخرا.
10- سلمان بن ربيعة الباهلي من قادة الفتوح في عهد عثمان:
كان هذا الصحابي أول من قضى بالكوفة، فقد بعثه عمر بن الخطاب t قاضيا بالكوفة قبل شريح، فلما ولي سعد بن أبي وقاص الولاية الثانية في أيام عثمان بن عفان استقضى سلمان أيضا، وقد شهد القادسية فقضى بها، ثم قضى بـ(المدائن)، وليس كل إنسان يصلح للقضاء، خاصة في أيام عمر بن الخطاب t, أو يصلح لأهل الكوفة التي كانت حينذاك تعج برجالات العرب وكبار الصحابة من جهة، وبأخلاط شتى من أمم وأقوام وقبائل مختلفة من جهة أخرى، وهذا دليل على غزارة علم سلمان بالدين الحنيف واستقامته وعدله وتدينه، وتمتعه بعقلية راجحة متزنة، وشخصية قوية نافذة، مما جعله موضع ثقة الناس جميعا، كما أنه تولى المقاسم في فتح (المدائن) وفي غزوة (الباب) أيضا، مما يدل على تمتعه بالنزاهة المطلقة. كان رجلا صالحا يحج كل سنة، روى عنه بعض كبار التابعين، وكان مثالا نادرا للخلق القويم، كريما مضيافا شهما غيورا وفيا صادقا محبا للخير، يحب للناس ما يحبه لنفسه، ولم يترك حين استشهاده دينارا ولا دارا، بعد أن عاش كل حياته مجاهدا وقاضيا وأميرا.
وقد كان متفوقا على زملائه في الصفات القيادية، فعندما بعث عثمان بن عفان t كتابا إلى الوليد بن عقبة -عامله على الكوفة- يأمره به أن يرسل نجدة من أهل الكوفة إلى أهل الشام بقيادة رجل ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه، لم يتردد الوليد لحظة في اختيار سلمان لهذا الواجب البالغ الخطورة، فاختاره من بين عدد كبير من القادة أصحاب الفتوح والأيام الذين كانوا معه أو كانوا في الكوفة؛ ذلك لأن سلمان كان حقا مثالا رائعا من أمثلة النجدة والبأس والشجاعة بالإضافة إلى ورعه وتقواه، لقد كان شجاعا مقداما سريعا إلى النجدة، خبيرا بفنون الحرب لممارسته الطويلة لها, وله تجارب طويلة في قيادة الرجال، وكان أبصر بالمضارب من الجازر بمفاصل الجزور([95])، مما يدل على أنه كان من الرماة الماهرين، وكان ماهرا في الفروسية خبيرا بالخيل، وكان يلي الخيل لعمر بن الخطاب t، قد أعد في كل مصر من أمصار المسلمين خيلا كثيرة معدة للجهاد، وكان في الكوفة أربعة آلاف فرس، فإذا داهم العدو الثغور الإسلامية ركبها المسلمون المجاهدون وساروا مجدين لقتاله([96])، وكان سلمان يتولى الخيل بالكوفة([97]).
وكان شجاعا في الفروسية، قال سلمان: (قتلت بسيفي هذا مائة مستلئم([98]) كلهم يعبد غير الله، ما قتلت منهم رجلا منهم صبرا). إنه لا يقتل حتى عدوه الكافر بالله الذي يعبد غير الله، لا يقتله في ساحة القتال صبرا بل ينذره ثم يصاوله مصاولة الأنداد، ويقتله عندما يجد فرصة لقتله، فلا يكون هذا القتل غدرا، ولا يكون صبرا.([99])
لقد كان مثالا للمجاهد الصادق المحتسب، الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا لا يبالي على أي جنب كان في الله مصرعه، وأخيرا سقط مضرجا بدمائه ولم يسقط السيف من يده، إنه قدوة حسنة لكل جندي ولكل قائد في ماضيه المشرف المجيد، وفي أعماله الفذة الخالدة.([100]) هذا وقد استشهد سنة اثنتين وثلاثين هجرية أو سنة ثلاث وثلاثين هجرية([101]), رضي الله عنه, الفقيه المحدث، القاضي العادل، الأمين النزيه، الإداري الحازم، الفارس المغوار، البطل الشهيد، القائد الفاتح سلمان بن ربيعة الباهلي([102]).
11- حبيب بن مسلمة الفهري من قادة الفتوح في عهد عثمان:
كان حبيب على صغر سنه يتنقل من ساحة عمليات إلى ساحة عمليات أخرى، فاتحا مرة، ومددا مرة أخرى، وكان النصر حليفه في كل معركة خاضها، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة غازيا، وكان يومئذ صغيرا، وشهد غزوة تبوك تحت لواء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبهذه الغزوة بدأ جهاده وهو يناهز العشرين من عمره القصير([103])، وحين رآه عمر بن الخطاب صلب العود وقوي البدن، جربه تجربة عملية ليرى أي نوع من الرجال هو، فعرض عليه خزائن المال وخزائن السلاح، فاختار السلاح وعف عن المال، وتفضيل السلاح على المال من مزايا القائد الذي يتغلغل حب الجندية في أعماق نفسه. وقد تولى قيادة كردوس في معركة (اليرموك) الحاسمة وهو ابن أربع وعشرين سنة، مما يدل على ظهور سماته القيادية مبكرا وهو في ريعان الشباب، وولاه عمر بن الخطاب t عجم (الجزيرة) إداريا وقائدا، وليس من السهل أن يولي عمر كل إنسان مثل هذا المنصب الرفيع؛ لأن عمر كان يلتزم بصفات معينة في القائد قل أن تتوافر في الرجال، أخيرا ولاه عمر بن الخطاب t (أرمينية) و(أذربيجان) وهي مناطق شاسعة وقيادة مهمة للغاية، نظرا لشدة شكيمة أهلها ولبعدها عن قواعد المسلمين الرئيسية والمتقدمة.([104])
ومارس القيادة والإدارة في عهد عثمان t، ولقد كان شجاعا غاية الشجاعة، مقداما غاية الإقدام؛ لما توجه لقتال (الموريان) كان في ستة آلاف، وكان (الموريان) في سبعين ألفا، فقال حبيب لمن معه: إن يصبروا وتصبروا فأنتم أولى بالله منهم، وإن يصبروا وتجزعوا فإن الله مع الصابرين، ولقيهم ليلا، فقال: اللهم أجل لنا قمرها، واحبس عنا مطرها، واحقن دماء أصحابي، واكتبهم شهداء، ففتح الله له.([105]) فكان من أسباب انتصاره على عدوه -بالإضافة إلى عامل الإيمان- هو الهجوم الليلي الذي باغت به العدو، وجعل معنوياته تنهار ثم يولي الأدبار.([106])
وكان مثالا شخصيا حيا لرجاله من الشجاعة والإقدام، فقد كان يقود رجاله من الأمام، يقول لهم: اتبعوني، ولا يبقى في الخطوط الخليفة مؤثرا السلامة والعافية، وحين عزم أن يبيِّت (الموريان) سمعته امرأته يذكر ذلك، فقالت له: وأين الموعد؟ فقال: سرادق موريان أو الجنة. وبيَّت حبيب عدوه وقتل من صادفه في طريقه، فلما أتى السرادق وجد امرأته قد سبقته إليه.([107]) فلم يكن وحده بطلا يضرب لرجاله بأعماله البطولية أروع الأمثال، بل كانت امرأته بطلة يقتفى الأبطال آثارها في التضحية والفداء.([108])
وكان يستشير رجاله ويتقبل مشورتهم، وكان لا يستأثر بالرأي دونهم، بل كان يتصنت ليتلقف آراء رجاله، ويطبق ما رآه حسنا، وينفذ ما يجده صوابا، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات الشورى قبل المعارك وفي أثنائها وبعدها؛ فقد سمع يوما أحد رجاله يقول: لو كنت ممن يسمع حبيب مشورته، لأشرت عليه بأمر يجعل الله فيه لنا نصرا وفرجا إن شاء الله، واستمع حبيب لقوله، فقال أصحابه: وما مشورتك؟ فقال: أشير عليه أن ينادي بالخيول فيقدمها، ثم يرتحل بعسكره فيتبع خيله، وتوافيه الخيل في جوف الليل، وينشب القتال، ويأتيهم حبيب بسواد عسكره مع الفجر، فيظنون أن المدد قد جاءهم فيرعبهم الله، فيهزمهم بالرعب.([109]) ونادى حبيب بالخيول، فوجهها بليلة مقمرة مطيرة، ثم ارتحل وراء خيوله، ولكنه عاد إلى عدوه في السحر، فحمل وحمل أصحابه فانهزم العدو وأصابوا غنائم كثيرة([110]).
كان حبيب صاحب كيد، يفكر ويقدر، ثم يستشير رجاله ويستطلع ساحة القتال، ويحصل على المعلومات المستفيضة عن العدو، ثم يبني بعد ذلك خطته العسكرية على هدى وبصيرة. إن أعمال حبيب الجهادية خطط مدبرة ولم تكن خططا ارتجالية، لذلك رافق النصر أعلامه في أخطر ساحات القتال في الفتح، وبالإضافة إلى تلك المزايا أو قبلها كان حبيب مؤمنا حقا صادق الإيمان، وكان إذا لقى عدوا أو ناهض حصنا يحب أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم([111]).
لقد كان حبيب قائدا فذًّا، جمع مزايا القائد الفذ: الطبع الموهوب، والعلم المكتسب، والتجربة العلمية([112])، والثقة بالله القوي العزيز. إن حبيب بن مسلمة أسدى للفتح الإسلامي خدمات لا تنسى، فهو بدون شك من ألمع قادة الفتوح في عهد عثمان t، وقد توفى هذا القائد الفذ سنة اثنتين وأربعين هجرية, فكان عمره يوم توفى أربعًا وخمسين سنة قمرية، وكانت حياته قليلة في تعداد السنوات، كثيرة في تعداد جلائل الأعمال، قصيرة في عمر الزمن، باقية آثارها على مر الدهور وتوالي السنين والقرون. رضي الله عن الصحابي الجليل، الإداري الحازم، السياسي المحنك، القائد الفاتح، حبيب بن مسلمة الفهري([113]).
([1]) الكامل لابن الأثير.
([2]، 3، 4) جولة تاريخية، ص335.
([5]) جولة تاريخية ص336، عثمان بن عفان، لهيكل، ص67.
([6]) المصدر نفسه، ص336. (3) المصدر نفسه، ص338.
([8]) البلاذري، ص69. (5) جولة تاريخية، ص338.
([10]،2) جولة تاريخية، ص338.
([12]، 4) المصدر نفسه، ص340.
([14]) المصدر نفسه، ص341.
([15]) الخلافة والخلفاء الراشدون، ص229.
([16]) قادة الفتح لبلاد المغرب، (1/61- 63).
([17]) الخلافة والخلفاء الراشدون، ص229.
([18]) قادة الفتح لبلاد المغرب، (1/61- 63).
([19]) الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي، للصلابي، ص189.
([20]) ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر، صالح مصطفى مفتاح المزيني، ص49.
([21]) أنطابلس: معناها برقة.
([22]) ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر، ص39.
([23]) الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي، ص191.
([24]) المصدر نفسه ص193، البداية والنهاية (7/158).
([25]) الكامل لابن الأثير (3/45، 46).
([26]) البداية والنهاية (7/158).
([27]) التاريخ الإسلامي (12/390).
([28]، 2) التاريخ الإسلامي، (12/392).
([30]) تاريخ الإسلام للذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، ص359.
([31]) ذات الصواري، شوقي أبو خليل، ص60، 61.
([32]) المصدر نفسه، ص61. (3) تاريخ الطبري (5/290).
([34]) الكامل في التاريخ (3/58) طبعة البابي الحلبي - القاهرة.
([35]) البداية والنهاية (7/163). (2) الشيخ الخضري (2/29).
([37]) ذات الصواري، ص62. (4) النجوم الزاهرة (1/80).
([39]) تاريخ ابن خلدون (2/468). (6) ذات الصواري، شوقي أبو خليل، ص64.
([41]) تاريخ الطبري (5/292). (2) ذات الصواري، ص66.
([43]) المصدر نفسه، ص67.
([44]) ذات الصواري، ص67. (2) تاريخ الطبري (5/293).
([46]) ذات الصواري، ص68. (4) تاريخ ابن خلدون (2/468).
([48]) المصدر نفسه (2/468). (6) ذات الصواري، ص68.
([50]) ذات الصواري، ص71، 72. (2) المصدر نفسه، ص76.
([52]) التاريخ الإسلامي (12/407). (2) مسلم، كتاب الفتن، رقم (2918، 2919)
([54]) البداية والنهاية (7/216).
([55]) عصر الخلفاء الراشدين، د. عبد الحميد بخيت، ص216.
([56]) إتمام الوفاء، ص70.
([57]) النظم الإسلامية، صبحي الصالح، ص489.
([58]) تاريخ الطبري (5/244).
([59]) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/466).
([60]) فتوح البلدان، البلاذري (1/175).
([61]) الخراج وصناعة الكتابة، لابن قدامة، ص413.
([62]) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/467).
([63]) المصدر نفسه (2/467). (5) المصدر نفسه (2/467).
([65]) فتوح مصر، ص192.
([66]) سميساط: مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات.
([67]) ملطية: من بلاد الروم مشهورة مذكورة، تتاخم الشام، وهي للمسلمين.
([68]) كمخ: مدينة بالروم بينها وبين أرزنجان يوم واحد، معجم البلدان (4/479).
([69]) قالقيلا: بأرمينية العظمى من نواحي خلاط، ثم من نواحي منازجرد.
([70]) من تاريخ التحصينات، محمد عبد الهادي، ص434.
([71]) فتوح البلدان (1/234). (2) المصدر نفسه (1/241).
([73]) الإدارة العسكرية (2/469). (4) طميسة: بلدة من سهول طبرستان.
([75]) الإدارة العسكرية (2/469). (6) المصدر نفسه، (2/470)
([77]) منبج: بلد قديم. (8) الإدارة العسكرية (2/470).
([79]) الفتوح، ابن أعثم (1/341، 342).
([80]) الإدارة العسكرية (1/189)، نقلا عن تاريخ الطبري.
([81]) المصدر نفسه (1/189). (3) تاريخ اليعقوبي (2/166، 167).
([83]) الطبقات (3/59). (5) الإدارة العسكرية (1/403).
([85]) المصدر نفسه (1/403).
([86]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص155.
([87]) المصدر نفسه، ص156. (3) الردم: قيل سد الصين.
([89]) الكامل لابن الأثير (3/29، 30)، تاريخ الطبري (5/146).
([90]) تاريخ الطبري (54/146).
([91]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص150.
([92]) تاريخ الطبري (5/148).
([93]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص154.
([94]) المصدر نفسه، ص154.
([95]) تهذيب ابن عساكر (6/210)، تاريخ الطبري (5/309).
([96]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص169.
([97]) أسد الغابة في معرفة الصحابة، (2/327).
([98]) المستلئم: الجندي الذي لبس عدته وأصبح جاهزا للقتال.
([99]) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/633).
([100]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص170.
([101]) المصدر نفسه، ص171.
([102]) المصدر نفسه، ص172.
([103]) كان عمره يوم تولى منصب قيادة منطقة الجزيرة وإدارتها 28 سنة.
([104]) تولى (أرمينية) و(أذربيجان) وعمره ثلاث وثلاثون سنة.
([105]) تهذيب ابن عساكر (4/37).
([106]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص189.
([107]) المصدر نفسه، ص189.
([108]) المصدر نفسه، ص189.
([109]) تهذيب ابن عساكر (4/37)
([110]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص190.
([111]) تهذيب ابن عساكر (4/3).
([112]) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، ص192.
([113]) المصدر نفسه، ص187.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 3130
تاريخ التسجيل : 31 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 2,291
- شكراً و أعجبني للمشاركة

- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 12
معدل تقييم المستوى
: 16

المبحث الرابع أعظم مفاخر عثمان جمع الأمة على مصحف واحد
أولاً: المراحل التي مرت بها كتابة القرآن الكريم:
1- المرحلة الأولى في العهد النبوي:
حيث ثبت بالدليل القاطع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن الذي ينزل عليه، وثبت أنه كان له كاتب أو كتاب يكتبون الوحي، حتى شُهر زيد بن ثابت بلقب (كاتب النبي صلى الله عليه وسلم لاختصاصه بكتابة الوحي)، وبوَّب البخاري في كتاب (فضائل القرآن) (باب كتَّاب النبي صلى الله عليه وسلم)، وذكر فيه حديثين:
الأول: أنا أبا بكر t قال لزيد: (إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله...) ([1])
والثاني: عن البراء قال: لما نزلت "لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ..." قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادع لي زيدا وليجئ باللوح والدواة والكتف، أو الكتف والدواة». ([2]) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن في مكة أيضا قبل الهجرة، وممن كتب له عبد الله بن سعد بن أبي السرح ثم ارتد، ثم أسلم عام الفتح، وله في ذلك قصة مشهورة قد ذكرتها. والمعروف أن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا كتبة، فلعلهم كانوا يكتبون القرآن في مكة، ومما يدل على أن القرآن كان مكتوبا في مكة قصة إسلام عمر بن الخطاب ودخوله على أخته، وبيدها صحيفة فيها سورة طه، وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه -أي القرآن- مجموع في الصحف في قوله تعالى: "رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً" [البينة: 2]. وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن كله مكتوب لكنه غير مجموع في موضع واحد، وكان مكتوبا على العسب واللخاف, ومحفوظا في صدور الرجال، ومع حفظه في الصحف وفي الصدور كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، وعرض عليه مرتين في العام الذي قبض.([3]) ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية([4]).
2- المرحلة الثانية في عهد أبي بكر:
كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثير من حفظة القرآن، وقد نتج عن ذلك أن قام أبو بكر t بمشورة عمر بن الخطاب t بجمع القرآن؛ حيث جمع من الرقاع والعظام والعسب ومن صدور الرجال([5])، وأسند الصديق هذا العمل العظيم إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري t، يروى زيد بن ثابت t فيقول: بعث إليَّ أبو بكر t لمقتل أهل اليمامة([6])، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر t: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر([7]) يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن([8]) كلها فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ([9])؟ فقال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك([10])، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه.([11]) قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن، فتتبعت القرآن من العسب([12]) واللخاف([13]) وصدور الرجال والرقاع والأكتاف.([14]) قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتِّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ" [التوبة: 128] حتى خاتمة براءة، وكانت الصحف عند أبي بكر في حياته حتى توفاه الله، ثم عمر في حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم([15]).
ونستخلص من المرحلة الثانية في جمع القرآن بعض النتائج:
أ- أن جمع القرآن الكريم جاء نتيجة الخوف على ضياعه نظرا لموت العديد من القراء في حروب الردة، وهذا يدل على أن القراء والعلماء كانوا وقتئذ أسرع الناس إلى العمل والجهاد لرفع شأن الإسلام والمسلمين بأفكارهم وسلوكهم وسيوفهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس ينبغي الاقتداء بهم لكل من جاء بعدهم.
ب- أن جمع القرآن تم بناء على المصلحة المرسلة، ولا أدل على ذلك من قول عمر لأبي بكر حين سأله كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خير. وفي بعض الروايات أنه قال له: إنه والله خير ومصلحة للمسلمين. وهو نفس ما أجاب به أبو بكر زيد بن ثابت حين سأل نفس السؤال، وسواء صحت الرواية التي جاء فيها لفظ المصلحة أو لم تصح فإن التعبير بكلمة خير يفيد نفس المعنى، وهو مصلحة المسلمين في جمع القرآن مبني على المصلحة المرسلة أول الأمر، ثم انعقد الإجماع على ذلك بعد أن وافق الجميع بالإقرار الصريح أو الضمني، وهذا يدل على أن المصلحة المرسلة يصح أن تكون سندا للإجماع بالنسبة لمن يقول بحجيتها كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.
ج- وقد اتضح لنا من هذه الواقعة كذلك كيف كان الصحابة يجتهدون في جو من الهدوء يسوده الود والاحترام، هدفهم الوصول إلى ما يحقق الصالح العام لجماعة المسلمين، وأنهم كانوا ينقادون إلى الرأي الصحيح وتنشرح قلوبهم له بعد الإقناع والاقتناع، فإذا اقتنعوا بالرأي دافعوا عنه كما لو كان رأيهم منذ البداية، وبهذه الروح أمكن انعقاد إجماعهم حول العديد من الأحكام الاجتهادية([16]).
* ما المقومات الأساسية لزيد بن ثابت للقيام بهذه المهمة؟
اختار أبو بكر زيد بن ثابت لهذه المهمة العظيمة، وذلك لأنه رأى فيه المقومات الأساسية للقيام بها، وهي:
أ- كونه شابا؛ حيث كان عمره 21 سنة، فيكون أنشط لما يطلب منه.
ب- كونه أكثر تأهيلا، فيكون أوعى له؛ إذ من وهبه الله عقلا راجحا فقد يسر له سبيل الخير.
ج- كونه ثقة، فليس هو موضعا للتهمة، فيكون عمله مقبولا، وتركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب.
د- كونه كاتبا للوحي، فهو بذلك ذو خبرة سابقة في هذا الأمر، وممارسته عملية له، فليس غريبا عن هذا العمل ولا دخيلا عليه([17]).
هـ- ويضاف لذلك أنه أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك t: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد.([18]) وأما الطريقة التي اتبعها زيد في جمع القرآن فكان لا يثبت شيئا من القرآن إلا إذا كان مكتوبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظا من الصحابة، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، خشية أن يكون في الحفظ خطأ أو وَهْم، وأيضا لم يقبل من أحد شيئا جاء به إلا إذا أتى معه شاهدان يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الوجوه التي نزل بها القرآن.([19]) وعلى هذا المنهج استمر زيد t في جمع القرآن حذرا متثبتا مبالغا في الدقة والتحري([20]).
* الفرق بين المكتوب في العهد النبوي وعهد الصديق:
الفرق بين المكتوب في العهد النبوي وما كتب في عهد أبي بكر: أن القرآن كان مكتوبا في العهد النبوي، مفرقا في الصحف والألواح والعُسب والكرانيف والقصب وأدوات أخرى، ولم تكن مجموعة سوره في خيط واحد، وأما الذي تم في أيام أبي بكر فهو كتابة القرآن في صحف كل سورة أو سور في صحيفة مرتبة آياته على ما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مهمة زيد بن ثابت أن يكتب ما كان مكتوبا في العهد النبوي في صحف، كل سورة في صحيفة مرتبة فيها الآيات ترتيبا توقيفيا([21]).
3- المرحلة الثالثة في جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان:
* الباعث على جمع القرآن في عهد عثمان:
عن أنس بن مالك: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير, وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق([22]).
ويؤخذ من هذا الحديث الصحيح أمور، منها:
أ- أن السبب الحامل لعثمان t على جمع القرآن مع أنه كان مجموعا مرتبا في صحف أبي بكر الصديق إنما هو اختلاف قراء المسلمين في القراءة اختلافا أوشك أن يؤدي بهم إلى أخطر فتنة في كتاب الله تعالى، وهو أصل الشريعة ودعامة الدين، وأساس بناء الأمة الاجتماعي والسياسي والخلقي، حتى إن بعضهم كان يقول لبعض: إن قراءتي خير من قراءتك، فأفزع ذلك حذيفة، ففزع فيه إلى خليفة المسلمين وإمامهم, وطلب إليه أن يدرك الأمة قبل أن تختلف فيستشري بينهم الاختلاف ويتفاقم أمره ويعظم خطبه، فيمس نص القرآن وتحرف عن مواضعها كلماته وآياته، كالذي وقع بين اليهود والنصارى من اختلاف كل أمة على نفسها في كتابها.
ب- أن هذا الحديث الصحيح قاطع بأن القرآن الكريم كان مجموعا في صحف ومضموما في خيط، وقد اتفقت كلمة الأمة اتفاقا تاما على أن ما في تلك الصحف هو القرآن كما تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرضة على أمين الوحي جبريل عليه السلام، وأن تلك الصحف ظلت في رعاية الخليفة الأول أبي بكر الصديق، ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ثم لما عرف عمر حضور أجله ولم يولِّ عهده أحدًا معينا في خلافة المسلمين، وإنما جعل الأمر شورى في الرهط المصطفين بالرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بحفظ الصحف عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن عثمان اعتمد في جمعه على تلك الصحف، وعنها نقل مصحفه (الرسمي)، وأنه أمر أربعة من أشهر قراء الصحابة إتقانا لحفظ القرآن ووعيا لحروفه وأداء لقراءته وفهما لإعرابه ولغته: ثلاثة قرشيين وواحدا أنصاريا، وهو زيد بن ثابت صاحب الجمع الأول في عهد الصديق بإشارة الفاروق، وفي بعض الروايات أن الذين أمرهم عثمان أن يكتبوا من الصحف اثنا عشر رجلا، فيهم أبي بن كعب، وآخرون من قريش والأنصار([23]).
ج- ونأخذ من هذا أن الفتوحات في عهد عثمان كانت بإذن وأمر من الخليفة، وأن القرار العسكري يصدر من المدينة، وأن الولايات الإسلامية كلها كانت خاضعة لأمر الخليفة عثمان في عهده؛ بل يدل على أن هناك إجماعا من الصحابة والتابعين في جميع الأقاليم على خلافة عثمان. وقدوم حذيفة بن اليمان إلى المدينة، لرفع اختلاف الناس في قراءة القرآن، يدل على أن القضايا الشرعية الكبرى كان يستشار فيها الخليفة في المدينة، وأن المدينة ما زالت دار السنة ومجمع فقهاء الصحابة([24]).
ثانيًا: استشارة جمهور الصحابة في جمع عثمان:
جمع عثمان المهاجرين والأنصار وشاورهم في الأمر، وفيهم أعيان الأمة وأعلام الأئمة وعلماء الصحابة، وفي طليعتهم علي بن أبي طالب t، وعرض عثمان t هذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتها الهادين المهديين، ودارسهم أمرها ودارسوه، وناقشهم فيها وناقشوه، حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه، فأجابوه إلى رأيه في صراحة لا تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلا، وظهر للناس في أرجاء الأرض ما انعقد عليه إجماعهم، فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالف ولا عرف عند أحد نكير، وليس شأن القرآن الذي يخفى على آحاد الأمة فضلا عن علمائها وأئمتها البارزين([25]).
إن عثمان t لم يبتدع في جمعه المصحف، بل سبقه إلى ذلك أبو بكر الصديق t، كما أنه لم يصنع ذلك من قِبَل نفسه، إنما فعله عن مشورة للصحابة -رضي الله عنهم- وأعجبهم هذا الفعل وقالوا: نعم ما رأيت، وقالوا أيضا: قد أحسن (أي في فعله في المصاحف)([26]).
وقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين مشق([27]) عثمان t المصاحف فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل منه([28])، وكان علي t ينهى من يعيب على عثمان t بذلك ويقول: يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيرا أو قولوا خيرا, فوالله ما فعل الذي فعل -أي في المصاحف- إلا عن ملإٍ منا جميعا -أي الصحابة-, والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل([29]).
وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خيرة الخلق على هذا الأمر المبارك، يتبين لكل متجرد عن الهوى أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنيع الذي صنعه عثمان t وحفظ به القرآن الكريم([30]).
قال القرطبي في التفسير: وكان هذا من عثمان t بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واطراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأيا سديدا موفقا([31])
ثالثـًا: الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهما:
قال ابن التين: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشيته أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم البعض، فخشى من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا لسوره، واقتصر في سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءاته بلغة غيرهم، دفعًا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة قد انتهت، فاقتصر على لغة واحدة.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لم يقصد أبو بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، إنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا تأويل أثبت مع تنزيل، ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد.
وقال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك؛ إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق، وقد قال علي t: لو وليت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان([32]).
وقال القرطبي: فإن قيل: فما وجه جمع عثمان الناس على مصحفه وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؟ قيل له: إن عثمان t لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف، ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك؟ وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا في القراءة لتفرق الصحابة في البلدان، واشتد الأمر في ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم، ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة t([33]).
رابعًا: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة:
ذهب الشيخ المحقق صادق عرجون -رحمه الله- إلى أن صحف الصديق التي كانت أصلا للمصحف الإمام بإجماع المسلمين لم تكن جامعة للأحرف السبعة التي وردت صحاح الحديث بإنزال القرآن عليها، بل كانت على حرف منها، هو الذي وقعت به العرضة الأخيرة واستقر عليها الأمر في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت الأحرف السبعة أولا من باب التيسير على الأمة، ثم ارتفع حكمها لما استفاض القرآن وتمازج الناس وتوحدت لغاتهم. قال الإمام الطحاوي: إنما كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، وسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا، فكانوا كذلك حتى كثرت منهم من يكتب, وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه, فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا بخلافها. قال ابن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد.([34])
وقال الطبري: إن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان جائزا لهم ومرخصا لهم فيه، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على حرف واحد أجمعوا على ذلك إجماعا شائعا، وهم معصومون من الضلالة.([35]) وهذا الحرف الذي كتبت به صحف الإجماع القاطع ونقل عنها المصحف الإمام جامع لقراءات القراء السبعة وغيرها، مما يقرأ به الناس ونقل متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأحرف الواردة في الحديث غير هذه القراءات.([36]) قال القرطبي: قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه المصحف([37])، وأقرب الآراء إلى الفهم عند ظننا في معنى الأحرف إنما هو الرأي القائل بأنها هي أفصح لغات العرب وأشهرها، وهي مبثوثة في القرآن كله، وإليه ذهب القاسم بن سلام وابن عطية في جماعة من الأجلاء، وإليه يرجع نحو سبعة أقوال مما ذكره السيوطي في الإتقان في معنى الأحرف([38]).
خامسًا: عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار:
لما فرغ عثمان من جمع المصاحف أرسل إلى كل أفق بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسله إلى الآفاق، وقد اختلفوا في عدد المصاحف التي فرقها في الأمصار، فقيل: إنها أربعة وهو الذي اتفق عليه أكثر العلماء، وقيل: إنها خمسة، وقيل: إنها ستة، وقيل: إنها سبعة، وقيل: إنها ثمانية. أما كونها أربعة فقيل: إنه أبقى مصحفا بالمدينة، وأرسل مصحفا إلى الشام، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى البصرة. وأما كونها خمسة؛ فالأربعة المتقدم ذكرها، والخامس أرسله إلى مكة. وأما كونها ستة فالخمسة والمتقدم ذكرها، والسادس اختلف فيه، فقيل جعله خاصا لنفسه، وقيل: أرسله إلى البحرين. وأما كونها سبعة، فالستة المتقدم ذكرها، والسابع أرسله إلى اليمن. وأما كونها ثمانية، فالسبعة المتقدم ذكرها، والثامن كان لعثمان يقرأ فيه، وهو الذي قتل وهو بين يديه.([39]) وبعث t مع كل مصحف من يرشد الناس إلى قراءته بما يحتمله رسمه من القراءات مما صح وتواتر، فكان عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي، وأبو عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي، وعامر بن قيس مع المصحف البصري، وأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس بالمدني([40]).
سادسًا: موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عثمان:
لم يثبت أن ابن مسعود خالف عثمان في ذلك، وكل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد، كما أن هذه الروايات الضعيفة التي تتضمن ذلك تثبت أن ابن مسعود رجع إلى ما اتفق عليه الصحابة في جمع القرآن، وأنه قام في الناس وأعلن ذلك، وأمرهم بالرجوع إلى جماعة المسلمين في ذلك([41]). وقال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بذهاب العلماء، وإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فجامعوهم على ما اجتمعوا عليه، فإن الحق فيما اجتمعوا عليه، وكتب بذلك إلى عثمان.([42]) وقد ورد عن ابن كثير رجوع ابن مسعود إلى الوفاق([43])، وأكد الذهبي ذلك فقال: وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد.([44]) ولا يلتفت إلى ما كتبه طه حسين في قضية المصحف وعلاقة عثمان مع ابن مسعود وما ساقه بأسلوب مسموم، فيه أفكار أخذها من أساتذته المستشرقين([45]). الذين اعتمدوا على روايات ضعيفة ورافضية في تشويه علاقة الصحابة ببعضهم رضي الله عنهم جميعا.
إن ابن مسعود الذي ترك صلاة القصر في منى خشية من الخلاف والفتنة ومتابعة للخليفة، هل يتوقع منه أن يصعد المنبر ويحرض الناس على الخلاف، وهو القائل: إن الخلاف شر([46]).
إن مؤرخي الروافض زوَّروا روايات ونسبوها لابن مسعود وموقفه من عثمان رضي الله عنهم، وأظهروا في تلك الأكاذيب الصحابة قوما متنازعين متباغضين، متعنتين متفاحشين في القول، وهي روايات ساقطة لا تثبت أمام النقد الهادئ الموضوعي، ويرفضها الذوق المؤمن والعقل الفطن، وقد زعمت الرافضة كذبا وزورا بأن ابن مسعود كان يطعن على عثمان ويكفره، ولما حكم عثمان ضربه حتى مات، وهذا كذب بيِّن على ابن مسعود، فإن علماء النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان بل لما بويع عثمان بالخلافة سار عبد الله بن مسعود من المدينة إلى الكوفة، ولما وصل إليها حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات فلم نر يوما أكثر نشيجا من يومئذ، وإنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذي فُوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوه.([47]) وهذه الكلمات الواضحة أكبر دليل على تلك المكانة الرفيعة لعثمان بن عفان في قلب ابن مسعود وعند جميع الصحابة، أولئك الذين مدحهم الله تعالى ورضي عنهم، وهم خير من فقه قوله سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا" [الأحزاب: 70]. فقول عبد الله بن مسعود صدق لا يعدو الحقيقة، كما أنه نابع عن قناعته وصادر عن محض إرادته، ما قاله خوفا ولا خشية، ولم يقذف به هكذا رخيصا للاستهلاك والتغرير، أو ليحوز مكانة ومنصبا في الخلافة الجديدة. إذن فمن بدهيات الأمور وأولياتها أن ليس ثمة حقد أو بغضاء في قلب أحدهما على الآخر، وإن حدث شيء فإنما هو من أجل الحق وصالح المسلمين([48])، ويندرج تحت فقه النصيحة وآدابها وتأديب الخليفة لرعيته، وأما ما زعم الروافض ومن سار على نهجهم من أن عثمان ضرب ابن مسعود حتى مات فهذا كذب باتفاق أهل العلم، قال أبو بكر بن العربي: وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور.([49]) فلا وجهة للرافضة بالطعن على عثمان بقصة ابن مسعود هذه, فإنه لم يضربه ولم يمنعه عطاءه، وإنما كان يعرف له قدره ومكانته، كما كان ابن مسعود شديد الالتزام بطاعة إمامه الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة([50]).
سابعًا: فهم الصحابة لآيات النهي عن الاختلاف:
 : "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [الأنعام: 153], فالصراط المستقيم هو القرآن والإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليها، والسبل هي الأهواء والفرق والبدع والمحدثات، قال مجاهد: "وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ" يعني البدع والشبهات والضلالات([51]). : "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [الأنعام: 153], فالصراط المستقيم هو القرآن والإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليها، والسبل هي الأهواء والفرق والبدع والمحدثات، قال مجاهد: "وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ" يعني البدع والشبهات والضلالات([51]).
ونهى الله -سبحانه وتعالى- هذه الأمة عما وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف والتفرق من بعد ما جاءتهم البينات، وأنزل الله إليهم الكتاب فقال سبحانه: "وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" [آل عمران: 105].
ونهى الأمة أن يكون أفرادها من المشركين، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فقال عز من قائل: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ` مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ` مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" [الروم: 30- 32].
وأخبر سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الذين يفرقون دينهم ويكونون شيعا وأحزابا([52]),  : "إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" [الأنعام: 159]. : "إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" [الأنعام: 159].
ويظهر من قصة جمع القرآن في عهد عثمان t مدى فهم الصحابة -رضي الله عنهم- لآيات النهي عن الاختلاف؛ حيث إن الله نهى عن الاختلاف وحذر منه، فلعمق فهمهم لهذه الآيات ارتعد حذيفة t عندما سمع بوادر الاختلاف في قراءة القرآن، فرحل فورا إلى المدينة النبوية، وأخبر عثمان t بما رأى وبما سمع، فسرعان ما قام عثمان يخطب الناس، يحذرهم من مغبة هذا الخلاف، ويشاور الصحابة -رضوان الله عليهم- في الحل لهذه المحنة التي بدأت بالظهور، وفي مدة قصيرة يحسم الأمر ويغلق باب الخلاف الذي كاد أن ينفتح بجمع الصحف ونسخها في مصحف واحد من المصادر الموثوقة جدا، وبإغلاق باب الفتنة هذا فرح المسلمون، بينما اغتاظ المنافقون الذين كانوا قد استبشروا ببوادر الخلاف التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر ويسعون إلى تحقيقها، ولما حسم الخلاف، ولم يجد أولئك طريقا إلى استنهاضه، ازداد حقدهم على عثمان t وسعوا إلى التشنيع عليه وتصوير حسنته هذه سيئة، وتلمسوا في سبيل إثبات ذلك خيوط العنكبوت الواهية، ليطعنوا فيه ويسوغوا خروجهم عليه بها، مظهرين للناس أن هذه الحسنة سيئة تستوجب الخروج عليه([53]).
إن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يتركوا كل قارئ على قراءته الصحيحة، بل جمعوهم على قراءة واحدة، فاجتمع شملهم وتوحد صفهم، وهذا درس عظيم نستلهمه من دراستنا لتاريخ عهد الخلفاء الراشدين، الحافل بالعبر والدروس ومواطن القدوة([54]).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم». ([55])
إن طريق الاعتصام بحبل الله أن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل من آكد الأصول في هذا الدين العظيم، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا الأصل العظيم -وهو الإسلام- مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، مما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة([56]). ولذلك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما يحفظ على المسلمين جماعتهم وألفتهم، ونهى عن كل ما يعكر صفو هذا الأمر العظيم.
إن ما حصل من فرقة بين المسلمين وتدابر وتقاطع وتناحر، بسبب عدم مراعاة هذا الأصل وضوابطه مما ترتب عليه تفرق في الصفوف، وضعف في الاتحاد، وأصبحوا شيعا وأحزابًا كل حزب بما لديهم فرحون([57]).
إن وحدة المسلمين واجتماعهم مطلب شرعي، ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة؛ بل من أهم أسباب التمكين لدين الله تعالى، ونحن مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فلا بد من تضافر الجهود بين الدعاة وقادة الحركات الإسلامية، وبين علماء المسلمين وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحًا حقيقًا لا تلفيقيًّا؛ لأن أنصاف الحلول تفسد أكثر مما تصلح، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: الجهاد نوعان؛ جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شئونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية وهذا النوع هو الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم، وهذان نوعان: جهاد بالحجة والبرهان واللسان، وجهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان.([58]) ثم أفرد فصلا بعنوان: الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة.([59]) وبعد أن ذكر الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تعاون المسلمين ووحدتهم قال: فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية([60]).
ولذلك نرى أن الأخذ بالأسباب نحو تأليف قلوب المسلمين وتوحيد صفهم من أعظم الجهاد؛ لأن هذه الخطوة مهمة جدا في إعزاز المسلمين وإقامة دولتهم، وتحكيم شرع ربهم، وهذا من فقه الخلفاء الراشدين، ويتجلى في أبهى صورة في جمع عثمان t للأمة على مصحف واحد.
([1]) البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم (4986).
([2]) البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم (4593).
([3]) البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم (4998).
([4]) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي، ص240، نقلا عن فتح الباري (9/12).
([5]) حروب الردة وبناء الدولة الإسلامية، أحمد سعيد، ص145.
([6]) يعني وقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذاب وأعوانه.
([7]) استحر: كثر واشتد.
([8]) أي في الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار.
([9]) يحتمل أن يكون إنما لم يجمع القرآن في المصحف.
([10]) هذه الصفات التي جعلت زيدا يتقدم على غيره في هذا العمل.
([11]) أي: من الأشياء التي عندي وعند غيرك.
([12]) العسب: هو جريد النخيل.
([13]) اللخاف: جمع لخفة: وهي صفائح الحجارة.
([14]) الرقاع: جمع رقعة وهي قطع الجلود. الأكتاف: جمع كتف، وهو العظم الذي للبعير أو الشاة.
([15]) البخاري، رقم (4986).
([16]) الاجتهاد في الفقه الإسلامي، عبد السلام السليماني، ص127.
([17]) التفوق والنجابة على نهج الصحابة، حمد العجمي، ص73.
([18]) سير أعلام النبلاء، الإمام الذهبي، (2/431)
([19]) التفوق والنجابة على نهج الصحابة، ص74.
([20]) الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق، للصلابي، ص206.
([21]) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (2/241).
([22]) البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم (4987).
([23]) عثمان بن عفان، صادق عرجون، ص171.
([24]) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (2/244).
([25]) عثمان بن عفان، صادق عرجون، ص175.
([26]) فتنة مقتل عثمان بن عفان (1/78).
([27]) مشق هو: الحرق، (لسان العرب 10/344).
([28]) التاريخ الصغير للبخاري (1/94)، إسناده حسن لغيره.
([29]) فتح الباري (9/18)، إسناده صحيح.
([30]) فتنة مقتل عثمان بن عفان (1/78).
([31]) الجامع لأحكام القرآن (1/88).
([32]) عثمان بن عفان، صادق عرجون، ص178.
([33]) الجامع لأحكام القرآن (1/87).
([34]، 2، 3) عثمان بن عفان، صادق عرجون، ص180.
([37]) الجامع لأحكام القرآن (1/79).
([38]) الإتقان للسيوطي (1/144-148).
([39]) أضواء البيان في تاريخ القرآن، ص77. (2) المصدر نفسه، ص78.
([41]) فتنة مقتل عثمان بن عفان (1/78). (4) المصدر نفسه (1/79).
([43]) البداية والنهاية (7/228).
([44]) سير أعلام النبلاء (1/349).
([45]) الفتنة الكبرى (1/159).
([46]) عبد الله بن مسعود، عبد الستار الشيخ، ص335.
([47]) طبقات ابن سعد (3/63).
([48]) عبد الله بن مسعود، ص324.
([49]) العواصم من القواصم، ص63.
([50]) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، (3/1066).
([51]) تفسير مجاهد، ص227.
([52]) دراسات في الأهواء والفرق والبدع، ناصر العقل، ص49.
([53]) فتنة مقتل عثمان بن عفان (1/82). (2) المصدر نفسه (1/83).
([55]) مسند أحمد (1/2، 26). (4) مجموع الفتاوى (22/359).
([57]) تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين، للصلابي، ص307.
([58]) وجوب التعاون بين المسلمين للسعدي، ص5.
([59]) المصدر نفسه، ص5.
([60]) المصدر نفسه، ص5.
-
رقم العضوية : 7073
تاريخ التسجيل : 24 - 6 - 2012
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
العمر: 25
المشاركات : 139
- شكراً و أعجبني للمشاركة

- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
البلد : الامارات
الاهتمام : القراءة و الكتابة
الوظيفة : طالبة
معدل تقييم المستوى
: 12

ما شاء الله بحث رائع و جميل و تستاهل الشكر على هذا المجهود
و الدكتور علي الصلابي دائما يتحفنا بكتبه الرائعة
تحياتي
|
 |




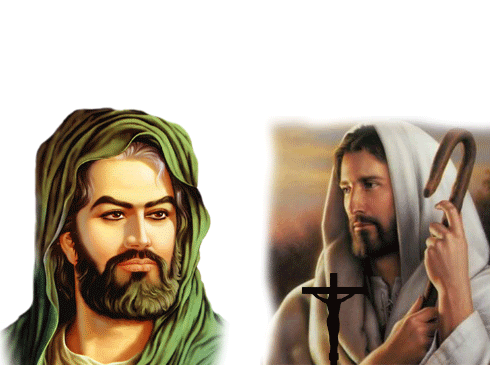

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس : "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [الأنعام: 153], فالصراط المستقيم هو القرآن والإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليها، والسبل هي الأهواء والفرق والبدع والمحدثات، قال مجاهد: "وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ" يعني البدع والشبهات والضلالات(
: "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [الأنعام: 153], فالصراط المستقيم هو القرآن والإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليها، والسبل هي الأهواء والفرق والبدع والمحدثات، قال مجاهد: "وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ" يعني البدع والشبهات والضلالات(
المفضلات